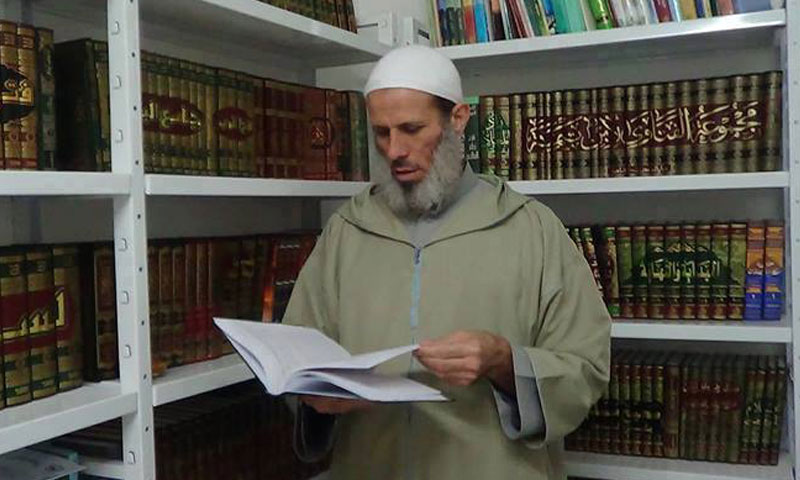د. عبد الآخر حماد يكتب: من ذكرياتي مع الكُتب.. «أحاديث الصباح في المذياع»
اشتريت عدد مجلة الأزهر لهذا الشهر (رجب 1446هـ)، فوجدت إحدى هديتيه كتاباً عنوانه «أحاديث الصباح في المذياع»، فعادتْ بي الذاكرة إلى ما قبل نصفِ قرن من الزمان؛ حيث كان لي مع هذا الكتاب ذكرى بل ذكرياتٌ.
ذلك أني كُلِّفتُ -وأنا بعدُ طالبٌ في المرحلة الثانوية- بالإمامة والخطابة في مسجد العائلة بالغنايم، وقد كان أكثرُ الخطباء في بلدتنا يلقون خُطبَهم من ورقة أو كتاب، ولكني سرت على خطى والدي رحمة الله عليه في إلقاء الخطبة من الذاكرة؛ فكان لا بد لي من تحضير الخطب التي كنت ألقيها في المسجد، وبالطبع كنت أستعين -بعد الله تعالى -بوالدي رحمة الله عليه، وبما أجده في مكتبته من الكتب والمجلات الإسلامية، وقد كان من أهم الكتب التي أحببتها، وكانت زاداً لي في إعداد الخطب والدروس ثلاثة كتب، وجدتها سهلة الأسلوب، وكانت موضوعاتها مناسبة لحاجة أهلنا في ذلك الوقت.
كان أول تلك الكتب هو كتاب «خلق المسلم» للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وكان ثانيها كتاب اسمه «الأنابيش» لمؤلف غير مشهور هو عبد الرحمن الضبع، وكان ثالث تلك الكتب هو موضوع حديثنا اليوم.
ومما أذكره عن ذلك الكتاب أن نسختَه التي كانت موجودة لدينا، كان غلافها مفقوداً، وكذا ضاعت منه ورقة أو ورقتان من أوله، فلما تصفحته وجدته يتحدث عن موضوعات شتى تتعلق بالنواحي الأسرية والاجتماعية، وأغلبها شروح مبسطة لأحاديث نبوية شريفة, وبالتالي كان مناسباً جداً لي، ومتناسباً مع سني ومستواي العقلي في ذلك الوقت، فلما سألت والدي عن عنوان ذلك الكتاب، قال إنه كتاب «أحاديث الصباح في المذياع»، للشيخين محمود شلتوت ومحمد محمد المدني، وقد كانا عالميْن مشهوريْن في تلك الفترة، كان أولهما -الشيخ شلتوت- شيخاً للأزهر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات (ت: 1963)، وكان الشيخ المدني (ت: 1968م) من كبار علماء الأزهر -أيضاًـ وقد تولى عمادة كلية الشريعة في فترة الستينيات، وكان الكتاب عبارة عن مجموعة من الدروس الإذاعية كان الشيخان قد ألقياها، في «حديث الصباح»، الذي كان -ولا يزال- يذاع عقب قرآن السادسة صباحاً من إذاعة القاهرة,
ثم مرت أعوام وأعوام، تخللتها محن وخطوب، سافرت بعدها خارج مصر لزُهاء عشرين عاماً، ولما رجعت إلى مصر كان مما اعتنيت به البحث عن كتبي وكتب والدي رحمة الله عليه، فوجدت أن جانباً كبيراً منها قد فُقد ولم أجدْ لها أثراً، ومنها هذا الكتاب, فلما آلت إلىَّ منذ سنوات مكتبة خالي الأستاذ محمد أحمد العطيفي (بوصيةٍ منه رحمه الله)، كان من أهم ما اهتممت به البحث عن الكتب التي فقدتُها من كتب والدي، لعلي أجدها في مكتبة الأستاذ العطيفي؛ وذلك لعلمي بتقاربهما في السن والثقافة، فتوقعت أن يكون هناك قاسم مشترك بينهما فيما يقتنيانه من الكتب، وبالفعل عثرت على أشياء كثيرة مما ضاع من مكتبة الوالد، وكان منها هذا الكتاب، ففرحت بذلك كثيراً، وكنت كثيراً ما أرجع إليه فأقلب فيه وأتصفحه بحثاً عن مسألة ٍ، أو لمجرد استعادة شيء من ذكريات الصبا والشباب، والدعاء لوالدي ولأستاذي العطيفي رحمة الله عليهما وعلى أموات المسلمين أجمعين.
ومن ذكرياتي مع هذا الكتاب أني كنت أشرح للمصلين شيئاً منه في دروس التراويح، فتعرضت ذات مرةٍ لحديث الرجل الذي اشترى عقاراً من آخر فوجد فيه جرَّةً فيها ذهب، فذهب إلى البائع ليرد له الجرة قائلاً إنه اشترى منه الأرض ولم يشترِ منه الذهب، فأبى البائع أن يقبل الجرة،وقال للمشتري: إنما بعتك الأرض وما فيها.
الحديث وفيه: (فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية.
قال أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا) [البخاري:3472) ومسلم (1721)]، فأردت تقريب المعنى أهل القرية، فقلت إنَّ الرجلين تحاكما إلى رجلٍ له شأن كعمدة القرية مثلاً، وإنهما لو كانا في أيامنا هذه لكانت الخصومة بينهما في أن كلَّ واحد منهما يريد الجرة لنفسه، لا أن كلَّ واحد منهما يريد أن يترك الجرة للآخر، فقال أحد الجالسين: بل لو كانا في عصرنا لطمع العمدة في الجرة وأخذها لنفسه.
فقلت له مازحاً: لعلك يا عم الحاج في خصومة مع حضرة العمدة، ولذا قلتَ في حقه ما قلت. فضحك الجميع.
ولما طالعتُ طبعة مجلة الأزهر من ذلك الكتاب، وجدتها قد أُخرجت بشكل قشيب، ووجدتها -بخلاف الطبعة القديمة- مُخرَّجةَ الأحاديث، وبها بعض التعليقات السريعة، ولا شك أن ذلك جهد مشكور من هيئة تحرير المجلة.
ومع ذلك لا أزال أجدني مشدوداً إلى الطبعة القديمة بأوراقها الصفراء، وذلك كعادتي مع غالب الكتب حيث أفضل القراءة في الطبعات القديمة التي اعتدت عليها؛ حتى إنني أحياناً أجد في بعض الطبعات الجديدة شيئاً من الفوائد، فأدوِّنُ تلك الفوائد في نسختي القديمة، لكي لا أتخلى عنها.
وبعد: فإنه مما يلاحَظ في موضوعات الكتاب الاهتمام بمعالجة أدواء الأسرة والمجتمع، التي لا يزال كثير منها قائماً حتى اليوم. ومن ذلك ما وجدته فيه من أنه لا يصح للمسلم أن يفترض الثقة المطلقة في أبنائه وبناته، بحيث لا يزعجه ولا يثير نخوته أن يعود الفتى أو الفتاة بعد هجعةٍ من الليل، فلا يُسأل أحدهما أين كان؟ وإن سُئل قُبِل منه أي جواب، ثم قال المؤلفان: (وددنا لو تدبرنا هذا فلم نُبِحْ مصاحبةَ الفتى للفتاة باسم الخطوبة التي قد تُفسخ، وباسم الصداقة وباسم القرابة، وباسم الحفلات والتعاون على جمع التبرعات، وما إلى ذلك من الأسماء التي خُدعنا بها وأُصبنا من قِبلها). [ص: 236]
وفي الكتاب أيضاً نزعة واضحة إلى إصلاح معتقدات العوام، وإنكار ما يقعُ من البدع والمحدثات، ومِن ذلك كلام المؤلفَيْن على حديث: اجتنبوا السبع الموبقات..
[أخرجه البخاري (2766) ومسلم (89)]،
حيث قالا عند تعداد أنواع الشرك: (وتعظيم الناس بما يُعظَّمُ به الله من أقوال وأفعال شركٌ، والنذر للأولياء والطواف بقبورهم، والاستغاثة بأسمائهم شركٌ، والشرك في جميع صوره وألوانه قاضٍ على الفضيلة، مميتٌ لعاطفة الخير، سبيل للتردي في الهاوية). [ص: 238]، فلنتأمل هذا الكلام وما يحويه من المعتقد الصحيح، ولنقارنه بما نراه اليوم من الفتاوى الرسمية التي تجيز سؤال الأموات، وطلب المدد منهم، لنرى الفرق بين علماء الأمس وعلماء اليوم.
والله المستعان.