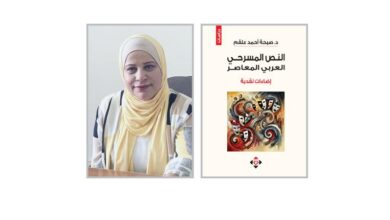الأمة الثقافية
“اللغة العربية والأسئلة الحضارية”.. تساؤلات يجيب عليها د. مصطفى عطية جمعة

الأمة : يقول د. مصطفي عطية جمعة في دراسة له بعنوان “”اللغة العربية والأسئلة الحضارية” بأن اللغة العربية كانت لغة حضارية في المقام الأول، بعد ظهور الإسلام وانتشاره، وتأسيس حضارته، ومن قبل ذلك، كانت لغة ثقافية عبّرت عن خصوصية الحياة العربية في الجاهلية، وشرفها الله تعالى بإنزال القرآن بها، فمن المهم مناقشة العوامل التي ارتقت بها العربية لتكون لغة حضارية، وأبرز المؤثرات فيها، والتعرض لمفهوم الازدواجية اللغوية، بنظرة معاصرة، وقضية ربط اللغة بالعرقية.
فإذا كانت اللغة عنصرا مستقلا للتواصل بين أبناء الجماعة اللغوية الواحدة، إلا أنها تصبح عنصرا حضاريا، عندما تحمل ألفاظها وتعبيراتها دلالات مستقاة من مرجعيتها الثقافية، وتجربتها الحضارية، ورسوخها الاجتماعي، وساعتها تتمكن في الأذهان والألسنة والأفئدة، ومن ثم تصبح اللغة أداة حضارية، وتكون سببا، ووسيلة، وغاية، في مواجهة أي غزو فكري أو استعماري.
ويمكننا أن نصف اللغة العربية بأنها لغة حضارية في المقام الأول، و”اللغة الحضارية” وفق تعريف إبراهيم السامرائي هي: اللغة التي سلخت من عمرها أحقابا طويلة، فكانت مرآة لأدب قويم عال، وفكر ثاقب متفاعل، وهذا يعني في المنطق اللغوي أن تشتمل على ألفاظ كثيرة شاملة لمدلولات كثيرة، تعبّر عن حاجات مختلفة عرضت للناس في مختلف العصور(1).
فاصطلاح “اللغة الحضارية” يعني في المقابل أن هناك لغات غير حضارية، فنعت اللغة بأنها حضارية، يشير إلى رحلة زمنية وتاريخية مع الحضارة، أثمرت تفاعلات أدبية وفكرية، وإثراءً لقاموسها اللغوي، الذي سيعبر عن حاجات الناس، وتطور حياتهم وعمرانهم وعلومهم وفنونهم حضاريا،
وسيترجم كل هذا في مفردات وتعبيرات، تمتاح من الجذور اللغوية الأصلية للغة، وتضيف عليها ما تستعيره من اللغات الأخرى، وعلى قدر ثراء الحضارة تُثرى اللغة.
سيكون السؤال: ما العناصر الحضارية المؤثرة لغويا؟ والجواب أنها: التجربة الروحية، والمذهب الفكري، والأداة في يد الصانع، كلُّ ذلك من عناصر الحضارة، فالمذهب والتجربة تراث، والأداة والآلة من قبيل المدنية، والجانب النفعي من كل أولئك مدني، وكلا الجانبين ينتهي إلى مفهوم الحضارة.
والثقافة هي حضارة مصغرة، فهي جزء من كل، فثقافة المجتمع جزء من حضارته، ولكل حضارة إطارها الروحي والفكري ومظهرها المادي، وهذا المظهر المادي يعرف باسم المدنية، أما الثقافة فيغلب عليها عنصرا الروح والفكر(2).
فالحضارة حاوية للثقافة بمكوناتها اللامادية، وهي تتسع أيضا لتشمل المدنية، بما تدل عليه من نشاط مادي، ومعرفة تطبيقية، فهي تشمل كل ما ينطوي عليه الكيان الاجتماعي من مبادئ الدين والسياسة والاقتصاد والأخلاق والثقافة،
أما المدنية فتعبر عما حققه الإنسان في واقع الحياة من خبرات عملية. فالحضارة إن لم تؤدِ إلى تطوير معيشة الإنسان، وفي تحقيق مستوى من الرفاهية له؛ تصبح مجرد علوم نظرية، غير مؤثرة. فالمدنية هي الوجه العاكس للتقدم الحضاري ماديا، مثلما أن اللغة تعكس التقدم الحضاري والثقافي بكافة أوجهه؛
وهو السبب الذي دفع أحمد أبو زيد إلى نعته للغة بوصفها قصةً حضارية، يقول: ” قصة اللغة هي قصة الحضارة الإنسانية، والحضارة لا تنعكس بوضوح في شيء مثلما تنعكس في الكلام واللغة، ويذهب بعض الكتّاب إلى القول بأن كل ما يظهر في لغة مجتمع من المجتمعات من نقص أو قصور، هو دليل قاطع على مدى تخلف ذلك المجتمع، في ركب الحضارة.
فالخبرة الإنسانية المتراكمة على مدى الزمان تنعكس في اللغة، وتجد تعبيرا لها فيها، سواء اتخذ ذلك شكل الكلام العادي أو الكتابة المعروفة أو الرسوم أو النقوش التصويرية..، أو حتى في الإنجازات الفنية المختلفة من معمارية أو موسيقية أو حركية، كالرقص والتمثيل الصامت، ما دامت كلها تترجم في آخر الأمر، إلى ألفاظ وتصورات ومفهومات ومشاعر.
واللغة حتى في معناها الضيق الرقيق.. يصعب قيام الحياة الاجتماعية المتماسكة المتكاملة.. فاللغة أداة التفاهم، الذي هو أساس التعاون بين أفراد الجماعة”(3).
انطلقت رؤية أحمد أبو زيد للغة من أعلى مراتبها، ثم المرتبة الأقل، ثم المرتبة الأدنى. فالمرتبة العليا للغة أن تكون لغة حضارية، تعبر عن كل مظاهر الحضارة والتقدم والمدنية، تتسع مفرداتها لتشمل المكتوب (العلوم والآداب) والمنطوق (الكلام)، والفنون، والموسيقى،
ويتجلى ذلك في اللغات الأساسية في الحضارات الكبرى، مثل الحضارات الإسلامية، والهندية، والفرعونية، والبابلية، والحضارة الغربية المعاصرة، مع تفاوت بنسب مختلفة، حسب إسهام كل حضارة، وامتداد عمرها الزمني، وبقائها أو فنائها، وتأثيراتها ومؤثراتها.
فهناك لغات حضارية كبرى، كانت واستمرت، ولا زالت، مثل اللغة العربية في الحضارة الإسلامية، واللغة الصينية في حضارة الصين، واللغة السنسكريتية في حضارة بلاد الهند، وأيضا اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في الحضارة المعاصرة.
أما المرتبة الأقل للغة، فهي تناسب المجتمعات التي بلغت شأوا من الثقافة، أو هي تابعة لحضارات كبرى، وتكون لغاتها المحلية مقتصرة على القطر، تحفظ الثقافة المحلية المتوارثة، وقد تنتج بها آداب وفنون، ولكن تظل تأثيراتها محدودة،
والمثال على ذلك اللغات الأوروبية محدودة الانتشار، مثل اللغة السويدية، واللغة الفلمنكية، واللغة الصربية، واللغة الرومانية، وكثير من هذه اللغات متفرعة من اللغة اللاتينية، فالناطقون بها محدودون بحدود الإقليم الذي يعيشون فيه.
ومن أجل التواصل مع بقية دول أوروبا، فإن شعوب هذه الدول مضطرة إلى استخدام لغات أخرى بديلة، أكثر انتشارا،ـ مثل اللغة الألمانية أو الروسية اللتين تستخدمان في المجر، وفي تشيكوسلوفاكيا(4).
وهو ما يطلق عليه “الازدواجية اللغوية”، وتعني إمكانية استخدام أبناء المجتمع الواحد لغتين من أجل التواصل؛ لغة محلية محدودة، وأخرى حضارية منتشرة، مثل المنطقة الألمانية في سويسرا ففيها اللغة السويسرية، واللغة الألمانية، وفي مصر فيها اللغة العربية واللغة النوبية ولغة أهل سيوة.
كما يشمل أيضا المجتمعات التي ينتمي أبناؤها إلى عرق واحد، ولكنهم يتكلمون لغة راقية، وأخرى وضيعة، ويقصد بذلك اللهجات المتفرعة من اللغة الأم، ومنها الدول العربية بلهجاتها(5).
فإذا نظرنا إلى الحالة اللغوية في العالم العربي، سنجد أن هناك لهجات، وبعض اللغات القليلة، وكلها تكاد تقتصر على كونها لغة تواصل يومي معيشي، ولغة الفنون التي تتخذ الشفاهية سبيلا، مثل الأغاني، والأشعار العامية، والفن التشكيلي الشعبي المصحوب بكلمات وأمنيات،
ولكن تظل اللغة العربية هي لغة العلم والتعليم، ولغة التراث، ولغة الاتصال الرسمي في الصحافة والمجلات. وتسقط في المقابل كل الدعوات التي انتشرت في العصر الحديث، وطالبت أن تكون العاميات المحلية هي لغة العلم والإبداع والإعلام، والتي بدأت على يد عدد من المستشرقين،
فقد قاسوا اللغة العربية الفصحى بمقاس اللغة اللاتينية، التي تحولت لهجاتها إلى لغات، ورأوا أن الذي يمنع العرب عامة، والمصريين منهم خاصة، عن الإبداع، والنهضة الحديثة تمسكهم باللغة الفصحى، التي نعتوها بالجمود، وأنها لا تواكب العصر(6)،
وهي دعوة خبيثة، غايتها إماتة الفصحى لتكون لغة مُتحَفية، لا يقرأها إلا المؤرخون والباحثون المنقبون في التراث، وتلك كارثة من المنظور الحضاري نفسه، لأن الشعب الذي يستطيع أن يقرأ تراثه ويفهم لغته؛ هو قادر على أن يجدد هذا التراث، ويجعله حيا، بل ويستحضره في نهضته الحديثة، يمتاح منه، ويضيف عليه، ويجدد لغته الفصيحة، بجعلها معاصرة، متجددة، قابلة لأن تُكتب بها العلوم الحديثة، وتُترجَم إليها.
وهذا لا يعني إهمال التراث الشعبي، وإن كان مكتوبا بالعامية، فاللهجات العربية قريبة من الفصحى بشكل عام، على تفاوت فيما بين هذه اللهجات، بل يجب أن نحتضن هذا التراث، ففيه الكثير من الأبعاد الجمالية والفنية والسوسيولوجية والنفسية، التي تمكننا من فهم الإبداع الشعبي الذي صاغه المبدع الشعبي، وتوجه به نحو البسطاء والعوام والنخبة أيضا طيلة قرون الحضارة الإسلامية،
مع تفعيل منهجية المقارنة بين الإبداع الفصيح والعامي، ورصد المؤتلف والمختلف بينهما، في الإطار الحضاري، وضمن السياقات التاريخية والمكانية والمجتمعية(7). وبذلك تتضافر روافد لغوية عديدة، في المسيرة الثقافية لشعوب الأمة، تشمل كل ما أنتجته المخيلة الإبداعية من فنون لغوية، بالفصحى أو بالعامية، وكلها تصب في النهر الحضاري للأمة.
أما المرتبة الأدنى لغويا، فهي تخص اللغات في المجتمعات البسيطة، قليلة العدد، وتكاد تقتصر على متكلميها، وتصبح وسيلة للتفاهم في الدائرة المجتمعية، وتكون عادة فقيرة في مفرداتها، وتعبيراتها، لأنها لا تملك رصيدا حضاريا أو ثقافة عميقة، وتوجد عادة في المناطق القبلية والبدوية في وسط آسيا، وفي أعماق إفريقيا، وكذلك ما تبقى لدى السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية.
ويمكن -في هذا الصدد- الحديث عن امتصاص بعض اللغات للبعض الآخر، فمثلا الفرنسيون يتكلمون اليوم اللغة اللاتينية، وهي لاتينية عمرها عشرون قرنا، تتميز بأصول ألمانية قديمة، وبمفردات مأخوذة من كلام الأجداد من شعب الغول. وأيضا هناك لغات تذوب، فقد ذابت الفرنسية والساكسونية لتولد منها اللغة الإنجليزية،
وهناك لغات اندثرت، وتبقّت نقوشها، وهناك لغات في طريقها للاندثار(8)، وهناك لغات ستعلو حضاريا، وستقبل عليها النخبة في العالم، لأن دولها ستعلو حضاريا وعلميا وسياسيا، فحركة الحضارة الإنسانية لا تعرف من يتربع على القمة إلى الأبد، وإنما هناك حضارات تعلو، ثم تخبو، وهناك حضارات كانت خابية وعلت.
وبناء على هذا، تسقط ادعاءات ربط اللغة الحضارية بالعرق والجنس، بمعنى أنه لا توجد لغة تعبّر عن جماعة مستطيلي الرؤوس، ولغة أخرى تعبر عن جماعة مستديري الرؤوس، أو أن هذه اللغة راقية تعبر عن رقائق الفكر ودقائق الإحساس، لأنها تعبر عن جماعة عرقية، أصحابها ناعمو الشعر،
وأن هناك لغة متخلفة لأن أصحابها مجعدو الشعر. وللأسف، فإن هناك مذاهب ونظما سياسية استغلت هذا التوجه، للتعصب لجنس ما، والزهو بلغته، واتخاذه ذريعة للسيطرة على شعوب تنتمي لأجناس أدنى منها، ويتكلمون لغات أدنى من لغاتهم، وبالتحديد أنصار الجنس الآري خاصة، والأوروبي عامة،
الذين رأوا أن عائلة اللغات الهندوأوروبية أسمى من اللغات السامية والحامية، وأن سائر اللغات يجب أن تخضع لها. وهو منظور سقط علميا، فلا يمكن للأنثروبولوجيين، أن يقولوا إن أصحاب الجماجم التي عثروا عليها، كانوا يتكلمون لغة متحضرة أو متخلفة، بل إن اللغة تنتشر لعوامل عديدة، لا علاقة لها بالجنس وشكل الجسد. فاللغة العربية انتشرت بين شعوب من أجناس مختلفة، لا تربطهم بالعرب الأصليين أية صلة(9).
لقد تحولت العربية من لغة ثقافة محلية، إلى لغة دين وعبادة، ولغة ثقافة عالمية وحضارة ممتدة، فهناك علاقة وثيقة بين اللغة الحضارية والخصوصية الثقافية، ففي الحضارة الغربية الحديثة، نجد أن مفردات اللغة والأساليب والتصورات وبناء الجملة، والتراكيب اللغوية والتشبيهات والاستعارات؛ تعبّر عن المجتمع الصناعي الحديث، الذي يتميز بتعقد نظمه الاجتماعية والاقتصادية، وشعور أعضائه بفرديتهم الذاتية(10)،
أي أن التميزات التي يقيمها مجتمع ما من المجتمعات، تظهر في تعبيراته اللغوية، معبرة عن أنماطه الثقافية، فالمسألة تبدو وكأن اللغة تختار من البيئة العامة بعض الملامح ذات الأهمية الخاصة، وهي لذلك تعطي لهذه البيئة الخاصة نوعا من التنظيم أو البناء الخاص بتلك الجماعة بالذات(11)،
وهو ما يفتح المجال لدراسة علاقة اللغة بالمجتمع والثقافة، ولتصبح اللغة معبرة عن ثقافة المجتمع، وعن طبيعة بيئته الجغرافية والطبيعية. والأمر ينصرف أيضا إلى طرائق التفكير في المجتمعات الحضارية وعلاقتها باللغة، والتي ستكون باستخدام أنواع معينة من الرموز، التي تبدو في لغة الناس وتعاملاتهم اليومية وأيضا في علومهم، وأيضا في أنواع الأشياء وماهيتها التي يعتقدون بأهميتها، وكذلك في الطرق التي يمثِّلون بها لأنفسهم العالم الفيزيقي والاجتماعي والأخلاقي الذي يعيشون فيه.
فالشعوب التي تتكلم لغات مختلفة، تعيش في الواقع عوالم مختلفة، واللغات التي يتكلمون بها تؤثر بدرجة كبيرة في مدركاتهم الحسية، وفي أنماط تفكيرهم المعتادة.
فهناك ما يسمى الكون الصغير الذي هو العالم الصغير الذي يحمله كل شخص في داخله، ويستخدمه في قياس وفهم العالم الكبير، وبالتالي فإن نظرة الإنسان إلى العالم الخارجي الواقعي، تحددها نشأته اللغوية، وكذلك في تصوراته عن الزمان والمكان(12).
فإذا كانت اللغة مرآة عاكسة لثقافة المجتمع، فهي أيضا عاكسة لتصورات الفرد في المجتمع، فهي أداة تعبير وتفكير، فالإنسان يفكّر ويعبّر من خلال الرموز والكلمات والتعبيرات التي تتيحها لغته. فالفرد عندما يعبر عن رؤية ما، أو موقف ما، فإنه يستحضر مخزونه الثقافي اللغوي،
والأمر جلي في الأمثال الشعبية، التي يستخدمها الفرد في تعبيراته اليومية، فهو يتوسل بالمثل للبرهنة على فكره، والمثل مأخوذ من الثقافة الشعبية المتراكمة، وإذا تأملنا تكوين الأمثال، سنجد أنها تعبر عن مواقف وأحداث وقصص مجتمعية، ربما تنسى القصة الأصلية، ويتبقى المثل المعبر عنها. أيضا،
فإن القاموس اللغوي المستخدم في المجتمعات الصحراوية يختلف عن مثيله في المجتمعات الزراعية، أو البحرية. والأمر يتعلق أيضا بالجانب الحضاري، فاللغة اليومية تعكس المستوى الحضاري الذي بلغه المجتمع، ففيها من المصطلحات والتصورات والمفاهيم والأدوات والأجهزة ما يبدو في اللغة اليومية، وأيضا في اللغة المكتوبة، ولغة الفنون والعلوم.
________________________________
الهوامش:
1 ) السامرائي، د. إبراهيم، اللغة والحضارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1977م/ ص8.
2 ) حسان، د. تمام، مقالات في اللغة والأدب، دار عالم الكتب، القاهرة، 2006م، ج2/ ص322.
3 ) أبو زيد، د. أحمد، حضارة اللغة، ، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد الثاني، العدد الأول، 1971م/ ص11.
4 ) شاهين، د. عبد الصبور، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط6، 1993م/ ص140.
5) كالفي، لويس جان، حرب اللغات والسياسة اللغوية، ترجمة: د. حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2008م/ ص79.
6) حسين، د. محمد محمد، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الجزء الثاني (من قيام الحرب العالمية الأولى إلى قيام جامعة الدول العربية، المطبعة النموذجية بالقاهرة، 1956 م/ ص 334 ، 335 .
7) الصويان، د. سعد، نحو تحديد مفهوم عربي للمأثور، مجلة الخطاب الثقافي، جمعية اللهجات والتراث الشعبي، جامعة الملك سعود، ع1، خريف 2006م/ ص160.
فهناك من يتحدث عن موت اللغة اللاتينية، والحقيقة أنها لم تمت، وإنما أصابتها تغيرات عميقة، وأنتجت أشكالا من لغات حديثة مثل البرتغالية، والقشتالية، ولغة قطالونيا، ولغة بروفانس، والفرنسية والإيطالية والإسبانية والرومانية. انظر: السعران، د. محمود، اللغة والمجتمع: رأي ومنهج، بدون ناشر، الإسكندرية، ط2، 1963م/ ص168، 169.
9) السعران، د. محمود، اللغة والمجتمع: رأي ومنهج/ ص66- 68.
10) أبو زيد، د. أحمد، ، حضارة اللغة، ص12.
11) السامرائي، د. إبراهيم، اللغة والحضارة/ ص28.
12) المرجع السابق- ص29.