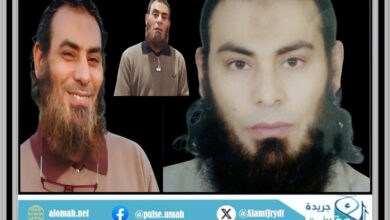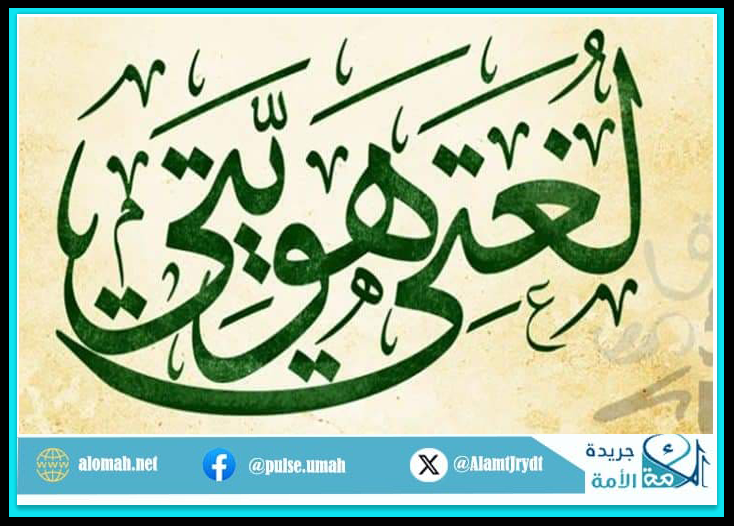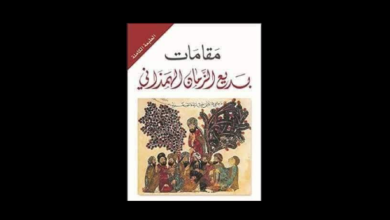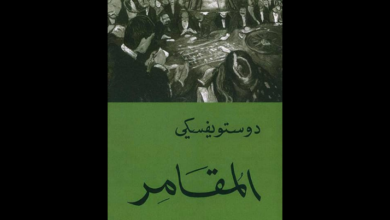قرأتُ لك: الشعر في الكتاب المدرسي
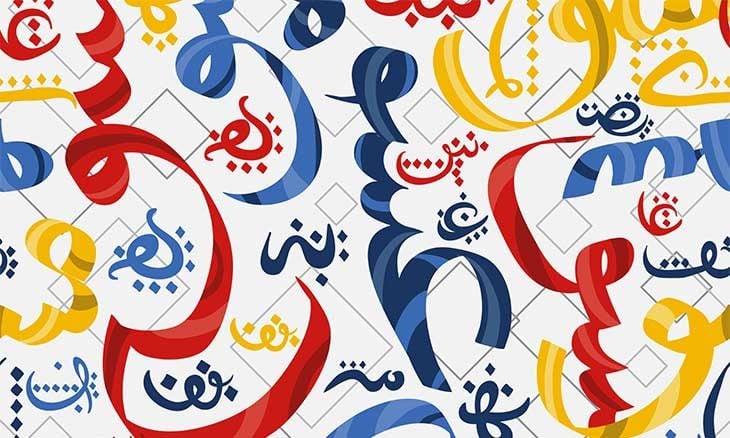
أي مفهومٍ للشعر في الكتاب المدرسي؟ ما هي صورته، والعلامات الرمزية التي تتشكل له؟ كيف يتلقى طلاب المدرسة هذا الفن؟ وإلى أي مدى تسهم الأطر المعرفية ذات الخلفية البيداغوجية والديداكتيكية في تقريبهم منه، وإحداث التأثير المنشود الذي تتطلبه قيمه وجمالياته الخاصة، ولاسيما داخل امتداد الشعر من التعلمات الصفية إلى الحياة المدرسية؟
في هذا السياق، نظّم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وبيت الشعر في المغرب، الدورة الأكاديمية حول «الشعر في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، يومي 13 و14 فبراير 2025، في العاصمة الرباط. وقد سعت هذه الدورة الأكاديمية التي شاركت فيها مجموعة من الشعراء والمفكرين والباحثين في علوم التربية والديداكتيك وناشري الكتب المدرسية، إلى إثارة النقاش حول وضعية الشعر داخل المنظومة التربوية، ورصد مكانته وتشخيصها، واستشراف آفاق تطويرها من خلال اقتراح الآليات المنهجية والصيغ الديداكتيكية الكفيلة بتطوير المعرفة بالشعر وطرائق تدريسه وتقوية خبرات المدرسين ومهاراتهم لتأديتها، من أجل إكساب المتعلمين الكفايات والمهارات الملائمة لقراءة الشعر والشغف به وتثمين ما فيه من قيم وجماليات نوعية تعزز الاندماح والتواصل بينهم، والشعور الصادق بإنسانيتهم، بقدر ما تعمل على الرقي بمداركهم ورؤاهم نحو الأشياء وعناصر الوجود التي تحيط بهم في عالمٍ رقمي ومادي جارف.
انتظمت وقائع الندوة في خمسة محاور: أي مكانة للشعر في المنظومة؛ مفهوم الشعر في الكتاب المدرسي؛ الشعر بين التعلمات والحياة المدرسية؛ مواصفات التكوين الخاص بمدرس الشعر، ثُم شهادات شعراء مغاربة حول تجربتهم في تدريس الشعر.
درس الشغف
عندما التحقتُ بمهنة التدريس، كان درس الشعر محط عنايتي، والقيام به بمثابة واجب إنساني وأخلاقي في آن. كان تصوري له آخذا بأطراف من القديم والحديث معا، مُتعددَ الروافد بقدر ما بدا متسامحا ومفتوحا على التأويل ضمن العُـدة المعرفية والديداكتيكية التي كان يتيحها المنهاج الدراسي، وتُمليها إكراهات الإنجاز الصفي. كنتُ آخذُهُمْ برفقٍ إلى نصوص الشعر، وما تقترحه من جمالياتٍ خاصةٍ؛ كأني آخذهم في نُزْهةٍ، حريصا على أن يكون صوتُ الشاعر من نص إلى آخر، مسموعا عندهم على نحو ما توحي به تجربته الحياتية والفكرية، ولا أُثقل عليهم من أجل توصيله بمصطلحاتٍ مُجردة بداعي المنهاجية؛ بل أترك لهم مسافة جمالية للانجذابُ إليه واستكشافه وتذوق ما فيه، بعد أن يكونوا قد استأنسوا بالنص الشعري ووقفوا على رصيده المعرفي وغوامض لغته في فترة الإعداد القبلي، ثُم يتطور الأمر إلى تبين ملامح تلك التجربة وتثمينها، سواء في علاقتها بخواص الفن الشعري وسننه الثقافي، أو بالاتجاه الجمالي الذي ينتمي إليه، أو بالعصر الذي عاشه وتأثر به: يقفون في أول الأمر على عتبات القصيدة وموازياتها النصية لاقتراح فرضيات القراءة، ويقرؤون القصيدة بالتناوب أكثر من مرة، وينبرون على إيقاعها بشكل يعكس إنشاديتها أو بناءها النصي حسب شكلها المعماري، ويجزئون أقسامها ويضعون لكل قسمٍ فكرة خاصة به، فيصلون بينها من أجل تركيب عام لغرض القصيدة أو موضوعها، ويجردون الحقول الدلالية ويكتشفون نواتها الدلالية التي ساهمت في إنتاج المعنى، ويستخرجون وَزْنَها من خلال تقطيع بعض أبياتها عروضيا، ويتبينون ما حدث فيها من تغييرات (زحافات وعلل)، وقافيتَها وريها ومظاهرَ من إيقاعها الداخلي (موازنات صوتية، تصريع، جناسات، تكرار، توازٍ..)، وهل لإيقاعها صلةٌ بغرضها أو موضوعها بطريق الفهم والتأويل، ثُم يفكرون في نماذج تمثيلية من صورها ومجازاتها ورموزها وضمائرها الشخصية، لتحليلها وإبراز ما تنطوي عليه من خصائص وتلفظات فنية خاصة، قبل أن ينتهوا إلى تركيب كل ذلك على نحوٍ يقودهم إلى تعيين أسلوب الشاعر وملامح تجديده الشعري ورؤيته للذات والأشياء والعالم.
من الإقراء إلى القراءة
كانت مراحل إنجاز النص الشعري (فرضيات القراءة، الفهم، التحليل، التركيب) تصدر عن القراءة المنهجية للنصوص التي جرى العمل بها داخل الثانوية المغربية ابتداء من أواسط التسعينيات من القرن العشرين، بديلا عن طريقة تفسير النصوص التي كانت تغرق في الشرح وتحصيل ما هو مُقرر سلفا. للمنهجية، بما هي مقاربة ديداكتيكية، مرتكزاتُها المعرفية وأطرها المرجعية التي تولي أهميتها للنص كنسيج لغوي وأثر فني، وتستمد مفاهيمها وأدواتها القرائية من المناهج النصية والنسقية (البنيوية، لسانيات النص، السيميائيات، جماليات التلقي، إلخ)، والأهم فيها أنها تحرص على مركزية المتعلمين في سيرورة بناء معنى النص والمعرفة به، من خلال تطوير أدواتهم الخاصة في التعامل مع الوضعيات التي يواجهونها، وقياس ردود أفعالهم الأولى كقُـراء، ومن ثمة كانت تساهم في تنمية مهارات تفكيرهم النقدي.
كانت المنهجية طموحة بالفعل، وصارمة كذلك. ولهذا لم يكن درس الشعر سالكا أو متاحا للجميع؛ إما لطبيعة نسيجه النصي وخصوصيته الفنية والجمالية، ثم لطبيعة «المُدْخَـلات» أو المكتسبات التي كان يأتي بها المتعلمون إلى النص الشعري، وكانت ردود أفعالهم تتفاوت قياسا إلى كونه قديما أو حديثا؛ فكان إنجاز النص يتطلبُ حِصتيْن أو ثلاث حصص، بل لم تكن وضعيته الصفية تخلو من مفاجآت وإكراهات، ومن نوبات ضحك أو تذمر كتوم. مثّلَ لي ذلك ذريعة، وحافزا داخليا، أكثر من أن يصيبني بالإحباط. كنتُ أتعلم من ذلك باستمرار، وأتغلبُ عليه بما يتيحه لي نشاطُ التقويم التكويني أو الإجمالي من خلال التمحيص الدائم والمستمر للفرضيات التي تمتْ صياغتها، ومن خلال الاشتغال على مستويات معينة في النص المدروس، ما زال حولها صَمْتٌ أو سوءُ فهم؛ مثل المستويين الإيقاعي والتصويري على وجه الخصوص.
كان هاجس الدرس، وما يترتب عليه من جهة الديداكتيك، وسؤال المعرفة بالشعر، يتقومُ عندي باعتبار القصيدة ليست إلهاما وحسب، بل صنعة فنية تتطلب مراسا وخِبْرة، وأن لهذه القصيدة تاريخية خاصة بها تهجع في ذاكرتها، ولا وعيها، ولها سَنَنُها الثقافي ضمن مجرى تاريخ الشعر العربي، بل إني حرصتُ على إيصال فكرة أساسية إلى جمهور المتعلمين في كل الأوقات: الشعر ليس ترفا جماليا، إنما هو ضرورةٌ مثل الصلاة والخبز والماء والهواء؛ ضرورةٌ في حياة الشاعر وفي حياة أُمته، وفي وجود الإنسان بِـرُمته.
أعترف بأن الكتاب المدرسي، وفي مسلك الآداب والعلوم الإنسانية تحديدا، كان حافلا بالشعر، وكانت الحصة التي تُسند للشعر ضمن هذا الكتاب ناصعة للعيان، وكان المنهاج نفسه ينتقل من وضع الإقراء إلى هاجس القراءة المنهجية، بل إن دواعي تأليف الكتاب كانت تُمليها شروط معرفية وديداكتيكية ذات اعتبار في علاقتها بدرس الشعر وتصريف أجرومياته؛ إذ كان يُراعي لإنجاز وَضْعياته الصفية والتفاعلية مبدأ التدرج، قياسا إلى طبيعة الفئة المستهدفة وحاجياتها ومداركها في كل سلك: من دَرْسٍ يُركز على جنس الشعر من حيث مفهومه وموضوعاته وأساليبه ـ وهذا الأمر يخص حتى الشعبة العلمية نفسها- إلى دَرْسٍ يندمج في سياق تاريخ الشعر القديم من جهة أصول القصيدة العربية وموسيقاها وأغراضها وأساليبها، وما وقع فيها من تَحول شكلي وثيماتي وجمالي عبر عصورها الذهبية حتى العصر الأندلسي، ثُم إلى دَرْسٍ يعتكف على إبراز التحولات الفنية الرئيسة التي ميزت القصيدة العربية واتجاهاتها الفنية في العصر الحديث. وكانت ثمة نصوص نظرية ونقدية لكبار دارسي الشعر العربي تُمهد لهذا الدرس وتتخللهُ، مع ما تُقدمه من مفاهيم ومقولات وأطر منهجية معرفية وجيهة لقراءة هذا الشعر والتواصل معه ثقافيا وجماليا.
في قلب الحياة المدرسية
بيد أني وجدتُ الشعر المغربي داخل الكتاب في وضعيةٍ هي أقرب إلى أن تكون هامشية، وأكثر ما يرِدُ منه هو عبارة عن نُتَفٍ توضيحية، على نحو يصير فيه متنا لـ»خارج»، أو يُكرس تبعيته للشعر المشرقي الذي يُنْزَل منزلة خاصةَ ويُحتفى به. كما وجدتُ أن تمثيلية بعض نصوص الشعر العربي، قديمه وحديثه، غير منسجمة مع الأطر المرجعية والمعرفية تبعا لسيرورة الكتاب وكفاياته القرائية، بل تبدو مُنفرة للحس المشترك لدى التلاميذ، إما بسبب لغتها، أو تجريديتها، أو مناخها الذي تُخيم عليه غُلالةٌ كثيفةٌ من الحزن والشعور بالضياع. وهذا واحدٌ من الأسباب الحقيقية التي تجعل هؤلاء التلاميذ يقدمون السرد على الشعر، ويرغبون في امتحانهم بقصةٍ أو مقالةٍ على الأرجح، درءا لكل شؤم وسوء عاقبة. وأُحب أن أسوق هذه الاعتبارات التي استخلصتُها مِما كان يواجهني باستمرار، ويَـعِن لي أثناء سنوات تدريسي للشعر:
الحاجة إلى مُؤلف شعري مُـوازٍ يجري إدراجه في إحدى الدورتين لكُل سلك دراسي، من شأنه أن يُعزز عند المتعلمين معرفة جديرة بالشعر من خلال المناقشات الدائمة التي يُجْرونها حوله، والعروض التي تُنجز فيه. قد يكون هذا المؤلف ديوانَ شعرٍ لشاعر أساسي في ثقافتنا العربية، أو مختاراتٍ شعرية لحقبة شعرية أو جيلٍ من الشعراء، أو يكون حول اتجاهات الشعر العربي الحديث وقضاياه وقيمه، يعبر عن جماليات هذا الفن وانفتاحه على روح العصر والحضارة الإنسانية، بديلا عما كانت تُمليه في السابق اختياراتٌ ذات طبيعة أيديولوجية أو مذهبية ضيقة.
إن القراءة المنهجية التي كانت تذهب إلى درس الشعر بأدواتها ومقولاتها المقررة، كانت تنحدر في كثير من الأحايين إلى وصفة جاهزة ووحيدة تُطبق على أي نص شعري، ومن ثمة كانت تتحول إلى غايةٍ في حد ذاتها. وقد التقطَ بعض قَعَدة التلاميذ ودُهاتِهِمْ هذا الأمر، فعملوا على استنساخها وحفظ خطواتها وتحايلوا عليها تَدْليسا لغرض الإغراء والتعمية على واقع الحال. ولهذا، ينبغي التنويع في أطر هذه القراءة ومداخلها، بشكلٍ يسمح للتلاميذ بتفتيق مواهبهم في التعبير ومهاراتهم في التفكير النقدي.
ينبغي أن يتم دَمْج مُكوني اللغة والتعبير والإنشاء في نسيج القراءة المنهجية على نَحْوٍ وظيفي، وضمن مقاربة تساندية مثمرة، لأن مثل هذه المُضايفة/ التساند بين هذه المكونات الثلاثة يسند أدوات القراءة ويُمتن عُـراها، بقدر ما يمد الفئة المستهدفة بمهارات وتقنيات ومنظورات عبر وضعياتٍ حواريةٍ وتفاعليةٍ، تطلق استجاباتهم وملكاتهم وردود أفعالهم وتعكس مواقفهم من القيم والمواضعات التي يحيونها في عالم متحول.
إيلاء الأنشطة الموازية (ورشات الكتابة والقراءة، مسابقات شعرية، محاضرات في فن الشعر، لقاء حواري مع شاعر(ة)، توقيع ديوان شعري، إلخ)، ما تستحقه من عناية خاصة من جميع أطراف العملية التعليمية، بسبب ما تقوم من أدوار تربوية وثقافية وجمالية، لأنها تساعد هؤلاء المتعلمين على الاندماج والتواصل بينهم والشعور بالأمان النفسي والاجتماعي، كما تُمثل متنفسا لرعاية مواهب الشعراء الناشئين وإقدارهم على كتابة الشعر وإنشاده والبوح بمشاعرهم وأحلامهم، من خلال ما تتيحه لغته وباقي وسائله الممكنة في التعبير، بما في ذلك الوسائل التي تتيحها التقنيات الرقمية الجديدة؛ وفي طليعتها الذكاء الاصطناعي.
منذ البدء كان ثمة إخلاصٌ لهذه الأنشطة من أجل أن يكون للشعر امتدادٌ في الحياة المدرسية طوال السنة الدراسية، وليس فقط في مناسبة اليوم العالمي للشعر. كانت عيناي لا تخطئ، كان بينهم نابهون، مُتحمسون، حالمون، يسكنهم الشعر ويتذوقونه، وكلما سنحتْ لهم سانحةٌ، في مسابقة وغيرها، يظهرون مواهبهم بثقةٍ وحُب، ويدفون أجنحة خيالهم لأول مرة كفراخٍ مُؤْمنةٍ بالتحليق، بل تجد بينهم من أتى من الشعبة العلمية ليس أقل حماسا منهم، قد زاحمهم في الصفوف الأمامية وأظهر العجب. إن هؤلاء يجعلونك تحلم معهم، ويسافرون بك إلى طفولتك ومراتع صباك الدافئة، ويُشعرونك بأنك موجودٌ بالفعل. الحلم، التطلع والوعي بالكينونة: هذا أعز ما يُطلب في الشعر.
عبد اللطيف الوراري (صحيفة القدس العربي)