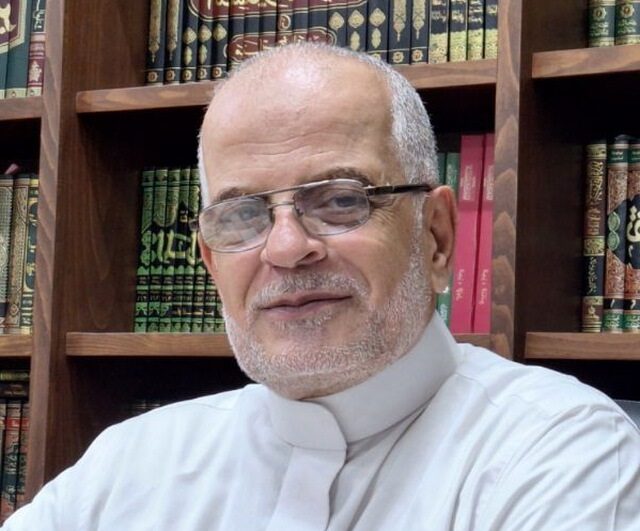في 30 ديسمبر 1993 وقّع الفاتيكان الاتفاق الأساسي الذي يعترف فيه بدولة إسرائيل.. وكم أدهش هذا القرار المتابعين للأحداث السياسية، فمنذ أن تم إنشاء هذا الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين كان البابوات يتشدقون بضرورة ضمان وضع دولي لمدينة القدس. وهو ما كان قد أوضحه البابا بولس السادس، حينما زار الأراضي المقدسة عام 1964، أثناء انعقاد مجمع الفاتيكان الثاني، ودافع عن حق الرسالات التوحيدية الثلاث في مدينة القدس. ورغمها أعلن الكيان الصهيوني في أغسطس 1980 ضم القدس واعتبارها «عاصمة أزلية» لإسرائيل.
والغريب أيضا أن البابا يوحنا بولس الثاني أعلن، بعد هذا القرار، في خطابه الرسولي بعنوان: «عام الفداء» الصادر في 20 أبريل 1984، ما يجعله يبدو وكأنه يتجاهل قرار الغزاة المحتلين، قائلا: «إن الشعوب والأمم التي لها أخوة في الإيمان بمدينة القدس، مسيحيون، ويهود، ومسلمون، لديهم دافع خاص ليبزلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على الطابع المقدس، المتفرد، والذي لا يعوض للمدينة. لذلك لا بد من إيجاد وسيلة حاسمة وفعّالة للحفاظ بصورة متجانسة وثابتة على مختلف المصالح والتطلعات، لحمايتها بصورة مناسبة وفعّالة بوضح يتم ضمانه دوليا».
ومن الواضح أن عبارته القائلة «أخوة في الإيمان» كانت تتضمن الرسالات التوحيدية الثلاث، كما أن عبارة «مختلف المصالح» تعنى أتباع الرسالات الثلاث، وأن الفاتيكان آنذاك كان يأخذ في الاعتبار حق الإسلام والمسلمين في القدس، ولو شكلا أو حتى يبدو مطلبه محايدا. أما المطالبة بوضع ضمان دولي لمدينة القدس فتكشف عن أن الكرسي الرسولي لم يعد يثق تماما في قادة الصهاينة لضمان التوافق المطلوب، أو أنه بدأ يدرك مؤخراً الهاوية التي سقط فيها بتبرئتهم وبالاعتراف بدولة لهم على.
وكان الأجدر به أن يدرك معنى الهاوية الجحيمية التي انساق إليها بتوقيعه على مثل هذا الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، متناسيا أن المسيحية الحالية قائمة أساسا على رفضها وبترها لليهودية، وعلى لعن اليهود ومحاربتهم على مدى ألفى عام تقريبا. ومن المؤسف إضافة أن ذلك الاعتراف يعنى رضوخ أعلى سلطة دينية في الغرب للقوى الصهيونية الجامحة، التي تتلاعب وتعربد بكافة القرارات الناجمة عن المجتمع الدولي ومؤسساته.
والغريب أن هذا الاعتراف الإجرامي من جانب الفاتيكان يناقض موقف البابوات السابقين وموقف الكنيسة الكاثوليكية الرسولية الرومية على مدى تاريخها.
وتكفى الإشارة إلى البابا بيوس العاشر الذي كان قد التقى بتيودور هرتزل في 25 يناير 1904، ورفض فكرة الموافقة على إنشاء دولة للصهاينة قائلا: «إن اليهود لم يعترفوا بربنا يسوع وبالتالي لا يمكننا الاعتراف بالشعب اليهودي»!. أما الكاردينال مرّى دل فال، الذي كان برفقته فقال: «طالما يُنكر اليهود الاعتراف بألوهية المسيح لن يمكننا بكل تأكيد مسايرتهم. لا يمكننا. لا لأننا نتمنى لهم أي سوء، بالعكس، لطالما حمتهم الكنيسة. أنهم بالنسبة لنا شهود ضروريين على ما حدث عندما زار ربنا الأرض. لكنهم مصرّون على إنكار ألوهية المسيح. كيف إذن يمكننا قبول استحواذهم على الأرض المقدسة إلا إن أنكرنا نحن أعلى مبادئنا؟» (وارد في كتاب أندريه شوراكي «الاعتراف»، 1992، صفحة 108). وقد تم إضفاء صفة القداسة على البابا بيوس العاشر، بمعنى أنه يمثل إيمان الكنيسة، وإيمان الكنيسة حتى مطلع القرن العشرين كان يعنى عدم الاعتراف بدولة للصهاينة!
وقد انتهت فترة البابا يوحنا بولس الثاني بصورة تكشف عن مدى عمق الكارثة، إذ لم يعترف الفاتيكان بأول دولة دينية عرقية في التاريخ فحسب، ولم يخرج عن كل تعاليم دينه أو «إنكار مبادئه العليا» فحسب، وإنما بدأ يساير دولة الصهاينة بمزيد من التنازلات الفاضحة: فكان يوحنا بولس الثاني أول بابا يذهب لزيارة المعبد اليهودي في روما، قائلا لأول مرة: «إخواننا الأكبر منا»، وإعلانه في 17 نوفمبر 1980 عن مسؤولية الكاثوليك تجاه اليهود، وأنها تتضمن ثلاث نقاط : تعليم التراث اليهودي للكاثوليك، دراسة معاداة السامية وما اقترفه المسيحيون من أعمال انتقامية على مر التاريخ، ويا للعجب: زيادة التقارب الروحي بين اليهود والمسيحيين! ووقف نفس ذلك البابا في سنة 2000 يبكى ويصلى أمام ما يطلقون عليه زورا وبهتانا: «حائط المبكى». فهذا الحائط هو «حائط البراق»، وهو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى..(تناولته بالتفصيل في كتاب «حائط البراق» 2001، والطبعة الثانية عام 2004 بعنوان «من حائط البراق إلى جدار العار»).
ويواصل البابا بنديكت السادس عشر نفس المسيرة المخزية. ففي الخطاب الأول الذي ألقاه بمناسبة توليه منصب البابوية، وبعد أن قام بتحية مختلف الفئات الكاثوليكية حتى العلمانيين منهم، «الذين يعاونون على إقامة مملكة الرب في العالم»، أي المساهمين في عمليات التبشير واقتلاع الإسلام التي فرضها عليهم مجمع الفاتيكان الثاني سنة 1965، واصل البابا قائلا: «إلى كل الذين لم يندمجوا معنا كلية بعد رغم حصولهم على التعميد»، ويقصد بهم أتباع الكنائس الأخرى، أضاف : «وأنتم، الأخوة الأعزاء من الشعب اليهودي، الذي نرتبط معه بتراث روحي مشترك تمتد جذوره في وعود الرب التي لا رجعة فيها»، ثم أنهى تلك التحية الكاشفة عن موقفه من الإسلام والمسلمين من أول يوم له في هذا المنصب قائلا: «وأخيرا فإن فكرنا يتجه أيضا إلى جميع رجال عصرنا، المؤمنين وغير المؤمنين»، وواصل الخطاب..
ويا له من إغفال أو استبعاد له مغزاه، فمنذ الكلمات الأولى الرسمية التي نطق بها استبعد الإسلام والمسلمين، ولا ندرى في أي فئة وضعهم في ذهنه: من ضمن المؤمنين، أو غير المؤمنين.. ولا غرابة في ذلك فقد سبق للفاتيكان أن وضع الإسلام عام 1965 مع الديانات الأسيوية، في وثيقة «في زماننا هذا» الشهيرة لاستبعاده عن رسالة التوحيد !
وإن كان لهذا الخطاب الافتتاحي أي معنى، فهو يشير بوضوح إلى موقف البابا المتعمّد العداء للإسلام، كما يشير إلى أن الإسلام والمسلمين ليسوا مستبعدون فحسب تماما من تلك المسيرة المشتركة بين الصهاينة والفاتيكان وإنما يعمل الفريقان معا على اقتلاعهم، وبالتالي فإن الآثار الإسلامية الموجودة في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس، وأهمها المسجد الأقصى، لا مكان له فى تلك الجريمة المشتركة.. ولا غرابة في ذلك أيضا، فالسيد بنديكت السادس عشر كان قد نشر بحثا، قبل توليته منصب البابوية بثلاث سنوات، يتناول فيه السيدة مريم والإيمان المريمي، وقد أطلق عليه عنوان: «ابنة صهيون»!!.. ولعل ذلك يكشف عن سبب انتخابه.
وهذا التحالف الحالي بين الفاتيكان والصهاينة، الذي بدأ بتبرئة اليهود من دم المسيح، ثم بالاعتراف الرسمي والدبلوماسي بدولة إسرائيل، هو بمثابة تحالف غير شرعي من الناحية الدينية، فوثيقة «التبرئة» لم تعتمد على أي نص كنسي سابق، كما هي العادة في مختلف النصوص لأنها تخالف الخط التاريخي لها، بل كفّت حتى عن احترام ذلك «العهد» الجديد الذي تقول أنها بموجبه تعتبر الكنيسة نفسها «شعب الله المختار الجديد» بدلا من اليهود! بل راحت الوثيقة تقر باستمرارية العهد الخاص باليهود !.. والفاتيكان، بذلك الاعتراف، يعتدى شرعا على لعنة أحلّت بهم لعدم اعترافهم «بربنا يسوع» -كما يقولون- ويعتدى على لعنة أنزلها الله عز وجل باليهود لابتعادهم عن رسالة التوحيد ورجوعهم إلى عبادة العجل وقتل الأنبياء، فتم هدم المعبد سنة 70م، وفُرض عليهم الشتات ولم تقرب البقية الباقية منهم ارض فلسطين بعد ثورتهم الثانية ضد الرومان عام 135م.
إن ما تناسته المؤسسة الفاتيكانية أن المسيحية انبثقت من بترها عن اليهودية، لأن رفض اليهود لرسالة يسوع، الذي لم يأت إلا من أجل خراف بيت إسرائيل الضالة (متى 15: 24) قد أدى إلى إعادة صياغة النصوص والخروج بدين لا يعرف عنه يسوع أي شيء.. وإن الاعتراف بالسلطة الدينية اليهودية يعنى أنه لا حاجة لوجود تلك المسيحية!. ويا لها من بداية انتقام رهيب..
ولا يمكن لمثل هذه المؤسسة العاتية، التي فرضت عقيدتها بالسلاح والقتل والاقتلاع ومحاكم التفتيش والتعذيب والحروب الصليبية والدينية والتعتيم ولىّ الحقائق وتحريف النصوص، وكلها حقائق باتت تملأ الكتب والمراجع بل والمجلات العلمية وغيرها، لا يمكنها أن تتنازل طواعية عن كل ما شيدته بمثل ذلك العنف الدامي على مدى ألفي عام تقريبا، أو أن تتنازل بمثل هذه البساطة، إن لم يكن هناك ما هو أقوى وأعتى منها ومن جبروتها. وهو ما تناولته بالتفصيل في كتاب «المساومة الكبرى، من مخطوطات قمران إلى مجمع الفاتيكان الثاني».. المطبوع في قطر ومنعته الرقابة في القاهرة!.
وإذا نظرنا من ناحية الصهاينة، لوجدنا أن إنشاء دولة لا يمثل في الواقع نهاية المطاف وإنما مجرد بدايته.. فما يرمون إليه تحديدا هو استعادة مكانتهم كشعب الله المختار -تلك المكانة الدينية التي سلبتها الكنيسة إياهم.. وذلك لا يتأتى إلا «بإقامة سلطة دينية يهودية جديدة في القدس»- على حد قول جيرار إسرائيل في كتابه المعنون: «المسألة المسيحية فكرة يهودية عن المسيحية». وهذه السلطة الدينية اليهودية الجديدة في القدس لا تتأتى إلا بهدم المسجد الأقصى وإقامة المعبد -بغض الطرف عن كل ما واكب تلك المسيرة الانتقامية من تحريف للنصوص الدولية والتاريخ بل ولحكم الله عز وجل وقضائه-..
ولا يسع المجال هنا لتناول كيف تم ذلك اعتمادا على الغش والتنازلات والخيانة من جميع الأطراف، فالكل متواطئ بصورة أو بأخرى، وما أكثر الكتب والمؤتمرات والقرارات والوثائق، لكنا نتوقف عند الوضع الراهن وكيف تمكن الصهاينة من تلجيم الغرب المسيحي المتعصب عن طريق قضيتين أساسيتين، هما: المحرقة، ومخطوطات قمران أو البحر الميت.
فقد تم تصعيد لعبة المحرقة إلى درجة الإطاحة لا بكل من يتشكك في عدد موتاها فحسب، وإنما بكل من يمس بمصداقيتها، والأدهى من ذلك التلويح بدور الفاتيكان فيها! وبذلك تم فرض صورة «اليهودي المظلوم المعتدى عليه دوما»، مع تحميل الغرب وزرها، أمام صورة «الفلسطيني المسلم الإرهابي»، لأنه يدافع عن أرضه، بل وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين بصورة لا سابقة لها في التاريخ! أما مخطوطات قمران التي تم الإعلان عن اكتشافها في نفس ذلك اليوم الذي تم فيه الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948، علما بأنها مكتشفة قبل هذا التاريخ، فذلك يكشف أن هناك صلة وثيقة بين الإثنين -خاصة لمن تابع تفاصيل قصتها والمغامرات التي واكبتها وحقيقة محتوياتها-.
وتكفى الإشارة هنا إلى قصة اكتشافها والتعتيم عليها وكل ما واكبها من قمع وتحكم من اللجنة العاكفة عليها والتابعة للفاتيكان، أو لكل ما قام به الصهاينة للاستيلاء على بعضها وإيداعها فى متحف خاص بها بجوار مبنى الكنيست. وهو ما يكشف عن مدى أهمية ما استولوا عليه. والتعتيم على نشرها لمدة خمسين عاما يمثل أكبر فضيحة علمية في القرن العشرين. ولم يسمح الفاتيكان بنشرها إلا بعد ترحيل تاريخ تحليل الكربون لمحاولة فصلها عن المسيحية. ويرجع التعتيم عليها، وفقا لما قيل فور اكتشافها، إلى أن بها ما يهدم المسيحية ويطيح بها إلى الأبد.. وتلك هي ورقة المساومة الكبرى التي يمسك بها الصهاينة ويفرضون بها كل تلك التنازلات المهينة على المؤسسة الكنسية وعلى المجتمع الدولي وكل قراراته التي يضربون بها عرض الحائط.. فهم المتحكمون!
ولو انتقلنا إلى شكل الوضع حاليا، لوجدنا: من ناحية، سباق محموم من المؤسسة الكنسية لتنصير العالم وخاصة لاقتلاع الإسلام، اعتمادا على الحوار ومؤتمراته لكسب الوقت حتى تتم عملية التنصير دون مقاومة تذكر، كما يقولون في النصوص الرسمية، مع محاولة واضحة لتنصير معالم المدن وخاصة الإسلامية منها، إضافة إلى عمليات القتل الجماعي في تلك الحروب الاستباقية الاستيطانية وكلها تحصد في أعداد المسلمين.. ومن ناحية أخرى، سباق آخر محموم، من جانب الصهاينة، لتنفيذ قرارهم عندما احتلوا أرض فلسطين واستولوا عليها، بأنهم يريدونها «أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض».. وهو ما يتم تنفيذه على مرأى ومسمع من ذلك المجتمع الدولي الذي تم تلجيمه، فالتزم الصمت وألف الخضوع صمتا إلا من بعض العبارات الجوفاء من قبيل نرفض، نحتج، نشجب، نعترض، الخ، ذرا للرماد في الأعين! وياله من منطق، فبعد أن ابتلع طُعم مسئوليته عن المحرقة، تولى القيام بمحرقة للشعب الفلسطيني تكفيرا عن ذنبه!
فواقع الأمر يؤكد أن الصهاينة قد استولوا على 80 % من أرض فلسطين أيام حرب 1967، ثم التهم جدار العار 40 % من أراضى الضفة الغربية، أي أنه لا يتبقى فعلا من كل أرض فلسطين سوى 9 %، التي تدور حولها الوعود والأكاذيب والتلويح الأجوف بإقامة دولة فلسطينية. وما أشبهها لعبة بذلك الحوار الذي تقوده الكنيسة لمجرد كسب الوقت حتى يتم لهم ما يبتغون.. ذلك لأن جدار العار يبلغ طوله 730 كيلو متراً بارتفاع ثمانية أمتار من الأسمنت المسلح، وبه برج مراقبة كل 300 متراً، وأسلاك شائكة مكهربة، إضافة إلى خندق بعمق مترين. والجدار يقام بتكلفة أكثر من مليون دولار للكيلومتر الواحد.. وكل ذلك: لحماية الصهاينة الغلابة الذين لا يملكون، دونا عن غيرهم في الشرق الأوسط، سوى ترسانة نووية وأسلحة فتاكة ومتطورة وكيميائية، لحمايتهم من حجارة الانتفاضة! وياله من منطق يبلعه الذين فُرض عليهم الصمت والتواطؤ..
وبناء الجدار بالصورة التي تم بها حول القدس الشرقية، أو هو بالفعل بناء جدارين متتاليين حولها كالطوق المزدوج، يبيد أية تطلعات بأن تكون هذه الجزئية المحاصرة بالسياج عاصمة لوهم يُدعى «دولة فلسطينية». فالجدار يفصل بالفعل مدينة القدس عن مدن الضفة عند رام الله في الشمال، وبيت لحم في الجنوب، وأبو رديس في الشرق، كما اخترق حرم جامعة القدس واقتلع ثلث مساحتها. وذلك يعنى تطويق وحماية مدينة «القدس الكبرى» كما حددها الصهاينة. فالبرنامج يسير على أساس عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية بأي ثمن، وعدم السماح بأي وجود فلسطيني، بل والعمل على محاصرتهم حتى الموت أو إجبارهم على الهجرة، وبذلك يكونوا هم الذين رحلوا بإرادتهم! أي أنها تكرار لنفس مخطط البداية الذي بدأ بالإرهاب وبمحاصرة الفلسطينيين وحصادهم في المجازر المتعددة لطرد من يتبقى.. وهو ما تؤكده تصريحات وزيرة خارجيتهم عقب لقائها مع نظيرتها الأمريكية يوم 1/8/2007، إذ أعلنت: «إن إسرائيل لن توافق على بحث القضايا الأساسية للنزاع مع الفلسطينيين وهي: الحدود، واللاجئين، ومستقبل القدس، خلال المؤتمر الدولي للسلام الذي دعي إليه بوش». فما معنى إقامته إن لم يكن مضيعة للوقت؟!
وإذا رجعنا إلى بدايات محاولة استيلاء الصهاينة على المسجد الأقصى، سنجد أنها بدأت بالتدريج منذ مطلع القرن العشرين، بجلب الكراسي والمصابيح والستائر وتركها أمام حائط البراق لتكون سابقة تمكنهم من ادعاء ملكيتهم للحائط. وتنبه المسلمون آنذاك وبدأ النزاع المسلح بين الطرفين فى 19/2/1922، وكان رجال الانتداب البريطاني يأمرون الصهاينة برفع تلك المعدات، ويعاود الصهاينة الكرة، حتى الانفجار المعروف باسم «ثورة البراق». فأرسلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق عرفت باسم «لجنة شو» نسبة إلى رئيسها.
وقال التقرير: «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق فيه لكونه يؤلف جزءاً من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف؛ وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي».
وانتهت اللجنة الدولية من وضع التقرير في ديسمبر 1930، ونالت قراراتها موافقة الحكومة البريطانية وموافقة «عصبة الأمم» آنذاك. إلا أن السلطات الإسرائيلية قد استولت في عام 1967 على «حائط البراق» بعد أن هدمت حارة المغاربة ووضعت يدها على باب المغاربة، أحد أبواب الحرم الشريف.. وتواصلت عمليات الحفر والتخريب، في نفس الوقت الذي تم فيه تشييد المعبد بطريقة المباني المعدّة مسبقا، أي أن تركيبه لن يستغرق أياما معدودة.. وذلك يفسر أهمية جدار العار وحقيقة والغرض منه..
وعلى الرغم من كل ما تم من حفائر منذ استيلاء الصهاينة على أرض فلسطين وحتى يومنا هذا، فإن كل الوثائق الجديدة تؤكد «أن اليهود لم يعد من حقهم ادعاء أن أرض فلسطين ملكا لهم بزعم أنهم غزوها قديما بمساعدة الإله يهوه. حقا، لقد عاش عليها أجدادهم منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، لكنهم كانوا يتقاسمونها مع الكنعانيين الذين كانوا يمثلون الأغلبية آنذاك، وهم أجداد الفلسطينيين. وأيا كان الأمر فلا حق لليهود في هذه الأرض التي غابوا عنها طوال عشرين قرنا»!! والمتحدث هنا عالمان من كبار علماء الآثار اليهود هما إسرائيل فنكلشتاين ونيل سيلبرمان، في كتابهما المشترك: «كشف النقاب عن الكتاب المقدس».
أما أطماع الصهاينة التي لا تأخذ في الاعتبار أي حق ولا منطق، فإن كل ما يرمون إليه هو استعادة حقوقهم السليبة من القيادة الكنسية، استكمالا لمشوار الإذلال الذي فُرض عليها بدأ من مجمع الفاتيكان الثاني، وذلك: بهدم المسجد الأقصى وإقامة المعبد لإعادة السلطة الدينية اليهودية. وعند إذ يظهرون ما لديهم من مخطوطات قمران التي تثبت أن المسيحية الحالية لا مصداقية تاريخية لها، بعد أن تمكنوا من تلجيم المجتمع الدولي بورقة «المحرقة» وإضعاف المسلمين والعرب إلى ما تحت الإهانة والإذلال، بعد أن ورطوهم في تنفيذ الكثير من ذلك المخطط الانتقامي الرهيب.. ويا له من انتقام!
ولا أتناول هنا الهوس الديني أو معركة هرمجدّون وغيرها، لكنني أشير بوضوح إلى: أن عملية هدم المسجد الأقصى تمثل جزء لا يتجزأ من مخطط الصهاينة للانتقام من المؤسسة الفاتيكانية لكل ما جعلتهم يتجرعونه من ذل ومهانة وإبادة على مدى ألفى عام، وفى نفس الوقت استكمال عملية إذلالهم للمسلمين ومقدساتهم، فمن يقبل بالخيانة لا مكان ولا احترام له لدى من يدفعه إليها..
فبدلا من أن نقدم الأسمنت للصهاينة لبناء جدار العار، وبدلا من بيع الغاز المصري لهم وبأقل من ثمنه، وبدلا من توصيل مياه النيل بترعة السلام، وبدلا من فرض عمليات تطبيع ضد إرادة الشعوب، لترسيخ الوجود الصهيوني وتثبيته، وكلها فضائح تناولتها الصحافة المصرية وغيرها، لا يسعني إلا أن أذكّر بالكلمة التي ألقاها السيد الرئيس حسنى مبارك في المؤتمر الثامن الذي عقد في رحاب الأزهر في أكتوبر 1977، نائبا عن الرئيس أنور السادات، وجاء فيها:
«إن المسجد الأقصى الشريف ما زال في أيدي أعدائنا، وإن إخواننا أبناء فلسطين لم يستردوا حقوقهم المشروعة بعد، وهذا الموقف يحتم استمرار الجهاد حتى يستنفذ وطننا ومقدساتنا وحقوق إخواننا، وإن هذا واجب لا يستثنى منه أحد، وإننا لا نمل أن نذكر المسلمين ونذكر العالم كل يوم بعدالة قضيتنا»..
والآن، وقد تزايد التهديد والوعيد بهدم المسجد الأقصى طارة، أو بهدم الكعبة طارة أخرى، نحن على مشارف حافة الهاوية فعلا، ولم تعد المسألة بحاجة إلى تذكرة للمسلمين وللعالم أجمع بعدالة القضية الفلسطينية أو بحق المسلمين في المسجد الأقصى، وإنما نحن بحاجة إلى إعلان الجهاد الحقيقي، واتخاذ التدابير الفعلية لذلك، بعد أن تبين للكافة الأطماع الاستيطانية للكيان الصهيوني ولمن يساندونه في الغرب.. فالجهاد كما شرّعه الله عز وجل، بالمال وبالنفس دفاعا عن الحق، قد أصبح فرض على كل مسلم ومسلمة لإنقاذ ونصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين: المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. لذلك لا يسعني إلا مناشدة كافة المسؤولين في العالم الإسلامي والعربي، بمختلف مستوياتهم مسؤولياتهم، سرعة التحرك لإحلال الحق، فالحق أولى بأن يُتبع.
ذلك هو ما تبين لي من كل ما تجمّع من كتب ووثائق وأحداث، أقدمه لمن يمكنه التصرف، علّنا نفيق من غفلتنا وندافع عن ديننا وكياننا، لأن الغرب دائم التخلص من عملائه، وما أكثر النماذج عبر التاريخ! كلنا عابري سبيل، ولا يبقى إلا صالح الأعمال.
استودع الله دينكم.. وأماناتكم.. وخواتيم أعمالكم..
استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.