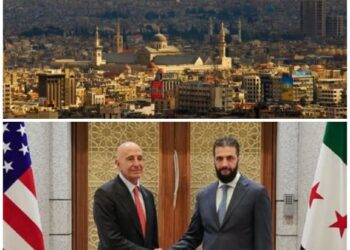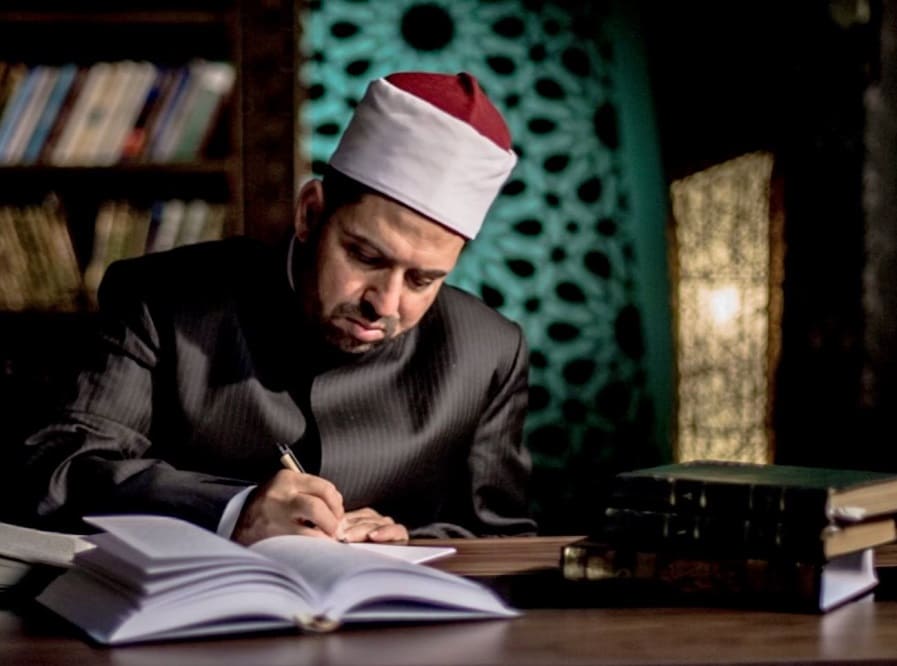في لحظة فارقة من تاريخ البشرية، وفي ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان، نزل صفوة الله من ملائكته (جبريل) على سيد ولد آدم (محمد بن عبد الله) بأول آيات من القرآن الحكيم: (اقرأ باسم ربك الذي خلق *خلق الإنسان من علق *اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم *علم الإنسان ما لم يعلم). [العلق: 1-5]، وقد كان نزول هذه الآيات إيذاناً بمولد نبوةٍ قضى الله أنه لا نبوة بعدها، ونشأةِ أمة حَكم العليم الخبير أنها خير أمة أخرجت للناس.
لكن دلالة هذه الآيات لا تقف عند هذا الحد، وإنما تتعداه ليستنبط منها أولو الأفهام والنُّهى ملامحَ منهج يجب أن تسير عليه تلك الأمة، حتى تتمكن من أداء رسالتها وحملها للعالمين.
1- فمن تلك الملامح أن الأمر بالقراءة فيه دعوة للعلم والتعلم، وبيان أن هذه الأمة لا تقوم لها قائمة إلا بالعلم، والمقصود بالعلم مفهومه الواسع، الذي يبدأ بالعلم بالله تعالى، وما يجب علينا نحوه وبما شرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتسع ليشمل كل علم نافع للخلائق في أمور دنياهم وأخراهم.
2- ولكن هذا الاتجاه العلمي الواسع مشروط بشرط يوجبه الإسلام ويحتمه -كما يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله في كتابه: (القرآن في شهر القرآن)- وهو أن يكون ذلك العلم: (باسم ربك)، وهنا يفترق العلم في صورته الإسلامية عن العلم في صورته الأوربية، بل تفترق الحضارة الإسلامية عن الحضارة الأوربية الحديثة وريثة الحضارتين الرومانية والإغريقية، بما فيهما من تقديس للعقل البشري من جهة، واتباع للشهوات من جهة أخرى. وذلك أن العلم بالنسبة لنا -معاشر المسلمين – يجب أن يكون (باسم الله) أي سعياً في سبيل الله وابتغاءً لمرضاته.
والعلم إذا انفصل عن القواعد الشرعية والضوابط الأخلاقية فإنه يصير نقمةً لا نعمة، ويُكلِّف البشريةَ من الخراب والدمار أضعاف ما تجنيه من ورائه من إنجازات، وواقع الحضارة الغربية اليوم شاهد على ذلك، وما أصدق قول حافظ إبراهيم رحمه الله متحدثاً عن الحرب العالمية الأولى -وهو ينطبق بلا شك على ما عداها من الحروب والمآسي العظام- وذلك حيث يقول:
لاهُمَّ إن الغربَ أَصبح شُعلةً * من هولها أُمُّ الصواعقِ تَفرَقُ
العلمُ يُذكي نارَها وَتُثيرها * مدنيةٌ خرقاءُ لا تَتَرَفقُ
ولقد حَسِبْتُ العلمَ فينا نعمةً * تأسو الضعيفَ ورحمةً تتدفقُ
فإذا بنعمتهِ بلاءٌ مُرهقٌ * وإذا برحمته قضاءٌ مُطبِقُ
3-ثم تأمل وصف الله تعالى نفسه بأنه: (الذي خلق)، فإن في ذلك إشارةً إلى أن هذا الخلاق العليم هو الذي يعلم ما يصلح لعباده من الأحكام والشرائع، كما قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14]، فإذا كان الخلق لله، فلا بد أن يكون له الأمر أيضاً، أي الشرائع والأحكام، كما قال تعالى: (ألا له الخلق والأمر) [الأعراف:54].
وما أجمل ذلك القياسَ الذي طالما استمعنا إليه من الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهو أننا نعلم أن من يخترع آلةً فإنه يضع لها ما يسمى ب(الكتالوج) الذي لا بد من الالتزام به، إذا أردنا تشغيل هذه الآلة بالصورة الصحيحة، فإذا كان ذلك شيئاً مقرراً لا اختلاف عليه بالنسبة لمن صنع جهازاً أو اخترع آلة، فكيف لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لمبدع الكائنات، وبارئ الأرض والسموات؟
إن من أكبر المصائب التي حلت ببلادنا أن كثيراً ممن يسمون أنفسهم بالنخبة، أو المثقفين، لا يفهمون من كلمة الدين إلا المفهوم الغربي الذي يجعل الدين مجرد علاقة بين الفرد وربه، أو أنه على أحسن تقدير مجموعة من المواعظ التي لا ينبني عليها تشريع ملزم، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، ولا غير ذلك من الأمور العامة.
وهذا المفهوم المنقوص لمصطلح الدين إن أمكنه أن يتعايش مع المفهوم الغربي القاضي بأن يُعطى ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، فإنه لا يمكن بحال أن يتعايش مع العقيدة الإسلامية القاضية بأن الإسلام نظام كامل شامل لكل جوانب الحياة؛ كما قال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين *لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين). [الأنعام: 162-163].
فالإسلام لا يعرف الفصل بين الأحكام التعبدية كأحكام الصلاة والزكاة والصيام ونحوها، والأحكام العامة في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها؛ لأن الذي قال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). [البقرة: 110] هو الذي قال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). [المائدة: 38]، والذي قال: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام). [البقرة: 183] هو الذي قال: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى). [البقرة: 178].
والعجيب أننا نجد في أقوال بعض من يتمسح بهم أولئك العلمانيون، ويعتبرونهم أساتذتهم فيما يسمونه بالتنوير، نجد دحضاً قوياً لهذا المفهوم الغريب للدين، وبياناً واضحاً لشمولية أحكام الإسلام.
وخذ مثالاً على ذلك هاتين الفقرتين من كتاب مرآة الإسلام للدكتور طه حسين -والذي يعد من أواخر كتبه -حيث يتحدث عن وجوب احتكام المسلمين إلى شريعة ربهم فيقول (ص: 234): (فكل ما يعرض للمسلمين من الأمر في حياتهم من المشكلات يجب عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله، يلتمسون له الحل في القرآن، فإن وجدوا هذا الحل فهو حسبهم، وإن لم يجدوا فعليهم أن يلتمسوه في سنة النبي، فيما صحت به الرواية عنه من قول أو عمل…
فإذا التمس حل المشكلات في القرآن فلم يوجد، والتمس في السنة فلم يوجد، فالمسلمون يرجعون إلى أصل ثالث من أصول الأحكام في الدين وهو إجماع أصحاب النبي..
فإن لم يجد المسلمون في القرآن ولا في السنة، ولا فيما أجمع عليه أصحاب النبي حلاً لبعض مشكلاتهم فعليهم أن يجتهدوا رأيهم، ناصحين لله ولرسوله وللمسلمين).
ولا شك أن الدكتور طه حسين كغيره من أهل الفكر والأدب يؤخذ من قوله ويُرَد، لكن مقصودنا بيان أن أولئك الذين يسمون أنفسهم بالتنويرين لا يلقون بالاً إلى هذا الكلام الواضح من الدكتور طه حسين في وجوب احتكام المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وإنما هم لا يزالون واقفين عند آرائه القديمة في مرحلة (في الشعر الجاهلي) و(مستقبل الثقافة في مصر)، والتي من الواضح أنه قد تجاوزها وتراجع عن أهم ما فيها، كما بين ذلك الدكتور محمد عمارة في كتابه (طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام)، مستدلاً بمثل هذا الذي نقلناه من كتاباته الأخيرة، وبأنه لم يُعِدْ طبعَ كتاب: (مستقبل الثقافة في مصر)، وأما كتاب الشعر الجاهلي فقد أعاد نشره بعنوان: (في الأدب الجاهلي) وحذف منه أهم المآخذ التي أخذت عليه.
ورغم ذلك لا تزال وزارة الثقافة المصرية تنشر كتاب (في الشعر الجاهلي)، بصورته التي تراجع عنها صاحبه. ولا يزال أولئك المتغربون واقفين عند الآراء القديمة لطه حسين، متجاهلين -كما يقول الدكتور محمد عمارة- (تطور فكر طه حسين حول علاقة الإسلام بالسياسة والدولة والقانون والتشريع، وهذا المنهج التغريبي لو تعامل مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لوقف بهم عند مرحلة عبادتهم الأصنام)! اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون.
د. عبد الآخر حماد – عضو رابطة علماء المسلمين
12/ 9/ 1446هـ- 12/ 3/ 2025م