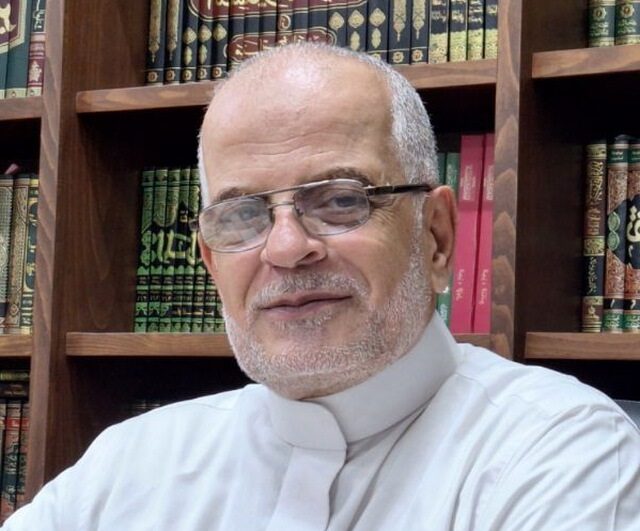صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ستُصالِحونَ الرُّومَ صلحًا آمِنًا؛ فتَغْزونَ أنتم وهُمْ عدُوًّا مِن ورائِكم؛ فتُنصَرون وتَغْنَمونَ وتَسْلمونَ، ثم ترجِعونَ حتَّى تَنزِلوا بمَرْجٍ ذي تُلولٍ، فيرفَعُ رجلٌ من أهلِ النصرانيَّةِ الصليبَ، فيقولُ: غلَبَ الصليبُ؛ فيغضبُ رجلٌ مِنَ المسلِمينَ فيدُقُّه؛ فعِندَ ذلك تَغْدِرُ الرُّومُ وتجمَعُ للملحمةِ).
[أخرجه أبو داود (4292) وابن ماجه (4089) وأحمد (16826) من حديث ذي مخمر أو ذي مخبر (رجل من أصحاب رسول الله)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند].
وقوله: (فيدُقُّه): أي يكسر المسلمُ الصليبَ، وفي رواية الإمام أحمد: (…فَيَقُومُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلَاحِمُ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْكُمْ فَيَأْتُونَكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً-أي راية- مَعَ كُلِّ غَايَةٍ عَشْرَةُ آلَافٍ).
وفي رواية عند أبي داود (4293) زيادة: (وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ).
وقد بينت في مقال سابقٍ أن هذا الحديث من أدلة مشروعية التعاون في القتال مع المخالفين، حتى لو كانوا من الكافرين، ما دام في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن حدوث ذلك في آخر الزمان مقراً له.
وأزيد اليوم أنه لا شك أن المسلمين وهم في حال تعاونهم مع الروم سيتمنون النصر لأولئك الروم، لأن انتصارَ الروم انتصارٌ لهم، كما أنهم سيحزنون لما قد يصيب الروم من مقاتلَ وإصابات. وإلا فبالله عليكم كيف يتصور عاقل أن المسلمين سيفرحون بما سيُحدثه العدو المشترَك من نكايةٍ وغلبةٍ في الروم، وهم معهم في نفس الخندق؟
أما إذا تغير الحال وثارت الحرب بين المسلمين والروم، كما جاء في تتمة الحديث فإن أهل الإسلام سيحرصون على قتال أولئك الروم وقتلهم والنيل منهم بكل وجه.
وما ذلك إلا أن مصلحة الإسلام في الحال الأولى كانت في بقاء أولئك الروم وانتصارهم، وأما في الحال الثانية فكانت في قتلهم والنكاية فيهم.
وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين في كل ما يشبه ذلك من المواقف.
لذا فإني لست مع مَن يظهرون الفرح والسرور بما أوقعه الصهاينة الملاعين في لبنان من قتل وتدمير، حتى لو طال ذلك بعضَ منْ آذوا أو قتلوا إخوةً لنا من أهل السنة؛ لأن العبرة بما نراه الآن من وقوف أولئك القوم في وجه الصهاينة ومساندتهم لإخواننا في فلسطين.
فحين تكون المعركة بين المسلمين واليهود، فإنَّ كل من يقف في خندقنا نفرح لنكايته في العدو، ونحزن لنكاية العدو فيه، وإنْ كنا نُبغضه لمعتقدٍ فاسدٍ عنده، أو لظلمه لإخواننا من أهل السنة والجماعة.
إذ لا شك أن ضعف جبهة أولئك المساندين، فيها إضعاف لموقف إخواننا في غزة والضفة، ويكفي ما رأيناه بعد تلك الضربات من انتشاء النتنياهو، وزهوه، وشعوره بالنصر، وزيادة شعبيته بين بني جلدته.
وأخيراً أذكِّر بنصين مهمين لشيخ الإسلام ابن تيمية لهما تعلق كبير بما نحن فيه:
أما أولهما:
فيتعلق بسؤال وُجِّه له رحمه الله عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟ فأجاب: (كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به؛ وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم؛ فإن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام.
والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافراً به؛ ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذَّب الرسول صلى الله عليه وسلم).
[مجموع الفتاوى 35/ 201].
وأما النقل الثاني
فهو يتعلق بموقف أهل الحق من مخالفيهم؛ حيث قال في معرض حثه على الإنصاف مع المخالفين، وعدم غمطِ ما عسى أن يكون معهم من الحق حتى لو كان قليلاً:
(.. لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حقٌ ما، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد الحق مع الباطل، حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض كما كان الأول مبطلاً في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة، وغيرهم).
[اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 151)،
وفي العبارة خلل صححته من شرح الطحاوية لابن أبي العز، انظر المنحة الإلهية تهذيب شرح الطحاوية ص: 333)].
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.