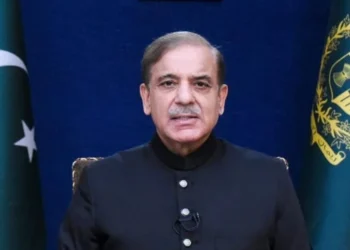ثمة مثل فرنسي يقول «كرسي المعارضة وثير»، فالمعارض يتمتع برفاهية النقد للسلطة السياسية لأن خطابه السياسي وقدراته القيادية لم توضع موضع الاختبار، لذا نجد خطاب المعارضة في كل دول العالم أقرب لخطاب «الآمال» منه لتحقيقها فعلا.. وبعد أن تصل المعارضة -إن وصلت- للسلطة تعود لاستخدام الذرائعية في تبرير القصور في انجاز ما وعدت به بحجج مثل قصر الفترة الزمنية أو عرقلة الآخرين أو الدسائس…الخ، وهي نفس أعذار الأنظمة القائمة.
فلو أخذنا حزب البعث في الوطن العربي، فقد وعدنا بالحرية والوحدة والاشتراكية، وعندما وصل للسلطة في بلدين عربيين هامين كانت النتيجة أن العداء بين جناحي الحزب كان أقسى من العداء مع خصومهما في خطابهما السياسي يوم أن كان الحزب في كرسي المعارضة..والناصريون وعدونا بالكثير وأنجزوا دونه، والشيوعيون كانوا أصحاب سلطة أو شبه سلطة في عراق عبد الكريم قاسم واليمن الجنوبي وبعض الفترات في التاريخ السوداني المعاصر وانتهوا لما نعرفه ونراه الآن.. وفي الجزائر شكلت العشرية السوداء شرخا في البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي حتى بين المعارضين..والثورة الفلسطينية كانت تسخر من قبول الدول العربية بقرار 242 ثم قبلت بأقل من ربع هذا القرار…. ولنتخيل لو بقيت هذه الأحزاب خارج السلطة لبقيت توهمنا بأنها «ستجلب الذئب من ذيله»، وتعدنا «بالمن والسلوى»،لأن كرسي المعارضة سهل، وهو ما اتضح بعد وصولهم للسلطة.
ذلك يعني أني لا آخذ أدبيات الحركات الدينية المعارضة مأخذ اليقين في الكثير مما تقوله، وقد لاحظنا أن الإخوان المسلمين خسروا معركتهم في مصر بعد شهور قليلة، ثم بدأ التذرع بان الواقع صعب والمؤامرات ضدهم كثيرة وخداع العسكر لهم كان اكبر مما اعتقدوا، وكأنهم كانوا يعتقدون أن استلام السلطة سيتم على طبق من ذهب، مما يعني أن أعذارهم في الفشل ليست إلا انكشافا لوهمهم بأنهم يدركون الواقع على حقيقته,وهو ما ثبت عكسه…
أما الليبراليون العرب، فلم يصل منهم للسلطة احد،وما زالوا «يحلمون» بثورة على غرار الثورة الفرنسية أو يحلمون بنسخ من فولتير ومونتيسكيو جان جاك روسو…ويواصلون الوعد من على كرسي المعارضة الوثير.
ماذا يعني ذلك؟
ذلك لا يعني أن المعارضة ليست ضرورية، أو أنها لم تنجز بعض الانجازات..بل هي ضرورية بمقدار ضرورات السلطة، لكن المقصود هنا أن يتواضعوا في أدبياتهم الحالمة، ولا يقدموا أنفسهم بأن مفاتيح الجنة بأيديهم، بل إن بعضهم يعدنا بهذه الجنة الأرضية منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن ونحن لا نرى إلا جحيما ولم ينجزوا وعدا واحدا…فإذا كان نصف قرارات الأنظمة فساد، فإن نصف وعود المعارضة أوهام…
أما الوجه الآخر للأزمة فيتبدى في نرجسية الفروق الصغيرة، إذ يميل الأفراد والجماعات الفرعية في مجتمع معين إلى تضخيم التباينات الصغيرة بينها بدافع «تأكيد الذات» والرغبة الدفينة في عدم التماهي، وعند نقل هذا السلوك إلى ميدان الفعل السياسي نجد أن كثيرا من التنظيمات أو الأفراد المتقاربين بشكل كبير في «استراتيجيات عملهم السياسي» ينفخون في فقاعات تبايناتهم الصغيرة لتصبح حاجزا كبيرا ومانعا يحول دون الوحدة بينهم، وتتضح هذه النزعة التي سماها فرويد وعلماء الانثروبولوجيا «نرجسية الفروق الصغيرة» في المجتمعات المتخلفة أكثر دون نفي وجودها ولو بحدة أقل في المجتمعات الأكثر عقلانية، ولتوضيح الفكرة سأمر على مثالين عربيين (رغم إمكانية التطبيق على مجتمعات غربية وغير غربية) أحدهما فردي والآخر جماعي:
1- النموذج الجماعي:
لو أخذنا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحاولنا تحديد المشترك لما يجمعهما، سنجد انهما على وفاق تام في جوهر نشاطاتهما: فهما ينتميان لنفس العقيدة بل ونفس الجذور الفكرية، ولهما هدف واحد(فلسطين) واتفاق تام على أدوات تحقيق الهدف (المقاومة المسلحة)، وتقتصر عضوية أفرادها على الفلسطينيين، بل إن تحالفاتهما الإقليمية والدولية من حيث الجوهر هي ذاتها، ومواقفهما من الجوانب الاجتماعية ذاتها، فلماذا لا تصبح الحركتان حركة واحدة؟ من الواضح ان الفروق الصغيرة(في الاجتهادات التكتيكية في معظمها والنزعات الفردية) تتنامى نرجسيتها إلى حد حجب الرؤيا عن «المشتركات الإستراتيجية الكبرى» لصالح جدار تبنيه «نرجسية الفروق الصغيرة» والنفخ فيها من قبل أفراد في القيادتين تتوارى في لاوعيهم ” نرجسيات” تأبى إلا أن تؤكد ذاتها.
2- النموذج الفردي:
صدام حسين وحافظ الأسد: ينتمي كلاهما لنفس الأمة (التي يعتز كل منهما بها)، ولنفس العرق ونفس اللغة(التي اعتبرت أساس القومية العربية) ولنفس الأيديولوجيا السياسية (الفكر القومي) ولنفس الحزب (حزب البعث) ولنفس الهدف(الوحدة العربية) ولنفس البيئة الجغرافية، بل ويشرب كل منهما من نفس النهر(الفرات)، ورغم كل هذه «المشتركات» الإستراتيجية كان العداء بينهما هو الأكثر وضوحا وقسوة في شبكة العلاقات العربية…ألا يدل ذلك على أن «نرجسية الفروق الصغيرة» فعلت فعلها في القطيعة بين الدولتين ومنع وحدتهما التي كانا ينشدانها في كل أدبياتهما السياسية…
يبدو لي ان سيطرة الفكر الغرائزي (نتيجة الجهل العام) توفر بيئة مواتية تماما لتنامي «نرجسية الفروق الصغيرة»، وأن علاجها لا يتم بثقافة الوعظ والإرشاد، بل ببنية عقلية متحررة تؤسس لبنيات اجتماعية واقتصادية وسياسية مبنية على أسس عقلانية عمادها أن الفروق الصغيرة قد تكون ميزة للتنوع الذي يعزز «المشتركات»، ويكفي النظر في المجتمع الإسرائيلي أو الأمريكي (الذي ينطوي كل منهما على فروق صغيرة وكبيرة لا حصر لها بين الأفراد والجماعات) لكنهم تمكنوا من «خلق» آليات كبح لرعونة “نرجسية الفروق الصغيرة” وتحويلها إلى معزز للمشتركات بغض النظر عن طبيعة النظامين..
ربما