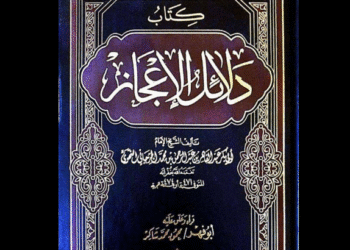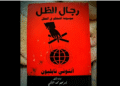«إن قراءة التاريخ واجب من الواجبات الدينية وركن من أركان اليقين يجب تحصيله!.»
لا أعتقد احتواء كتب الحكم والبلاغة على مقولة أكثر أهمية من هذه العبارة العبقرية للإمام المُصلح محمد عبده (١٨٤٩ – ١٩٠٥م).. وذلك لِما للتاريخ من أهمية بالغة في تقدم الأمم ونهوضها، بتحصيل الاستفادة منه في تجنب أخطاء السابقين. فإن السعيد من اتعظ بغيره والشقيّ من اتعظ بنفسه..
وقد فرّق الأستاذ أحمد بهاء الدين بين الإنسان والحيوان بمدى الاستفادة من درس التاريخ، في مقدمة كتابه «أيام لها تاريخ»..
وقد يرى البعض غير ذلك من أسباب الاختلاف مثل العقل أو اللغة أو حتى التدين!..
وهو ما لا اعتقده فروقا جوهرية، حيث يُشبَّه الإنسان العاقل الذكي بالثعلب، كما أن الحيوان يمتلك لغة وإن كنا لا نعلمها، وقد فهّمها الله عزّ وجل لسيدنا سليمان عليه السلام..
وكذلك الإيمان، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ الله وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، كما أنه يوجد كثير من البشر ملحدين لا إيمان لهم!..
ولذلك كان الفارق الجوهري بين الإنسان والحيوان (في اعتقادي) هو تدوين التجارب والمعارف والعلوم، التي تصير للأجيال التالية تاريخًا يُضاف إليه ويُرتقي به..
وهو ما نجد معناه في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: دأبت في قراءة علم التاريخ كذا وكذا سنة، وما قرأته إلا لأستعين به على الفقه!..
هذه المقدمة عن أهمية التاريخ لا علاقة لها بموضوعنا اليوم إلا من وجه واحد بالغ الأهمية وهو عدم تكرار الجدل حول الأمور التي قُتلت بحثا من قبل، مع الاستفادة من الأخطاء التي وقعت من جرّاء الخلاف فيها وحولها!..
ومن أبرز الأمثلة على هذا، ذلك الخلاف الكبير حول مصطلح «الديمقراطية» الذي رفضه وحاربه قطاع عريض في التيار الإسلامي وكتبوا عن مخالفته للشورى في الإسلام وتعارضه التام مع الشريعة الإسلامية!..
حتى جاء في «موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة»: «ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة، أوفي التشريع، إذ تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى، وحقه في التشريع المطلق، وتجعلها من حقوق المخلوقين!.».[١]..
والأخطر من ذلك ما صدر في منتدى للتيار السلفي في السعودية من فتوى للشيخ علي بن خضير الخضير، حين قال:
«البرلمانات أماكن شرك وكفر ومن يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، ويحب البرلمانيين المشرعين… ونحوهم، من أجل توجهاتهم وعقائدهم، فهذا كافر!..»[٢]..
وهو ما كان يصب بلا شك في المقام الأول لصالح حكام الجور والاستبداد المتحكمين في البلدان العربية وشعارهم السلطان إما في القصر والصدر وإما في القبر. فلا يوجد تداول للسلطة أو حتى مجرد محاسبة على فساد أو تقصير!.
ولذلك كانت تلك الدعوة في أولويات علماء السلطان وفقهاء الحكام، وتولى كبرها الممالك الوراثية وفي الصدر منها المملكة العربية السعودية، وللأسف تم دعم هذا الرأي عندما خاض مع هؤلاء بعضُ نفر من أهل العلم الإخلاص والثقة المشهود لهم في المشروع الإسلامي، متأثرين وقتها بهذا التشوه للمصطلح وعدم النظر في المصلحة العامة للبلاد والعباد!.
وكان من هؤلاء الأستاذ محمد قطب رحمه الله الذي كتب فصلا كاملا لنقض الديمقراطية في كتابه مذاهب فكرية معاصرة، والتشكيك فيها عندما تساءل: «هل الله هو المعبود في الديمقراطية وحده دون شريك؟!.. أم هناك عشرات من الآلهة الزائفة تُعبد مع الله أومن دون الله؟!.. وكلاهما سواء. فإن عُبِدَت مع الله فهو الشرك، وإن عُبدت من دون الله فهو الكفر. والشرك والكفر كلاهما كُفر!.»[٣].
وقد كان من المستغرب والعجيب أن يُدان المصطلح الذي تقدم به الغرب ومنح الناس حريتهم عند الدعوة لتطبيقه في بلاد المسلمين، وذلك لأن المصطلحات مثل المياه تتشكل في الإناء الذي يحتويها، ومثال ذلك مصطلح العلمانية الذي حمى أوروبا وأنقذها من تسلط الكنيسة بصكوك غفرانها وشعوذة رجالها على رقاب الناس، صار عندنا سيء السمعة لأنه يفصل الدين الإسلامي بشريعته الغرّاء عن الدولة وكافة شئون الحياة!..
وبذلك كان يجب النظر إلى أن الإسلام سوف يأخذ من الديمقراطية، كفالة حرية التعبير والدعوة إلى الله، ومحاسبة الحاكم وتداول السلطة وليس حرية الشذوذ والإباحية ومعاقرة المسكرات، التي تكفلها الأنظمة الاستبدادية دون مراعاة لدين أو أخلاق!..
وهذا هو المقصد من الشريعة الذي عبر عنه الإمام ابن القيم بقوله: «إذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر وجهه بأي شكل كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره».
وهوما فهمه بوعي كبير وعقل مستنير المفكر الإسلامي خالد محمد خالد (١٩٢٠ – ١٩٩٦م) ودعا إليه في كتابه «الدولة في الإسلام»، الذي يُعد من أعظم ما كتب في حياته، حيث تراجع فيه عمّا كتبه سنة ١٩٥٠م في كتابه «من هنا نبدأ» ودعوته العلمانية آنذاك بفصل الدين عن الدولة وشئون السياسة، فقال مصححا بعد ٣٠ سنة كاملة من دعوته تلك: «إن الإسلام الذي نحمل لواءه لم ينته ولن ينتهي دوره في ترشيد الحياة وهداية البشر، كما لن تنتهي حاجة البشرية إليه.
وعلينا أن نعمق إيماننا بأن الإسلام:
دين، ودولة..
حق، وقوة..
ثقافة، وحضارة..
عبادة، وسياسة..».[٤]..
ولكن ذلك لم يشفع له في ظل الجناية الكبرى التي جناها التيار السلفي النجدي (السعودي) من إدخال الأمة في جدال كبير حول المصطلحات!.
وهو ما وقع فيه الكاتب الموسوعي القدير أنور الجندي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عندما رفض تنصُّل المفكر الكبير خالد محمد خالد، من آرائه القديمة التي أعلنها في الخمسينيات من إنكار أن الإسلام دين ودولة، ورغم فرح الناس لهذه العودة إلى الله من الشيخ خالد، إلا أن الأستاذ الجندي أصر على وضعه في خانة عصبة العلمانية أعداء الشريعة الإسلامية، قائلا: «إن خالد محمد خالد قد اشتهر في نظر العصريين بأنه من دعاة (الديمقراطية).. وأنه يراها الحل الأمثل لحاضرنا ومستقبلنا، فكيف يمكن أن يكون من يقول هذا: مفكر إسلامي؟!.. وكيف تكون الديمقراطية الحديثة هي الشورى؟!».[٥]..
وإذا كانت القاعدة الأصولية التي يقر بها السلف والخلف تقول: «الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، فلا تحكمْ على شيءٍ إلا بعد أن تتصوره تصوُّرًا تامًّا؛ حتى يكون الحكمُ مطابقًا للواقع، وإلا حصل خللٌ كبيرٌ جدًّا»!.
فإن الأستاذ خالد قام بتحرير معنى الدعوة للديمقراطية – التي أخذها عليه الأستاذ الجندي– ووضعها في إطارها الإسلامي من المساواة بالشورى، بصورة واضحة جلية في قوله:
ربما يظن البعض أن «أبا بكر، وعمر» لم يكونا حاكمين ديمقراطيين لأنه لم يكن بجوارهما تلك المؤسسات الديمقراطية الحديثة من برلمان ودستور ومعارضة وصحافة حرة.
بيد أن وضع المسألة على هذا النحو يشكل خطأً كبيرًا..
فقد كان غياب هذه المؤسسات لا يعني أكثر من كونه تعبيرا عن نظم ذلك العصر البعيد في جزيرة العرب بل ومعظم بلاد العالم منذ ١٤٠٠ عام.
لقد حقق الخليفتان على أوسع مدى الجوهر الحيّ للديمقراطية من خلال إيمانهما العميق بكرامة الإنسان، ومن خلال الأشكال والتطبيقات التي كانت تلائم عصرهما.
فإذا كانت الدولة في عهدهما لم تشهد المعارضة البرلمانية لفقدان ذلك في بيئتهما، فإن المعارضة نفسها كانت تمارس بأسلوب فعال وعميق.
وكانت الشورى يومئذ شعيرة من شعائر الله، وحقًا مقدسًا للجماعة كلها.
وإذا كان التطور يومئذ لم يهيئ قيام صحافة حرة، فإن الكلمة الصادقة الشجاعة كانت على كل لسان، يصغى الخليفة إليها ويثيب عليها!.
ولوأن الخليفتين العظيمين يحكمان في عصرنا هذا لأعطيا التجربة الإنسانية في النظام الديمقراطي الرشيد كل احترامهما، ولانتفعا بها إلى أبعد مدى، ولأخذا من أشكالها الحديثة ما يحقق جوهرها ويعبر عن خصائصها.
صحيح أن ذلك لم يكن سيتم بصورة مطلقة، بل كان سيتم داخل إيمانهما المطلق بالدين الذي آمنوا به واتبعوه.. على أنه مع وجود هذا التحفظ لن ينقص ذلك من قدرهما كحاكمين ديمقراطيين!.
ذلك أن أي حاكم ديمقراطي إنما يعمل داخل حدود الدستور العادل القائم في دولته..
وأبو بكر وعمر كانا يعملان داخل حدود الدستور القائم في دولتهما..لقد كان للقرآن في أمتهم من الولاء والإجلال والهيمنة أكثر مما للدساتير في كل الدنيا.
ولقد تضمن القرآن العظيم مزيتين من أعظم مزايا الديموقراطية:
أولاهما – أنه جعل الشورى واجبا مفروضا في دولة الإسلام.
وثانيتهما – أنه لم يلزم بطاعة أحكامه واعتناق مبادئه إلا من يختاره ويقره ويؤمن به..
أما الآخرون الذين لم يؤمنوا به من أهل الكتاب، فلهم أن يعيشوا وفق عقائدهم داخل إطار الدولة..
صحيح أن القرآن «دستور» لم يضعه الشعب، ولكنه دستور رضيه الشعب وآمن به واقترع عليه واستشهد في سبيله.
وإذن فالمعيار الصحيح الذي يوزن به حكما الصديق والفاروق وديمقراطيتهما هومدى احترامهما لهذا القرآن.. لهذا الدستور، الذي آمن به المسلمون واختاروه قانونا ومنهجا لحياتهم.»[٦]..
فهل هذا الطرح الذي قدمه الأستاذ خالد محمد خالد يستحق الإنكار عليه ووضعه في خانة أعداء الشريعة الإسلامية؟!..
وقد رأينا في كل الانتخابات الديموقراطية النزيهة التي شهدتها الدول الإسلامية نجاح التيار الإسلامي وأحزابه بأغلبية واضحة كبيرة، وهوما ثبت بالتجربة في الجزائر سنة ١٩٩٠م، وتركيا منذ مطلع الألفية وحتى يومنا هذا. ومصر في كل الاستحقاقات منذ ثمانينيات القرن الماضي..
ولكن هذا التشوه حول المصطلح (الكفري)، جعل التيار السلفي في ظل الانفراجة الديموقراطية بعد ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١م، حريصًا على البحث عن مواد تطبيق الشريعة وضماناتها وإثارة الجدل الذي أضاع كثير من جهود التيار الإسلامي في طموحات طوباوية متعذر تحقيقها، بدلا من الانشغال بتوفير الحصانة للحريات بكافة أنواعها والحرص على نجاح التجربة والتكاتف من أجلها كطريق يكفل طريق الدعوة أكثر من أي طريق آخر سلكوه في ظل مهادنة الأنظمة المستبدة القمعية، حتى مع دعوتهم التي سدت سُبل التغيير أمام الشعوب بحجة تحريمها للانتخابات والديموقراطية وأنها لا توافق شرع الله الذي لم يُطبق منه سوى نصف الآية ال ٥٩ في سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ..}.. دون بقيتها التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}..
وهى الدعوة التي استخدموا فيها التدليس وإخفاء بعض الكتاب لترسيخ الحكم الوراثي الاستبدادي وهوما نجده في تلك الإجابة التي قالها الشيخ صالح الفوزان عضوهيئة كبار العلماء، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، عندما سُئِلَ هل الانتخابات طريقة صحيحة في اختيار ولي أمر المسلمين وتداول السلطة، وما النصيحة لمن ابتلوا بهذا في بلدانهم؟!.
حيث رد الشيخ قائلا: ليس من حق أي أحد أن يدخل في اختيار ولي الأمر من الغوغاء وعامة الرجال والنساء، وإنما ينتخب الحاكم العلماء والقادة ووجوه القوم فقط!.
وتثبُت البيعة أيضا بأن يعهد الحاكم من بعده إلى رجل أومجموعة مختارة محدودة ينتخبون من بينهم ولي الأمر مثلما فعل عمر بن الخطاب بوضع الأمر في الباقين من العشرة المبشرين بالجنة والذين اختاروا من بينهم عثمان بن عفان فلزمت بيعته على جميع الأمة، ولم يحصل انتخابات وهذا يكفي في الإسلام!.
فهذه طرق البيعة ومنها أيضا إذا تغلّب مسلم بالسيف على بلد فخضع له أهلها فإنه يصبح إماما!.
أما انتخابات يقوم بها الرجال والنساء فهذا ليس من هدي الإسلام!..[٧]..
والنقطة الهامة هنا التي أغفلها الشيخ لأنها تجرح بالأساس الحكم في الممالك الوراثية، عندما لم يذكر أن عمر بن الخطاب أخرج واحد من السبعة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وهو «سعيد بن زيد» على الرغم من جلال قدره وسابقته في الإسلام لأنه ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وقد ترك عمر شروطا وقواعد لأعضاء مجلس الشورى الانتخابي الستة الباقين، كان من بينها أن يتعهد الخليفة المنتخب ألا يعامل أهله معاملة خاصة متميزة!. [٨]..
كما أغفل الشيخ الفوزان (ولا أحسبه عن جهل) الإشارة إلى أعظم عملية انتخابية ديمقراطية في العصر القديم عندما بقي عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – يشاور الناس رجالا ونساء ومن يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة لمدة ثلاثة أيام لدرجة أنه شاور حتى العذارى في خدورهن!.»[٩]..
وهى الرواية التي رواها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال بعضهم بضعفها ولكن صححها واحتج بها الإمام ابن تيمية في إثبات شرعية بيعة عثمان بن عفان عند الرد على الشيعة الروافض!.[١٠]..
كما نرى تأكيدها في تاريخ الإسلام للذهبي، حين ذكر خطبة عبد الرحمن بن عوف التي قال فيها:
«أيها الناس إني قد سألتكم سرًّا وجهرًا على أمانتكم فلم أجدكم تعدلون عن أحد هذين الرجلين: إما علىّ وإما عثمان..»[١١]..
وأيضا عند الإمام البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه: «.. أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان..»[١٢]..
وفي النهاية قبل الختام أود أن أعرض هذا التعريف الذي ربما يكون الأدق لمبدأ الشورى -قبل أن تغشاه الغواشي الاصطلاحية والفقهية- وهو ما قاله ابن خلدون عن حكام بني إسرائيل بعد يوشع، حيث وصفهم بأنهم «كان أمرهم شورى، فيختارون للحكم في عامتهم من شاؤوا..ولهم الخيار على من يلي شيئا من أمرهم».
وقد تضمن هذا الوصف أن يختار القوم ابتداءً من يحكمهم بكل حرية، وأن يكون هذا الاختيار من عامة الناس دون احتكار له من فئة أو طبقة اجتماعية بعينها، ثم يكون لمن اختاروا الحاكم الحق في مراقبته وعزله إن عجز أو خان!. [١٣]..
وفي اعتقادي الشخصي أن الفقر الفكري عند معظم أبناء التيار الإسلامي المخلصين وخاصة أبناء الدعوة السلفية وعدم تزكية الكتب الفكرية الإسلامية للقراءة بجانب العلوم الشرعية هي التي وصلت بنا إلى تلك الحالة، وقد منّ الله علينا بكتب وافية شارحة لكل ما التبس من قضايا في العصر الحديث وأذكر في قضية الديمقراطية تلك، كتابا قديما هاما للأستاذ فهمي هويدي في مطلع التسعينات تحت عنوان «الإسلام والديمقراطية»، وحديثا درة من درر الباحث محمد بن المختار الشنقيطي تحت عنوان «الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية».. وغيرهما العديد من الكتب التي يجب أن تصب في أن الشورى والديمقراطية وجهان لعملة واحدة يقفان على صعيد واحد في مواجهة الاستبداد..
هوامش المقال:
[1] الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، د/ مانع الجهني، ج٢، ص١٠٥٦، دار الندوة العالمية، الرياض الطبعة الرابعة ١٤٢٠ه.
[2] ٢٠٠ سؤال وجواب للشيخ علي بن خضير بن فهد الخضير، لقاء منتدى السلفيون، ص٦٧..
[3] مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ص٢٢٩، دار الشروق الطبعة الثالثة ١٩٨٨م.
[4] الدولة في الإسلام، خالد محمد خالد، ص١٠٤، دار ثابت، طبعة أولى.. يناير ١٩٨١م..
[5] كتاب إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام، أنور الجندي، ص٢٧٧، طبعة دار الاِعتصام سنة ١٩٨٥م..
[6] الدولة في الإسلام، خالد محمد خالد، ص٥٤-٥٧، دار ثابت، طبعة أولى.. يناير ١٩٨١م..
[7] الخلافة والملك، المودودي، ص٤٨، نقلا عن فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج٧، ص٤٩، الرياض النضرة ج٢، ص٧٦.
[8] البداية والنهاية، ابن كثير، ج١٠، ص٢١١
[9] منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٦، ص٣٥٠
[10] تاريخ الإسلام، الحافظ الذهبي، ج٣، ص٣٠٥..
[11] البخاري، من حديث المسور بن مخرمة (ح: ٧٢٠٧)، نقلا عن صحيح وضعيف الطبري، ج٣، ص٣٠٤..دار ابن كثير دمشق، طبعة ٢٠٠٧م، تحقيق البرزنجي
[12] الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، محمد المختار الشنقيطي، ص١٦٦، نقلا عن ابن خلدون، كتاب العبر ج٢، ص١٠١.