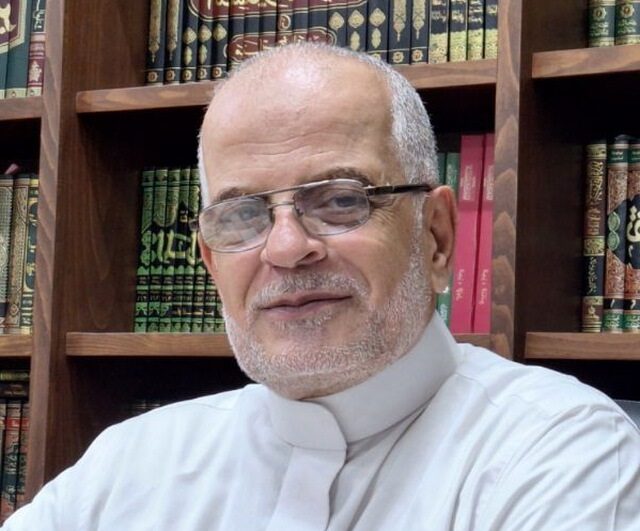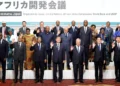عندما شرعت في كتابة هذه السلسلة من المقالات قبل شهرين تقريبا، للحديث عن أخطاء ثورة 25 يناير 2011، كنت أعي مقدما أن ما سأكتبه سيواجه بالكثير من التحفظات، والانتقادات، وربما الاستنكار، ذلك ليقيني في أن رؤيتي للثورة، وتحليلي للأحداث التي تسببت في فشلها، ولمواقف القوى السياسية فيها، سيتصادم مع قناعات الكثيرين ممن يقصرون أسباب الفشل، على الظروف الخارجة عن الإرادة، مثل الانقلاب العسكري، وخيانة بعض النخب السياسية، ومؤامرات الدولة العميقة..
وأنا وإن كنت أرى أن انقلاب العسكر على الثورة كان كفيلا بأن ينسف أي مبررات أخرى أدت إلى فشلها، إلا أن هذا لا يعفي القوى السياسية من ارتكاب العديد من الأخطاء التي كانت أقرب إلى الجرائم السياسية منها إلى الأخطاء، لأن هذه الأخطاء هي التي سهلت مهمة العسكر في تنفيذ الانقلاب..
كان من الممكن التجاوز عن كل هذه الأخطاء، لو أن الانقلاب وقع في اليوم الأول للثورة ووأدها في مهدها، أو تمكن من إبطال مفعولها قبل انفجارها الحقيقي بعد ثلاثة أيام من خروجها وبالتحديد يوم جمعة الغضب بالثامن والعشرين من يناير، بيد أن الثورة مضت في طريقها، والانقلاب عليها لم يتم إلا بعد سنتين وبضعة أشهر -29 شهرا كاملة- بما يعني أن من قاموا بالانقلاب كانوا مترددين، أو قل خائفين من الثورة وثوارها، وكانوا يتحسسون طريقهم قبل الإقدام على هذه الخطوة، إلا أن رعونة القوى السياسية وأخطائهم الجسيمة في إدارة الثورة، هي التي جرأت العسكر، وأزالت عنهم الخوف ومكنتهم من تحقيق المراد، وإن ظل الخوف يطاردهم طوال الوقت، وقد ظهر هذا على الكثير من تصرفاتهم وقراراته.. ولعل خوفهم هذا هو ما جعلهم يطهون انقلابهم على نار هادئة، خوفا من أن تفسد الطبخة، وقد صبروا على عملية الطهي إلى أن اكتمل الإنضاج بعد سنتين وبضعة شهور، في الثلاثين من يونيو 2013، وتم الإعلان عنه رسميا بعد 72 ساعة في الثالث من يوليو..
وفي مقال اليوم الذي سنكشف فيه كالعادة أخطاء القوى السياسية، سنتناول بشيء من التفصيل الطرق الجهنمية التي استخدمها العسكر لتنفيذ مخطط الانقلاب، ولمراحل التحضير والطهي التي احتاجتها عملية تجهيز وجبتهم المسممة التي أكلت منها القوى السياسية، ما أدى إلى اغتيالها، بعد قتل ثورتهم!!
الانقلاب بدأ يوم التنحي!
كما أشرنا بأكثر من مقال سابق، إلى أن الثورات فعل مفاجئ يستحيل توقعه أو التنبؤ به، شأنها شأن الزلازل والبراكين، ومن ثم فهي تأتي مباغتة للجميع -الشعب والسلطة والسياسيين- وبالتالي فهي تغافل الأنظمة الحاكمة عند وقوعها، تلك الأنظمة التي غالبا ما يكون طول بقائها في الحكم أوهمها بالخلود في السلطة والثقة في عدم وجود طارئ يسلُبها سلطتها، وأن قبضتها الأمنية، وأدواتها القمعية، وتجريفها للحياة السياسية، يكفي لأن يجعلها تنام قريرة العين، غير عابئة بأنين الناس من الظلم الواقع عليهم، ولا تذمرهم المكتوم، إلى أن ينفجر الشعب مرة واحدة، ويفاجئهم بالثورة..
والوضع في الثورة المصرية كان كذلك، حيث أن السلطة لم تكن أبدا متوقعة لما حدث في 25 يناير، ومن يقول بإن الثورة خرجت في هذا اليوم بتخطيط من الجيش لإفساد مشروع مبارك بتوريث الحكم لابنه جمال، فهو واهم، أو مهزوم أمام ما يصدّره له الإعلام، أو أمام الرواية المخابراتية التي ترددت في تلك الفترة، وكان هدفها إشعار الشعب بوهم الثورة، وفي نفس الوقت التأكيد على قوة ويقظة الجيش وأنه لا يحدث شيء في البلد إلا بعلمه، وبتخطيط منه، ولو أن هذه الرواية كانت حقيقية، لما نزل الجيش إلى الشارع ليحمي الشرطة من الثوار كما حدث في جمعة الغضب، ولما أطلق الجيش رصاصة واحدة على الثوار، ولما انقلب على الثورة لا حقا، هذا فضلا عن أن هذه الرواية تتنافى مع ما حدث في أربع دول عربية أخرى شهدت في نفس الفترة ثورات ضد أنظمتها أيضا هي تونس وليبيا وسوريا واليمن، وجميعها أطاحت برأس النظام إلا دولة واحدة هي سوريا، لأنه ومن اللحظة الأولى قرر جيشها إبادة الشعب بالأسلحة غير المشروعة، فهل كانت جيوش كل هذه الدول هي من خططت للثورات؟!
والذي لا شك فيه أن فجائية الثورة في مصر هي التي أربكت المؤسسة العسكرية في البداية، وأصابتها بالشلل المؤقت، وقد ظهر هذا الارتباك من تصرفاتها المترددة في التعامل مع الثوار، مرة بمواجهتهم بالأسلحة النارية، وأخرى بتأييدهم وتقديم التحية لهم، والفجائية أيضا هي التي جعلتها تصبر على الثورة والثوار الـ18 يوما الأولى قبل إعلان تنحي مبارك عن الحكم، وهي فترة كانت كافية للبحث والدراسة، والتفاهم مع الشركاء الدوليين والإقليميين لوضع السيناريو المناسب للتعامل مع الثورة والذي كان بطبيعة الحال هو الانقلاب عليها، وهو ما وقر في قلوبهم من اللحظة الأولى..
من هنا يمكنني الجزم، بأن مخطط الانقلاب على الثورة بدأ يوم إعلان مبارك التنحي عن الحكم وانتقال السلطة إلى المجلس العسكري، كما أستطيع الجزم أيضا بأن المجلس العسكري لم يضع مخطط الانقلاب منفردا، إنما شارك في إعداده الحلفاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كنا قد أكدنا من قبل أنها لم تكن مرحبة بالثورة، حتى وإن أظهرت عكس ذلك، فنجاح ثورة يناير كان سيمثل تهديدا كبيرا لمصالحها بمصر والشرق الأوسط، فضلا عن خطورة الثورة على الوجود الإسرائيلي بفلسطين، ذلك الوجود الذي ترعاه وتحميه وتموله أمريكا، وقد ظهر دور أمريكا في خطة الانقلاب بحرص مسؤوليها على الإيحاء للثوار والسياسيين بأنهم يؤيدون ثورتهم ويدعمونها، والدليل هو أن الرئيس الأمريكي وقتها «بارك أوباما» هو وبنفسه الذي طالب مبارك بالاستجابة لنداء الثوار بترك الحكم حالا، وقيل وقتها إن أوباما حذر مبارك من التأخير في الرحيل، موجها له جملته الشهيرة (الآن يعني الآن Now Means Now) ولم يكن هذا الموقف سوى عملية خداع للثوار تكشفت لاحقا، بدليل أن أمريكا التي أيدت الثورة في البداية وأمرت مبارك بالتنحي، هي التي باركت الانقلاب عليها في النهاية، وهي أيضا التي غضت الطرف وعملت من بنها، وهي تشاهد وتتابع المجازر البشرية التي ارتكبها العسكر في رابعة وأخواتها لفرض انقلابه، ولو أن أمريكا كانت مع الثورة فعلا كما تقول، لكانت تصدت للانقلاب ولما أيدته، أو على أقل تقدير كانت طبقت قانونها الذي يحظر عليها التعامل مع سلطة انقلبت على حاكمها الشرعي، وأمريكا نفسها هي التي كانت قد عرّفت ما جرى مع الرئيس محمد مرسي في 2013 بأنه انقلاب عسكري!!
إذن الإطاحة بمبارك كانت أول المراحل المهمة في خطة الانقلاب، أو يمكن القول إنها المرحلة الأهم والأكبر في الخطة، لأنها هي التي مهدت الطريق أمام بقية المراحل، حتى المحاكمة التي جرت مع مبارك لاحقا، كانت جزءا من الخطة، لأنه وكما ذكرنا في مقال سابق، أن العسكر لم يقدم مبارك للمحاكمة إلا بعد مرور 78 يوما من اندلاع الثورة، وهي فترة كانت كافية جدا، لأن يقوم مبارك بتستيف أوراقه، وتوفيق أوضاعه، وتهريب بقية أمواله، أضف إلى ذلك أن الذي أحال مبارك للمحاكمة هو النائب العام عبد المجيد محمود، وهو المعين لهذا المنصب من قبل مبارك نفسه، وهذا وحده كان كفيلا بأن يجعل المحاكمة برمتها أقرب إلى المهزلة، ولذلك لم يكن غريبا أن تتم إحالة مبارك للمحاكمة في القضايا التي اتهم فيها، بلا أي أدلة اتهام حقيقية يمكن أن تستند إليها المحكمة، هذا بفرض أن المحكمة كانت ستراعي ضميرها وعدلها في التحقيقات، ولذا لم يكن غريبا أن يحصل مبارك على أحكام بالبراءة في كل القضايا التي رٌفعت ضده، فيما كان الأهم في تلك المهزلة هو أن أغلب التهم التي وجُهت لمبارك، تعلقت بجرائم تربح واستيلاء على المال العام، وكأن مبارك كان محاسبا بشركة، كل تهمته أنه أختلس أموال تلك الشركة، وليس بصفته رئيسا لدولة تعدادها يفوق المائة مليون نسمة، ظل يحكمها لثلاثة عقود، أفسد كل شيء فيها، وأهلك فيها الحرث والنسل، ومن ثم كان الواجب أن يحاكم على جرائمه السياسية في حق الشعب والدولة، قبل أن يحاكم على جرائم تربح، فتكون محاسبته مثل محاسبة محصل كهرباء استولى على حصيلة اليوم!!
الوقيعة بين القوى السياسية
بعد نجاح المرحلة الأولى من خطة الانقلاب بتنحي مبارك، وانطلاء المخطط على الثوار والقوى السياسية، الذين فرحوا وهللوا بهذا الإنجاز، وراحوا يتركون الميدان، ويتوقفون عن اكمال بقية المسار الثوري، بدأت تتدافع بقية مراحل المخطط كالعقد المنفرط، حيث لم يمض على تنحي مبارك أقل من 48 ساعة، حتى كان المجلس العسكري جاهز بالمرحلة الثانية من المخطط، وهي المرحلة التي كانت تهدف إلى تفتيت القوى السياسية وبعثرتها، عن طريق إحداث الوقيعة بينهم، بإدخالهم في منافسة سياسية مبكرة، لم يكن قد آن أوانها، ففي اليوم الثالث عشر من فبراير، أي بعد يومين فقط من تنحي مبارك، أصدر المجلس العسكري بيانا مهما، كان أقرب إلى الفخ الذي استدرج إليه جميع القوى السياسية، ذلك البيان الذي حدد فيه العسكر خارطة طريق الثورة التي يفترض أن تؤدي إلى تسليم مقاليد الحكم للسلطة الجديدة التي سيختارها الشعب، وهي الخارطة التي كان يجب أن يضعها الثوار والقوى السياسية وليس أحد غيرهم، تبدأ تلك الخارطة بالدعوة إلى استفتاء شعبي يجري يوم 19 مارس، كان أحد أهم بنوده هو التصويت على ما إذا كانت الانتخابات تجرى أولا أم إصدار دستور جديد للبلاد أولا، وهو البند الذي انقسمت عنده القوى السياسية بين داعم للانتخابات أولا، وأخر يريد الدستور أولا، وقد كان المجلس العسكري ذكيا للغاية وهو ينصب هذا الفخ للقوى السياسية، فقد أدرك أن هناك قوى سياسية يهمها إجراء الانتخابات سريعا لثقتها في الفوز بها، وهي القوى الإسلامية (الإخوان تحديدا) وأخرى لا تريد الانتخابات لعدم ثقتها في الفوز وتريد إطالة الأمد الثوري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وهذه هي بقية القوى الأخرى الليبرالية واليسارية، فقرر التلاعب بالفريقين، وبالفعل نجحت خطته وحدث الخلاف الذي كان ينشده، بتفكك القوى السياسية، والتي ظلت على تفككها إلى أخر يوم في الثورة!!
تجييش الإعلام ضد الثورة
إحداث الوقيعة بين القوى السياسية لم يكن كافيا للحد الذي يجعل المجلس العسكري والثورة المضادة يركنون إليه لإجهاض الثورة، صحيح هو إنجاز كبير ومهم، له ما بعده في مخطط الانقلاب، إلا أنه كان غير كاف للتخلص من تلك القوى، خاصة وأن من بين هذه القوى قوة كبيرة تمثل الغالبية العظمى من الثوار والجماهير، هي قوة جماعة الإخوان المسلمين، وهي قوة قادرة على إكمال المسار الثوري وحدها، ويعلم العسكر أن التصدي لتلك القوة وتفتيتها ليس بالسهولة التي يمكن أن يفتت بها أي قوة سياسية أخرى، حيث أن جماعة الإخوان كتلة صلبة، شديدة التماسك، وقرارتها مركزية، الجميع ينصاع إليها دون جدل أو نقاش، فضلا عن خبراتها السياسية، وانتشارها الواسع في داخل وخارج مصر، كما أن المؤشرات أظهرت للعسكر مبكرا بأن الإخوان مرشحون للفوز بكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبالتالي هم في طريقهم لتولي مقاليد حكم الدولة المصرية، لذا لابد من إيجاد أسلحة أخرى غير سلاح الوقيعة بينها وبين القوى الأخرى، تكون أكثر فعالية لضرب الجماعة وقصم ظهرها، ومن ثم تعجيزها عن الوصول لأهدافها..
هنا بدأ التفكير في سلاح الإعلام بل والتخطيط على الفور في إنشاء منظومة إعلامية ضخمة تتولى القيام بهذه المهمة، تلك المنظومة التي ستصبح في غضون أيام قليلة أشبه بمنصة صواريخ، دورها الأول والرئيس هو دك قواعد الإخوان وتحطيم كل أهدافهم، وقد بدأ تجهيز هذا السلاح في توقيت كان فيه الإخوان والقوى السياسية مشغولون بتنابزهم وتصارعهم، والسعي لجمع غنائم الثورة، وهو ما سهل كثيرا من مهمة الإعلام في أداء رسالته واستقطاب خصوم الإخوان وضمهم لصفه، وقتها ظهر ولأول اسم شخص يدعى محمد الأمين، لم يكن له أي ذكر من قبل ثورة يناير، لكنه هو الذي وقع عليه الاختيار ليكون في الواجهة عند تأسيس المنظومة الإعلامية الجديدة صاحبة المهمة المحددة، وقيل عنه أنه كان يعمل محاسبا بدولة الكويت، وفي رواية أخرى رجل أعمال، إلا أنه وفي كل الأحوال بدا وكأنه أغنى رجل على وجه الأرض ظهر على السطح فجأة، وقد ظهر مدى ثرائه، من طريقة تأسيسه لمنظومته الإعلامية، حيث راح يشتري كل القنوات الفضائية الموجودة في السوق، بما في ذلك قنوات رياضية كانت قد توقفت مثل قناة «مودرن سبورت» المملوكة للواء نبيل دعبس صاحب جامعة مودرن أكاديمي بالمعادي، وكانت عمليات الشراء تتم في سرعة مريبة، ولذلك أُطلِق على الأمين وقتها لقب إمبراطور الإعلام، ورغم ترديد اسم الأمين بكثافة في ذلك الوقت والتأكيد على أنه صاحب مشروع إعلامي ضخم سيفيد البلد، إلا أن كثيرين كانوا يدركون وجود جهات كبرى تقف وراءه وتموله، لأنه لا يوجد عاقل على وجه الأرض مهما كان حجم ثروته أن يقوم بشراء هذا الكم من القنوات الفضائية في هذا الزمن القصير، إلا إذا كان لديه مخطط ما ينوي تنفيذه، أو أنه يعمل في غسيل الأموال، فإمكاناته المادية بدت تفوق أكبر تجار السلاح والمخدرات في العالم، بل تفوق قدرة الكثير من مؤسسات الدولة المصرية، لذا قيل إن من يقف وراءه دولة غنية لها مصلحة من هذه العملية، يبصم الناس على أنها الإمارات، وقد اشترى الأمين وقتها كل الفضائيات المصرية الخاصة تقريبا، حتى أن إمبراطوريته الإعلامية التي أسسها في أيام معدودة، ضمت 14 قناة فضائية وثلاث صحف، إضافة إلى شركة فور ميديا للإعلان، هذا غير شبكة الأخبار العربية التي تمتلكها عائلة الخرافي الكويتية، والتي كان يديرها الصحفي المصري حامد عز الدين، ولو كانت هناك وسائل إعلام أخرى مستعدة للبيع لاشتراها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إنما وصل للتعاقد مع كل الإعلاميين المصريين تقريبا، مقابل رواتب خيالية، يصل راتب الإعلامي الواحد فيها إلى عدة ملايين من الجنيهات شهريا، بل يقال إنهم كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار، بما يعزز وجود طرف أجنبي في الموضوع، وبما يؤكد أن الهدف هو شراء ولاء هؤلاء الإعلاميين، وضمان تنفيذهم لأي مهام تطلب منهم، والتي عرفنا لاحقا أنها شيطنة الإخوان، وإجهاض الثورة، وقد كان!!
برلمان في الهواء
كل هذا كان يجري تحت سمع وبصر القوى السياسية، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان بعض رجالها يدركون أن ما يجري هدفه التصدي لهم، وإيقاف طموحهم نحو الوصول للسلطة، إلا أن الجماعة كانت تقابل ذلك بعدم اكتراث، أو حتى رد فعل دفاعي، ربما لقلة الحيلة، أو لحسن ظنهم بالعسكر، أو ربما لانشغالهم ببريق السلطة الذي بدا يلمع في أعينهم، ذلك البريق الذي جعلهم يتجاوزون عن الكثير من مكائد وألاعيب العسكر، بل جعلهم يستسلمون للوقوع في الفخاخ التي نُصبت لهم، على أمل الاستمرار والاحتفاظ بالسلطة وبريقها!!
وكان أكبر وأخطر الفخاخ التي استسلم لها الإخوان، هو قبولهم بخوض انتخابات مجلس الشعب، دون وجود حكومة ممثلة للثورة، فالانتخابات التي أجريت في نهاية 2011 واكتسحها الإخوان، كانت الحكومة الموجودة وقتها، هي حكومة فلول يرأسها الدكتور كمال الجنزوري الذي خدم في دولة مبارك 13 سنة بواقع تسع سنوات كوزير للتخطيط وأربع رئيسا للوزراء، وهي حكومة اختارها المجلس العسكري على عينه، وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الاختلال السياسي لمنظومة الدولة، حيث البرلمان يمثل الثورة، والحكومة تمثل الثورة المضادة، والبرلمان يتطلع لتحقيق مطالب وأهداف الثورة، والحكومة تعمل على إفشالها، وقد نتج عن ذلك التضاد أن وقعت العديد من الصدامات بين البرلمان والحكومة، انتهت بالطبع بانتصار الحكومة المدعومة من العسكر والدولة العميقة والإعلام، حيث تم حل مجلس الشعب بعد أربعة أشهر فقط من انتخابه..
ولا شك أن الحالة المختلة هذه التي سيق إليها الإخوان سوقا، هي التي جعلت البرلمان الأول في تاريخ مصر، والقادم بعد ثورة كبرى، وبإرادة شعبية حقيقية، بلا أي سلطات أو صلاحيات، خاصة بعدما ظهر عجزه عن محاسبة الحكومة على أخطاء تحدث، فقد كانت الحكومة كانت ترفض الرد على أي استفسارات من الأعضاء، بل إن رئيس الحكومة نفسه كان يعلن تحديه لقرارات المجلس، والتي منها رفضه الاستجابة لطلب النواب بالحضور للبرلمان لمناقشة الميزانية، حتى التشريعات التي كان البرلمان يصدرها، كانت المؤسسة القضائية ترفض مناقشتها أو اعتمادها، الأمر الذي أساء كثيرا لسلطة وهيبة مجلس الشعب، وبلغت الإساءة للبرلمان مداها بعد المجزرة البشرية التي وقعت في استاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من مشجعي النادي الأهلي، حيث لم يستجب أحد من المسؤولين لطلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء البرلمان، حتى أن النائب العام نفسه رفض التعاون مع البرلمان، بالاستجابة لطلبه بسرعة التحقيق في المذبحة وتقديم نتيجة التحقيقات وتحويل الجناة إلى المحكمة، وكلها مواقف جعلت أعضاء البرلمان يبدون كمن ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء!!
خديعة الرئيس محمد مرسي
المجلس العسكري كان يدرك جيدا حجم المخاطرة الكبيرة التي خاضها بحل مجلس الشعب، تلك المؤسسة التي كانت تمثل وقتها الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة المصرية، لكن ولأن كل شيء كان مدروسا ومخططا له بعناية فائقة، فإن اختيار المجلس العسكري لتوقيت الحل في الرابع عشر من يونيو 2012، كان اختيارا مثاليا حيث جاء وقت انشغال الشعب والإخوان بانتخابات رئاسة الجمهورية، بل جاء وسط آمال عريضة كانت تحدو جماعة الإخوان المسلمين بأن رئيس مصر القادم سيكون منهم، حيث كانت المؤشرات تشير لفوز محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق، وساعتها قد يرى الإخوان أنه لا مشكلة من خسارة البرلمان طالما أنهم سيأخذون الرئاسة..
وبالفعل ومن هذا المنطلق تقبل الإخوان قرار حل البرلمان بروح رياضية عالية، لكنهم لم يدركوا خطورة هذا التفريط، فهم بذلك سيتركون ممثلهم الذي سيجلس على كرسي الرئاسة في العراء تتخطفه الشياطين دون أي مؤسسات شرعية تحيط به وتحصنه وتدعم قراراته ومواقفه، وهو ما كان يسعى إليه المجلس العسكري والدولة العميقة الذين كانوا يخططون لأن يكون مرسي وحيدا في السلطة يسهل الانفراد به، والإجهاز عليه في اللحظة المناسبة..
وإذا كان البعض يرى أن مرسي استطاع منفردا أن يواجه المجلس العسكري ويعزل عددا كبيرا من قياداته، على رأسهم المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان، إضافة إلى عدد أخر من القيادات العسكرية، وهو ما قوبل بسعادة كبيرة من عموم المصريين، إلا أني رأيت هذه القرارات هي إحدى حيل المخطط الذي وضعه العسكر وأنصار الثورة المضادة للخلاص من مرسي مستقبلا، والحيلة كما رأيتها وأخبرت بها كثيرين من الأصدقاء وقت حدوثها، كانت تقضي بزرع عميل داخل نظام مرسي، ذلك العميل الذي سيتولى لاحقا مهمة الانقلاب عليه، وكان هذا العميل الذي استقر العسكر على تجنيده بالتشاور والتنسيق مع بعض مسؤولي الدول الراعية للثورة المضادة هو الجنرال عبد الفتاح السيسي، ذلك الجنرال الذي تم تقديمه للرئيس مرسي في صورة ملاك جاء ليعينه على محاربة وطرد الشياطين التي ستحيط به أثناء حكمه، وكان السيسي وقتها يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية برتبة لواء قبل أن يرقيه مرسي إلى رتبة فريق ويعينه وزيرا للدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي، بعد أن ابتلع مرسي الطُّعم، ودخلت عليه اللعبة، بأن السيسي هو هدية السماء وأنه يصلح لأن يكون ذراعه اليمنى في الحكم، ولعل الذي رسخ هذا المفهوم عند مرسي بطهرانية السيسي، هو المخطط الذي وضعه له العسكر، ذلك المخطط الذي كان يقضي بأن يقوم السيسي بتحذيره من مخطط انقلاب عسكري، يرتب له طنطاوي بمعاونة سامي عنان، فطبقا للرواية الأكثر انتشارا حول قصة الإطاحة بطنطاوي وعنان، فإن قرار الإطاحة بطنطاوي وعنان، جاء على في أعقاب حادث رفح الإرهابي الذي وقع في الخامس من أغسطس 2012 والذي أسفر عن استشهاد 16 جنديا وضابطا مصريا، وأن الثنائي طنطاوي وعنان كانا يرتبان للانقلاب على مرسي في مراسم تشييع جثامين هؤلاء الضحايا، وهي المراسم التي تم الإعداد لها بعناية فائقة لترسخ لدى مرسي صدق تحذيرات السيسي من طنطاوي وعنان، حيث شهدت المراسم اعتداءات أعداد كبيرة من الجماهير على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في ذلك الوقت دون أي تدخل من الشرطة العسكرية حتى أن الجماهير كادت تفتك بقنديل عند خروجه من المسجد عقب صلاة الجنازة، مما اضطره للجري في الشارع ممسكا حذاءه بيده، كما قامت الجماهير بالهتاف ضد مرسي وتحميله مسؤولية الحادث، وهذه الأحداث هي التي جعلت مرسي يغيب عن الجنازة، وقيل وقتها إن الذي حذر مرسي من المشاركة فيها هو عبد الفتاح السيسي، بعد أن أبلغه بوجود مخطط من طنطاوي وعنان يقضي بترك الجماهير تعتدي عليه وربما قتله، أو على الأقل إهانته وإهدار كرامته، ومن ثم يقوم طنطاوي وعنان بالانقلاب عليه، وهذا الموقف الأخلاقي النبيل هو الذي جعل مرسي يثق في السيسي ثقة عمياء، ويعينه على الفور وزيرا للدفاع بدلا من طنطاوي، بما يعني ابتلاعه الطعم ونجاح خطة تجنيد السيسي.. والذي يدقق في تلك التفاصيل ويراقب ما حصل لاحقا، يتأكد أن كل ما حدث في هذه القصة كان مرسوما بدقة بالغة، وأن الخطة وضعت بتنسيق وتعاون كاملين بين السيسي وطنطاوي، ولو أن مرسي كانت لديه خبرة سياسية كافية في فنون التعامل مع العسكر، لفهم المخطط أو على الأقل ساوره الشك في وجود مخطط يشارك فيه السيسي، ومن ثم يطيح به مع طنطاوي وعنان، فلو أنه فعل ذلك لانقلبت المعايير، وإن كنت أعتقد أن كشف مرسي للخطة وإفساده اللعبة، قد تكون خطته البديلة هي انقلاب الجيش عليه وربما اغتياله في حينها، والذي يجعلني أؤكد على وجود اتفاق وتنسيق بين طنطاوي والسيسي على هذه الخطة، هو استمرار العلاقة بين الإثنين بعد إقالة طنطاوي دون أن يشوبها أي شائبة، وقد ظهر ذلك جليا بعد الانقلاب، من خلال حرص السيسي الشديد على الاحتفاء بطنطاوي ودعوته لكل المناسبات خصوصا العسكرية، ليؤكد تقديره الكبير له، وليوصل رسالة للقوات المسلحة وللرأي العام أن طنطاوي كان ولايزال هو الأب الروحي له وللمؤسسة العسكرية، ولو أن السيسي كان قد غدر بطنطاوي فعلا ووشى به عند مرسي وتسبب في إقالته بهذا الشكل المهين، لما استمرت العلاقة بينهما على تلك الرومانسية التي كنا نراهما عليها بعد الانقلاب..
وهناك مشهد أخر يكشف التنسيق بين السيسي وطنطاوي لخداع مرسي واستغلال طيبته وعاطفيته وقلة خبرته السياسية، ذلك المشهد الذي رأيناه في اللقاء الذي تم بثه بأحد حلقات المسلسل التليفزيوني الدرامي «الاختيار 3» للتدليل على عنف الإخوان وهذا ليس موضوعنا، ففي هذا المشهد ظهر الثلاثة (مرسي وطنطاوي والسيسي) قبل الإعلان الرسمي عن فوز مرسي برئاسة الجمهورية، وبدا من سياق الحوار أن الثنائي -السيسي وطنطاوي- أحدهما كان يعزف والأخر يغني على مرسي لتجميل صورة السيسي، فطنطاوي يتحدث عن أخلاق السيسي ومناقبه الجليلة في الجيش، قائلا هو المفروض لا يكون موجودا هنا – يقصد السيسي – حتى لا تكون شهادتي فيه مجروحة، فيما يظهر السيسي في أخر الكادر وهو يداري خجله ويقول بالهمس والإشارة لطنطاوي أخرج أنا؟ بينما يستطرد طنطاوي ويقول إن ده -أي السيسي- زي ابني، وعلى فكرة متدين وإخلاصه لله كبير وهذه جملة لا محل لها من الإعراب لأن الجيش المصري معروف بعلمانيته ولا يرحب بالمتدينين، لكن الهدف كان هو الدخول لمرسي من الجانب الذي يحبه وهو التدين، ثم يضيف أنا حاطط عيني عليه من زمان ليكون قيادة مهمة في المستقبل، في المقابل يؤكد مرسي على كلام طنطاوي بالابتسامة وهز الرأس والارتياح لكل هذه الصفات التي يتحلى بها السيسي، وكأن لسان حاله يقول «سيماهم في وجوههم»
خطة نشر الفوضى
لم يكتف المجلس العسكري بما انجزه من خطط في كل المراحل السابقة لإجهاض الثورة، والتمهيد للانقلاب عليها، إنما راح يحرض دولته العميقة للعمل على تعطيل كل مرافق الدولة وافتعال المشاكل والأزمات الكبرى التي تُظهر عجز دولة الإخوان عن التصدي لها أو حلها، ومن ثم يتوق الناس إلى وجود نظام قوي يقدر على إدارة الدولة وضبط إيقاعها وإعادة الانضباط لها، وهذا أمر لا يتحقق إلا في وجود مؤسسة مثل المؤسسة العسكرية.. ففي فترة حكم مرسي وحكومته التي شكلها في الرابع والعشرين من يوليو 2012، بدأت تظهر العديد من الأزمات التي عجز مرسي وحكومته عن إيجاد حلول لها، حيث ظهرت أزمات نقص الوقود التي ترتب عليها الانقطاع المستمر للكهرباء، وعدم توافر أنابيب البوتاجاز التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وأصبحت غير موجودة إلا بالسوق السوداء، هذا فضلا عن عدم توافر المواد البترولية بمحطات الوقود ما تسبب في تكدس تلك المحطات بالسيارات التي كانت تقف في طوابير تمتد لعدة كيلومترات وتستمر ساعات طويلة، حتى يتمكن صاحب السيارة من تموين سيارته بالوقود..
في الوقت نفسه كان الإعلام يمارس مهمته على أكمل وجه في الحرب على الإخوان وإظهار عدم جدارتهم بإدارة الدولة، حيث راح يفتح النار على مرسي والحكومة ويتهمهم بالفشل والعجز عن مواجهة الأزمات التي يعاني منها الشعب، في اللحظة نفسها كانت القوى السياسية المعادية للإخوان تحرض الجماهير على الخروج للشارع للتظاهر والتنديد بحكم الجماعة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور في الشوارع الرئيسية، وإصابة الدولة بالشلل..
في الجهة الأخرى كان الرئيس محمد مرسي يسابق الزمن من أجل إنجاز دستور جديد للبلاد، أملا في ضبط الوضع السياسي لاستقرار الدولة، إلا أن القوى السياسية التي كانت تأوب مع الإعلام والثورة المضادة، راحت تضع العراقيل والخوازيق أمام أي منجز يمكن أن يحققه، وهو ما ظهر في أزمة صياغة الدستور، التي شهدت انسحاب واحد وثلاثين عضوا من بين المائة عضو التي ضمتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، احتجاجا على ما وصفوه بهيمنة التيار الإسلامي على مواد الدستور، وهذه الانسحابات هي التي فتحت الباب أمام الاعتراضات الكبيرة من جانب القوى الليبرالية والاشتراكية على إجراء الاستفتاء لإقرار الدستور.. مؤسسة القضاء كانت تشارك في اللعبة أيضا، حيث أعلن قضاتها رفضهم الإشراف على الاستفتاء بدعوى الاعتراض على الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012، بحجة أنه يمنح الرئيس سلطات واسعة تتجاوز سلطاته، كذلك الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية التي قررت تعليق أعمالها في تلك الفترة احتجاجا على ما وصفته بالضغوط النفسية والمادية التي يواجهها قضاة المحكمة نتيجة محاصرة مؤيدي الرئيس للمحكمة..
وغير ذلك من الأزمات الأخرى الكبرى المتفجرة في توقيت واحد، والتي كان من بينها الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمام قصر الاتحادية، وهي الاشتباكات التي أسفر عنها وقوع ثمانية قتلى غالبيتهم من مؤيدي مرسي، وقد كشفت تلك الأحداث عن الدور الذي تلعبه الدولة العميقة في افتعال الأزمات، أو على الأقل ارتياحها وترحيبها بها، وهذا ما أظهره موقف وزير الداخلية في ذلك الوقت (اللواء أحمد جمال) الذي كان يتابع الأحداث الدموية ويرفض إرسال أي قوة للفصل بين المواطنين وحقن دمائهم، ولعل الذي يؤكد تواطؤ الوزير في هذه الأحداث أو على الأقل رضاه عنها ورغبته في تصاعدها، هو رفضه الرد على تليفون الرئيس مرسي عندما اتصل به ليأمره بإرسال قوة من الداخلية للسيطرة على الموقف وفرض الأمن أمام القصر الرئاسي..
أضف إلى ما سبق أزمة مستشاري الرئيس التي تفجرت وقتها أيضا بعد أن قرر سبعة منهم الاستقالة لأسباب مختلفة وهم: أيمن الصياد وعمرو الليثي، ومحمد عصمت سيف الدولة، وسيف عبد الفتاح، سمير مرقص وفاروق جويدة ورفيق حبيب، هذا بخلاف أزمات حوادث القطارات التي تكررت في تلك الفترة، ناهيك عن حوادث الإرهاب التي وقعت في سيناء خلال تلك الفترة، والتي شهدت حادثين في أقل من شهر، الأول في الثامن من أكتوبر 2012، بالهجوم على سيارة بريد وأسفر عن مقتل أمين شرطة وأحد أبناء سيناء، والثاني في الثالث من نوفمبر، بالهجوم على كمين للشرطة بطريق جسر الوادي شمال سيناء، وأسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الشرطة، هذا بخلاف الحادث الكبير الذي وقع في أغسطس والذي تناولناه سالفا، عند الحديث عن تجنيد السيسي في نظام مرسي..
وغير ذلك من الأزمات المفتعلة والمدبرة التي لا تحصى ولا تعد، والتي تولدت في توقيت واحد، وكانت أشبه بماسورة مياه ضخمة انفجرت فجأة!
نعيم السلطة الذي قتل الوزراء
هذا الوضع الملتهب والمشحون بالمؤامرات ضد الثورة وضد الإخوان تحديدا، كان يوجب على مسؤولي الجماعة بالدولة، إدراك الواقع بأن انقلابا عسكريا قادما في الطريق، فما كان يجري في الشارع وفي مختلف مؤسسات الدولة، كان كاشفا لخطورة الوضع الذي تسير إليه البلد تحت حكم الجماعة، بل يكشف الخطر الذي يهددهم إذا ما وقع الانقلاب، بيد أن الإخوان لم يحركوا ساكنا يثبت فهمهم لحقيقة ما يجري، أو يظهر قدرتهم على مواجهة المؤامرة والتعامل معها، حيث ظل مرسي في عالمه الأفلاطوني بالسعي لتحقيق انجاز وسط كل هذه الفوضى، فبدا كمن يرتب غرفة نومه بينما المبنى يتهم هدمه بالبلدوزرات من الخارج، فيما ظل الوزراء يمارسون مهام عملهم رغم كل الأعاصير التي كانت تحيط بهم وتوشك أن تعصف بهم جميعا، ولذا كان محزنا ومحبطا أن يعتقد مسؤولو الإخوان أنهم قادرون على تجاوز كل هذه الأزمات وفعل شيء يثبتون به وجودهم وجدارتهم بالمسؤولية، وهو ما يؤكد انفصالهم التام عن الواقع، وكأن كل أزمتهم مرهونة بتحقيق إنجازات تجعل الشعب والإعلام يرضوا عنهم، وليست الأزمة في وجود دولة عميقة يجاوز عدد أفرادها العشرة ملايين، يتحكمون في كل مفاصل الدولة، ويعملون جاهدين على تخريبها وشل حركتها، لذا كم كنت أشفق على ذلك الرجل المخلص باسم عودة وزير التموين، وهو يتصدى بطوله لكل هذه الرياح من أجل تحقيق بعض مطالب المواطنين، لدرجة أنه كان يفعل ما لا يجب أن يفعله الوزير، مرة بتسلقه للسيارات المحملة بأنابيب البوتاجاز لبيعها بنفسه للمواطنين قبل وصولها للسوق السوداء، وأخرى بمطاردة مافيا تجارة الدقيق، فضلا عن قتاله من أجل إيجاد حلول جذرية لأزمة رغيف العيش، وغير ذلك من المحاولات التي كانت أقرب إلى المهام الانتحارية، وهو ما كان يمكن أن يعرض حياته للخطر..
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة التي كان يبذلها الوزراء الإخوان في تلك الفترة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنها كانت أقرب إلى مصارعة طواحين الهواء أو النقش على الماء، لذا كنت أرى أن الأجدر بهم وبكل المسؤولين المحسوبين على الثورة أن يتوقفوا عن السعي لتحقيق الإنجازات، وأن يعملوا على علاج أصل المرض وليس أعراضه بتطهير مؤسسات الدولة وجهازها الإداري، وهذا لم يكن سيتحقق إلا في حالة واحدة فقد هي تركهم للمكاتب، والعودة مجددا إلى ميدان الثورة، لاستكمال ثورتهم والقضاء على الدولة العميقة وإزالتها من الجذور، لكنهم وللأسف لم يفعلوا، بل ظلوا في مواقعهم غير مدركين لخطورة الموقف، ويبدو والله أعلم أن نعيم المناصب التي كانوا فيها، وهيلمان السلطة الذي كان يحيط بهم، هو الذي أسكرهم وأدار رؤوسهم عن الواقع المأساوي الذين يعيشون فيه، فكانت النتيجة أن فشلوا وفقدوا السلطة وهيلمانها، بل وغٌيّبوا في السجون، وقُتل رئيسهم!!
الأخونة والإرهاب الفكري
الإرهاب الفكري للإخوان عن طريق اتهامهم المستمر بالسعي لأخونة الدولة، كان واحدا من الأسلحة الفتاكة التي تم استخدامها ضدهم، وهو سلاح أحسن الإعلام والقوى السياسية المعادية للإخوان توظيفه ضدهم وربما ضد الإسلام السياسي بأكمله، حيث نجح الإعلام والسياسيون في تصوير هذا التيار على أنه عدو من خارج الوطن جاء لاحتلال الدولة المصرية، وليس مجرد فصيل سياسي يمتلك تأييدا واسعا من الشعب، جاء عن طريق انتخابات حرة نزيهة، شهد العالم كله بطهارتها، وأن أبناءه أخوة في الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فكان من نتيجة ذلك أن جعلوا قطاعا واسعا من الشعب المصري ينجرف خلفهم، مبديا قلقه وتخوفه من حكم الإسلاميين، ومن أخونة الدولة وأسلمتها، حتى أن المصريين الذي يقال عنهم أنهم متدينون بطبعهم، راحوا يتصدون لهؤلاء الإسلاميين خوفا على بلدهم من فرض بعض قيم الدين التي ادعى الإعلام إن الإسلاميين يريدون فرضها على الشعب، مثل تحجب المرأة، وحظر بيع الخمور، وغلق الملاهي الليلية، والتصدي للعري، ومنع ارتداء النساء للمايوهات في الشواطئ، وغير ذلك من الشائعات التي لم يصرح بها الإسلاميون، بينما اندفع الناس للدفاع عن بقائها، بل والمطالبة بالتخلص من الإخوان والإسلاميين، وهو ما ظهر جليا في المظاهرات العارمة التي خرجت في 30 يونيو 2013!!
ولم تقف حرب الإرهاب الفكري عند هذا الحد فحسب، بل وصلت لحد تشكيك الإعلام في نزاهة وأمانة الرئيس مرسي في اختيار الموظفين والمسؤولين الذين يقوم بتعيينهم، فأصبح أي مسؤول يصدر الرئيس قرارا بتعيينه في أي جهة بالدولة، حتى وإن كان مسيحيا يقولون عن أنه إخوان، وأي قرار يصدره حتى وإن كان في الصالح العام يصنفونه على أنه أخونة للدولة، بيد أن الغريب هنا هو أن تؤثر تلك الحرب غير المنطقية أو المتسقة مع الواقع، في قرارات وأفعال وتصرفات مسؤولي الإخوان أنفسهم، بعد أن بدا عجزهم الواضح عن مواجهتها بأسلحة مضادة، فصاروا يترددون في اتخاذ أي قرار، كما كانوا يتحسبون لأي تصرف يفعلونه خوفا من اتهامهم بالأخونة، فأثر ذلك على أدائهم وعطلهم عن انجاز أي من المهام المطلوبة..
وتواصلت حرب الإرهاب الفكري على الإخوان ومرسي تحديدا، بترديد الشائعات الكبرى والتي إن صحت لمثلت تهديدا للأمن القومي المصري، ولأتُهم صاحبها بالخيانة العظمى، من هذه الشائعات مثلا، تنازل مرسي عن سيناء لصالح أهل غزة، وبيعه لقناة السويس والأهرامات لدولة قطر، والتنازل للسودان عن حلايب وشلاتين، وغير ذلك من الشائعات، التي وضعها العسكر بعناية، وأدت لاغتيال مرسي معنويا، وكانت من المبررات التي أدت إلى الانقلاب عليه، بل ومحاكمته عليها لاحقا!!
التسفيه من مرسي
مخطط الانقلاب على مرسي كان يقضي أيضا بالتسفيه منه وإضعاف شخصيته، وإظهار قراراته بأنها والعدم سواء، تجلى ذلك في القرار الذي اتخذه مرسي في الثامن والعشرين من يناير 2013 عندما فرض حالة الطوارئ بمنطقة القناة لمدة 30 يوما، وذلك على خلفية الأحدث التي وقعت في بورسعيد، عندما هجم الأهالي على السجن العمومي وقسم الشرطة، بعد قرار المحكمة بإحالة 21 شخصا من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد لمفتي الجمهورية، وهي المذبحة التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي كما ذكرنا سابقا، حيث قام عدد من أهالي المحكوم عليهم بإطلاق الأعيرة النارية على السجن الذي به المتهمون، فيما قام أخرون بإطلاق النار في محيط ميناء بورسعيد، وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل ضابط وأمين شرطة ونحو 52 أخرين.. يومها أصدر مرسي قراره الجمهوري بفرض حالة الطوارئ، وهو القرار الذي نفذه الجيش بالفعل بنزول الدبابات والمدرعات لفرض حظر التجوال بمنطقة القناة، إلا أن هذا الحظر سرعان ما تم خرقه والاستخفاف به، حيث ظهر من يلعب الكرة أمام الدبابات في مباراة كان يقودها طاهر أبو زيد نجم الأهلي القديم، فيما ظهر أخرون من أعضاء فرق الفنون الشعبية بمنطقة القناة، يرقصون يغنون على أنغام السمسمية أمام الدبابات أيضا دون أن يمنعهم أو يستوقفهم أحد من الضباط أو الجنود المكلفين بفرض الحظر، بما يشير دون مواربة إلى أن كل هؤلاء كانوا مدفوعين من الأجهزة التي تعمل على كسر هيبة مرسي، وإهدار قيمة منصب رئيس الجمهورية، وقد تأكد دور الأجهزة في تحريض الناس على خرق الحظر، بعد تعيين طاهر أبو زيد وزيرا للرياضة بعد الانقلاب مكافأة له على خرق الحظر ولعب الكرة أمام الدبابات، ودهس قرارات الرئيس!!
نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.