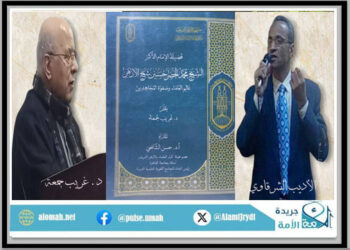“الزيني بركات” رواية لجمال الغيطاني صدرت لأول مرة عام 1974م. وهي تدور حول شخص يدعى: “الزيني بركات” كان يعمل كبيرا للبصاصين، أي رئيسا للمخبرين، في عهد السلطان الغوري أوائل القرن العاشر الهجري.
وكان السلطان قد قرر أن يتولى بركات بن موسى نظارة الحسبة بحيث يصير مسؤولا عن مراقبة الأسعار والمكاييل والموازين والتجسس على الناس ومعرفة ما يقولون عن السلطة، إلى جانب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأنعم عليه بلقب “الزينى”. بيد أن الزيني ذهب للسلطان راجيا إعفاءه من هذه المسؤولية الجسيمة، فهو عبد فقير يريد قضاء الباقى من عمره فى أمن وسلام، ولا يستطيع أن ينام وهناك مسلم مظلوم سوف يحاسبه الله عنه يوم القيامة حتى لو لم يكن يعلم به. وحار كبير البصاصين السابق الشهاب زكريا بن راضى في الأمر، إذ هو يعرف من رجاله المنبثين فى كل مكان أن بركات دفع ثلاثة ألاف دينار للحصول على هذا المنصب، وزادت حيرته عندما لم يجد شيئا ذا قيمة في سجلاته عن هذا الرجل رغم أن وظيفته، بوصفه كبير البصاصين، تتيح له معرفة كل شىء عن أي شخص، إذ كل ما وجده في الصفحة المخصصة لبركات هو: “بركات بن موسى، له مقدرة الاطلاع على النجوم، أمه اسمها عنقا”.
سمع الناس برفض بركات للمنصب وتعجبوا، ثم بدأ تعلقهم به، وطلبوا من شيوخ الأزهر الضغط عليه لقبول المنصب. وحين توجه بركات إلى السلطان مرة أخره متذللا وقابلا تولى مسؤولية الحسبة الشريفة إرضاء لجماهير الشعب تنفس الناس الصعداء مؤملين بداية عهد مجيد كله عدل ورخاء.
وبدأ الزيني عمله بإصدار القوانين لتنظيم أحوال الناس وإنصاف المظلومين وإحقاق الحق وإلغاء الاحتكار والحد من ظلم رجال المماليك وفتح بيته لتلقى المظالم من الناس، وزاده السلطان قانصوة الغوري تشريفا بتعيينه واليا على القاهرة بالإضافة إلى منصب الحسبة فى أرجاء البلاد.
وقد اهتم الزينى بإنشاء جيش من البصاصين آمرا كبيرهم بفتح ملفّ لكل شخص في السلطنة منذ ولادته يسجل فيه كل ما يتعلق به منذ لحظة ميلاده إلى ساعة وفاته بما فى ذلك ميوله وأهواؤه ومكامن خطره ونقاط ضعفه بحجة أن بني عثمان يتربصون بمصر وينتظرون الوقت الملائم للانقضاض عليها.
ويشرع الزيني بركات فى تنفيذ برنامجه الإصلاحى، فيعلق الفوانيس لإضاءة الشوارع ليلاً، ويفتح داره لتسلم المظالم، ويلغي الضريبة، ويسعر البضائع، ويرفع الاحتكار عن بعض السلع… إلخ. ثم يقوم السلطان بتسليمه علىّ بن أبي الجود كي يجبره على كشف ما خبأه من أموال. لكن الشهور تمضى دون أن يبيح ابن أبي الجود بشىء. ويبدأ القارئ المخدوع بالزيني بركات فى اكتشاف شخصيته الحقيقية حين تصل إلى علمه وقائع حبس ابن أبي الجود والتعذيب الوحشى الذى وقع عليه وإعدام عدد من الفلاحين، ثم فشل الزينى بركات رغم ذلك كله في الوصول إلى أية معلومات حول المال المخبوء. ثم يبدأ التحالف الشيطانى بين الزينى وزكريا فى البصّ المشترك على الناس وتحديد نظام دقيق لتسجيل تفاصيل حياتهم فى قوائم، ويصل الأمر إلى درجة عقد اجتماع يضم جميع كبراء البصاصين فى الممالك والإمبراطوريات المختلفة لتبادل الخبرات المختلفة في التجسس والمراقبة. ثم تبدأ الحقائق المفزعة في الظهور، ومنها أن الزيني إنما رفض منصب الحسبة فى البداية كى يرتفع قدره بين الناس ويكتسب الشعبية التى توطد عرشه وتمنع أي أمير من قتله خوفا من ثورة الجماهير. أما بالنسبة لقصقصته ريش صغار التجار والمحتكرين فقد كان يفعله ذلك كى يرضى الناس عنه، وفي ذات الوقت كان يغض الطرف عن جرائم الحيتان الكبار. وفوق ذلك كان يجمع الإتاوات باسم السلطان وباسم الشيخ أبي السعود، الذي لا يعلم من حقيقة الأمر شيئا.
وبسبب جبروت البصاصين تخرس الألسنة، ثم يعتاد الناس الظلم ولا يجدون فيه بعد هذا ما يستغرب أو يعاب. وعندما تسقط الدولة المملوكية ويحتل العثمانيون البلد يختفى الزينى بركات أياما ليظهر مرة أخرى وقد تولى للعثمانيين حسبة القاهرة كما كان الأمر أيام المماليك. لقد كان الزينى فى الحقيقة يتصل بالعثمانيين قبل هذا فى السر، بينما كان يشنق ويخوزق أي تاجر أو طالب علم يُشْتَبَه في اتصاله بهم ليوحى للسلطان أنه رقيب على أمن البلاد والعباد…
وفي القصة أخطاء فاحشة لا يقع فيها أقل التلاميذ إلمامًا بتاريخ الإسلام وعقائده. يقول المؤلف على لسان كبير البصاصين: “ألم يكن خاتم المرسلين وسيد البشر مضطهَدًا من قومه؟ ألم يرمه اليهود بالحجارة من فوق أسوار الطائف فألهب الهجير باطن قدميه، وسال دمه؟ ألم يحاربوه وتأكل واحدة منهم كبد عمه حمزة نيئة؟ ومن قبل ألم يثقلوا رأس المسيح عليه السلام بالشوك، ودقوا المسامير فى جسده وصلبوه؟” (ص150). فاليهود لم يرموا النبى عليه الصلاة والسلام بالحجارة، لا فى الطائف ولا فى غيرها. بل الذين رَمَوْه بالحجارة إنما هم صبيان الطائف وعبيدها وسفهاؤها من المشركين الوثنيين. ولم يكن ذلك من فوق أسوارها، بل فى الشوارع التى كانوا يطاردونه فيها.
لقد خلط الكاتب بين تآمر اليهود على إلقاء رَحًى من فوق سطح أحد منازلهم على النبى عليه الصلاة والسلام وبين مطاردة سفهاء الطائف وصبيانها له بتحريض من كبارها الكفرة. كذلك فالتى لاكت كبد حمزة رضى الله عنه لم تكن يهودية، بل هي هند زوجة أبي سفيان. وهند لم تأكل كبد حمزة، بل لاكتها ثم لفظتها. ولا أدرى كيف غاب هذا أو ذاك على الكاتب، وهو متعارَف مشهور لا يخفى على أحد! لعن الله الثقافة الضحلة!
أما السيد المسيح عليه الصلاة والسلام فإن القرآن حاسم تمامًا في نفى الصلب عنه. ولا يَقُلْ أحد إن من حق الكاتب أن يرفض ماجاء فى القرآن ويأخذ بادعاء كتبة الأناجيل، فليس هذا رأيا للكاتب، بل هو كلام كبير البصاصين. وكبير البصاصين، مهما يكن من ظلمه ومعاونته للحكام المستبدين، هو رجل مسلم، فضلا عن أنه ينتمى إلى القرن العاشر الهجرى. أقصد أنه لا يمكن أن يكون قد أَوَّل قوله تعالى: “وما صلبوه” (النساء/ 158) بمعنى أنهم لم يقتلوه صَلْبًا، لكنهم رغم ذلك قد وضعوه على الصليب وسمَّروه كما يقول القاديانيون، الذين يقول أحدهم (وهو مالك غلام فريد، محرر ترجمة القرآن الكريم إلى الإنجليزية وتفسيره بها) في ترجمة هذه العبارة القرآنية الكريمة: “nor did they bring about his deathon the cross“، فإن مثل هذا التأويل الغريب الذي لا تسعفه اللغة لم يظهر إلا فى العصر الحديث. وعلى أية حال فلا يمكن أن يقول به إلا من كانت صناعته التدقيق في مثل هذه النصوص وتقليبها على كل وجوهها المحتملة وغير المحتملة. وأين من ذلك بصاص كان يعيش في القرن العاشر الهجرى؟
ثم هل كان بوذا يُعْبَد في الصين كما يفهم من قول هذا البصاص نفسه: “أخبرنا كبير بصاصي بلاد الصين العظيمة أنه نجح فى ضم أكابر العلماء في صفه والأعيان والكهنة خَدَمة البوذا الأعظم”؟ (ص152). كذلك هل كانت هناك اتفاقيات مشتركة بين الحكومة المصرية في ذلك العهد والحكومة الصينية وغيرها من الحكومات على تبادل المعلومات الاستخباراتية حتى يَكْذِب كبير البصاصين فى مصر بعين وقحة زاعما أن نظيره فى الصين قد أمده بكذا وكذا من المعلومات؟ هذا هو العته بعينه. وهو يذكرني بقول الطلبة هذه الأيام: الدكتور امرؤ القيس، والدكتور الطبري، والدكتور البخاري، والدكتور الجاحظ، والدكتور البوصيري. وهكذا ينبغي أن يكون الأدباء العالميون الذين يتطلعون إلى إحراز جائزة نوبل، وإلا فلا.
واضح أن الغيطاني لا يعرف كيف ينبغى أن تكتب الرواية التاريخية. بل من الواضح أنه عاجز عن الاستفادة من قراءة كتب التاريخ، التى صدع دماغنا بأنه دائم الرجوع إليها بل العكوف عليها حتى ليظن المساكين من القراء أنه من كبار المؤرخين! ولله في خلقه شؤون! كذلك فالأسلوب الذى كتب به الغيطانى روايته هو أسلوب صحفى أقل من المتوسط لا يعكس شيئا من روح ذلك العصر بتاتا: لا فى الألفاظ ولا فى العبارات ولا في التراكيب ولا فى الصور ولا حتى في الجو. أى أنه قد فشل في أول خطوة من خطوات كتابة الرواية التاريخية، تلك الخطوة التى تتمثل فى إعاشة القراء داخل العصر الذى تدور فيه وقائع الرواية!
والغيطانى هو واحد من إفرازات الفترة السابقة على الثورة، تلك الإفرازات المشوهة التى خرجت علينا بكل ما هو سئ وفاسد فى عالم القلم مما لا يمكن أن تفلح الدعايات المغالطة في التغطية على سوئه وفساده. والمضحك أنهم كانوا يسوّقون الغيطانى للناس فى سوق الكتابة على أنه مبدع كبير. ولا أدرى أى إبداع وأي كِبَر، والرجل محدود القدرات، ضيق الثقافة، فقير الموهبة. بل إنه لا يحسن الإملاء، ودعنا من أخطاء النحو والصرف والأسلوب، فمن الظلم انتظار استقامة قلمه في هذه الميادين، وهو ما هو فى عالم التعليم والمدارس والشهادات التى لا تؤهل مثله لأكثر من طباع فى صحيفة. وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة سنة 1974م، ومع هذا لم يتنبه الغيطاني للأخطاء التي فيه والتى سوف نسوق بعضا قليلا منها فى هذا المقال، فلم يصلحها فى هذه الطبعة الجديدة، بل ولا فى طبعة دار الشروق الثانية عام 1994م، التى لا يزال مكتوبا فيها (ص152) قوله تعالى: “وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات” على النحو الذى أثبته الغيطانى العبقرى في الطبعة الأولى المطلقة على لسان الزينى بركات رغم أن الزينى بركات لم يكن يوما خريج مدارس الصنائع، ومن ثم لا يمكن أبدا أن يقول: “وجعلناكم فوق بعض درجات” كما دلس الغيطاني على الرجل، متصورا بعبقريته التى ليس لها من ضريع أن القرآن مكتوب بالعامية المصرية، التي لا يعرف جنابه سواها: بالممارسة طبعا لا بالدراسة، فالدراسة بالنسبة له أمر صعب كما هو واضح. أما الفصحى فيَدُك منه والقبر. وهذا أمر طبيعى، فتلك إمكانات الرجل، الذي لم يحصل إلا على شهادة المدرسة الصناعية في مهنة النِّسَاجة من أكلمة ولباد وأقمشة وأمثالها فيما قرأنا.
وبناء القصة عجيب لا أفهم له حكمة. لقد قسّم المؤلف قصته إلى عدة أقسام، وهذا أمر عادى يجرى عليه معظم مؤلفى القصص الطويلة، لكنه بدلا من أن يسمى كل قسم: “فصلا” مثلا سماه: “سرادقا”. ولا أدري السر وراء تنكبه المصطلح الشائع واستعماله هذه الكلمة التي لا أفهم ماذا يقصد بها، اللهم إلا إذا كان يقصد الخيام التي كان يتعلم صناعتها فى مدرسة الصناعة.
ثم إن عنوان كل “سرادق” هو بوجه عام عبارة طويلة بالنسبة لعناوين القصص وفصولها: فمثلا عنوان السرادق الأول هو “ماجرى لعلي بن أبي الجود وبداية ظهور الزينى بركات بن موسى- شوال 912هـ”، وعنوان السرادق الثانى هو: “وفيه يدبر الزينى والشهاب زكريا أمورا شتى”… وهكذا. والملاحظ أنه، رغم طول العناوين مما كان ينبغى معه أن يكون العنوان واضح الدلالة على أحداث الفصل (أو السرادق)، فإن العناوين لا تغطى أحيانا هذه الأحداث كلها، كما فى عنوان السرادق الثالث مثلا، الذى جاء على النحو التالى: “السرادق الثالث، وأوله وقائع حبس على بن أبى الجود” (ص83)، فإن حبس ابن أبى الجوذ وتعذيبه لا يستغرقان إلا جزءا من السرادق، أما باقى السرادق فلا علاقة له من قريب أو بعيد بهذا الحبس والتعذيب، بل لا ترد فيه أية إشارة إلى شئ منه. أما السرادق السابع فلا وجود له. إنما هو عنوان جانبي تحت عبارة قصيرة، ثم لا شئ. فما لزومه؟ لقد كان يمكن إلحاقه بالسرادق السادس، الذى كان آخر عنوان جانبى فيه هو: “سعيد الجهينى”، فهو أيضا عن هذا الشخص. كذلك فان آخر فصل في الكتاب عنوانه: “خارج السرادق”، فما دلالة هذا العنوان؟ لكن لا ينبغى أن نعول كثيرا على أن الغيطاني يقصد شيئا معينا، إذ ثقافته وموهبته الفقيرة الضيقة المحدودة أعجز من أن يكون لديها جواب على تساؤلاتنا.
ثم إن كل سرادق قد قُسِّم بدوره إلى عناوين جانبية. وهذه العناوين إما اسم أحد أبطال القصة، وإما اسم حى من أحياء القاهرة. ولكن هذه العناوين أحيانا لا تدل على ما تحتها. فمثلا نجد فى ص119 العنوان التالى: “كوم الجارح”، ولكن الكلام الذي تحته، ويستغرق ثلاث صفحات، هو عن الشيخ ريحان نفسه لا عن هذا المكان. وكثير منه غامض. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأحداث التي تَرِد تحت العناوين الجانبية المسماة باسم إحدى الشخصيات لا تُرْوَي كلها من خلال رؤية هذه الشخصية وحدها، بل بعضها فقط يُرْوَى من خلال نظرتها، وبعضها من خلال شخصية أخرى. ومعظم هذه العناوين الجانبية قد تكررت، مثل عنوان “سعيد الجهينى”، الذي رأيناه في ص14، 47، 71، 77، 79… إلخ
والغيطاني يقطع الفصول بنداءات رسمية تبدأ عادة بـ “يا أهالي مصر”، أو بخطبةِ جمعةٍ أو بفتاوَى أغلبُ الظنِّ أنها منقولة عن الكتب التى تؤرخ لهذه الفترة. وهو لا يدمج هذه المقتسبات بأحداث القصة إدماجا عضويا، بل يفردها ويحافظ عليها كما هى، فيحس القارئ أنها كالجنادل الصخرية في وسط مجرى النهر، إذ تقف عندها القصة فجأة أو على الأقل: تركد حركتها ركودا شديدا، ويشعر الإنسان أنه لا يطالع قصة بل بحثا تاريخيا، لكنه للأسف بحث تاريخي يخلو من النظرة المحللة والناقدة، ويكتفي بالنقل، والنقل العبثي في معظم الأحيان.
ويصدق هذا أيضا على الاقتباسات المطولة من الرحالة الإيطالى “فياسكونتي جانتى”، التي يؤخذ عليها إلى جانب ذلك أنها غير متساوية طولا، وتفتقد الترتيب التاريخى، ولا يطَّرد ورودها فى موضوع بعينه في الفصول التى وردت فيها. ثم ما الداعى إليها؟ ولماذا هذا الرحالة بالذات؟ بل لم كان أوربيا أصلا؟ وهل أضاف هذا الاختيار شيئا إلى القصة؟ بل أكانت القصة ستضارّ بشئ لو حُذِفت هذه الاقتباسات حذفا؟
ويدخل في بناء القصة أيضا عنوانها. وعنوانها كما نعرف هو “الزيني بركات”. أفليس من الغريب أن قصة تدور حول شخصية تاريخية لا تقول لنا من أين أنت هذه الشخصية؟ وما أصلها؟
إننى بعد تقليبي النظر فى بناء هذه القصة لا يخالجنى أدنى شك فى أن المؤلف لم تكن عنده خطة واضحة فى ذهنه لهذا البناء، وأن هدفه لا يعدو مخالفة الشائع ولفت الأنظار ببهلوانية فنية يحسب أن القارئ سوف ينخدع ويتوهمها تجديدا إبداعيا، وهي من الإبداع بريئة كل البراءة.
أما بالنسبة للسرد والأحداث فقد لاحظتُ الآتي: أن الغيطانى أحيانا ما يبدأ السرد تحت أحد العناوين الجانبية بكلام لا صلة بينه وبين سائر ما كتب تحت هذا العنوان. ومن ذلك مثلا أنه تحت عنوان: “سعيد الجهينى” (ص71) يسوق كلامًا غامضًا عن السماوات والشهب وما إلى ذلك مما لا دلالة له ولا علاقة تربطه ببقية الكلام، وهي عن زكريا بن الراضي والزيني بركات.
وهذا يؤدي بنا إلى الملاحظة الثانية، وهى أن العنوان الجانبي قد يحمل اسم شخصية ما، ولكن رؤية الأحداث تحت هذا العنوان لا تتم من خلال عيني هذه الشخصية فقط، بل تتأرجح بينها وبين عينى شخصية أخرى كما سبق أن وضحنا. وهذا الأمر مطرد إلى حد كبير. فلماذا العنونة إذن باسم شخصية معينة؟ وسوف أسوق هنا نفس المثال السابق، ففى صفحة 71 نجد العنوان هكذا: سعيد الجهيني”، ولكن العين التي ترى تتغير عند السطر السابع فى ص72، فبدلا من سعيد نجد أن الأحداث تُرَى بعينى منصور، لتعود مرة أخرى فتُرَى بعيني سعيد، وهذا مجرد مثال.
أما الملاحظة الثالثة فهي أن السرد يغمض أحيانا، فلا ندري عَمَّ يتكلم الراوى، كما هو الحال فى ص119. كذلك فإن طريقة السرد قد تقترب من تيار الوعي، لكن مع الاستمرار في رواية الأحداث بضمير الغائب (ص139-140 مثلا). وقد يتداخل تيار الوعى مع مشاهد اللحظة التى تسترجع فيها الشخصية ذكريات الماضى. فمثلا في ص185– 186 نرى سعيد الجهيني يتابع شريط ذكرياته وأفكاره إلى أن يقول (فى نفسه): “بقيت مسألة ثانية” (ص186)، ثم فجأة يقطع الغيطانى شريط الذكريات والأفكار، ويبتدئ فى وصف البيت، ثم يستطرد قليلا ليعود فجأة كما قطع الشريط فجأة فيقول واصلا ما أنقطع: “أما المسألة الثانية… إلخ”. والحقيقة أنني لا أستطيع أن أجد مسوغا لكل هذا سوى التصنع السخيف الذى يحسب الغيطانى، لضحالة موهبته، أنه يفتح به فتحا مبينا.
والغيطاني مغرم غرامًا غريبا بالتلبث عند المشاهد الجنسية: السوى منها والشاذ، مع أنه لا فائدة من وراء ذلك يمكن أن يجنيها القارئ، فهذه المشاهد الجنسية لا تساهم في تطوير الحدث أو إضاءة جانب مظلم فى جوانب الشخصية التى تمارس الجنس أو التى تشاهده. ثم إن هذا الوصف قد يأتى في جو مناقض تماما له، مما يدل على أن هذا غرام شخصي لدى الكاتب ينبغى أن يستشير فيه طبيبا نفسيا.
ولأضرب بعض الأمثلة السريعة على كل ذلك: فمثلا في ص41 نراه يأخذ فى وصف نهدى إحدى النساء من غير أن يكون لذلك أية فائدة، بل هو مجرد استطراد وثرثرة جنسية ينبغى على الفنان الحاذق أن يحذره ولا يستسلم له. لكن ما للغيطاني وما للحذق الفنى؟ وفى ص47 نجده، في قمة الحديث عن الحب الروحى، يذكر الجسد والنهدين. واللافت للنظر أن هناك منظرا تكرر وصفه أو الاشارة إليه عدة مرات مما يمكن أن يفيد هؤلاء الذين يحبون أن يدرسوا نفسيات الكُتّاب من خلال مثل هذه النصوص، وهو منظر رجل يجامع امرأة وقد تعرت مؤخرته: “كيف يتعرى السلطان ويلفح الفراغ مؤخرته الضخمة عندما يعلو امرأة من حريمة؟” (ص112). “آه ! لا بد أنها أخبرت الزيني بطريقة نومه معها… كان الزينى ثالثهما فى كل خلوة. عيناه اللامعتان تتأملان مؤخرته العارية” (ص128). “رأى بعينى عقله سماح الرقيقة التي تساءل يوما: أحقا تمضغ وتأكل وتأتي ما يأتيه البشر؟ رآها عارية تماما، يخور فوقها لوطي عاري المؤخرة” (ص140).
حتى حينما يحاول الكاتب أن يكتفى بالتلميح تحس أن التلميح غليظ سمج، بل أغلظ وأسمج من التصريح ذاته. وإنى لا أدرى كيف واتى القلم صاحبه فى كتابة هذا الكلام وصفا لعملية اغتصاب أحد الغلمان: “زام شعبان وعض يد زكريا. طرحه أرضا. أفسد الأرض البكر. عَبَر مضايق مجهولة لم ينفذ منها إنسان. وقف عند حافة لم يطلع عليها ذكر” (ص22). إن المؤلف هنا يتصور، بجلافة قلمه السمج، أنه بخلع غلالة من الشاعرية على هذا الجو الشاذ سيكون قد أتى بدعا. والحقيقة أنه بذلك قد زاد الجو شذوذا فوق شذوذه، فمثل هذه اللغة التى يظن هو أنها شاعرية لا تناسب هذا النتن. إن مثله كمثل من يأتي بباقة من الورد ويرمى بها فى وسط البراز متصورا أنه بذلك يمحو عنه نتانته وبشاعته. فأين التمييز؟ وأين التمييز أيضا في النص التالي؟:
“تجئ سماح. حلقه ضاق بلعابه وأنفاسه. أرسل ألما كالصهد. شَفَّتْ روحه وخَفَّتْ. تحررتْ من أسر الجسد. عَلَتْ. جناحاها دموع صافية. نجوم الأعالى خرساء. تقول حديثا خفيا غير منطوق، لا يسمعه مخلوق… أرسل دمعا صادقا كطلوع النهار. رأى بعينى عقله سماح الرقيقة التى تساءل يوم: أحقا تمضغ وتأكل وتأتى ما يأيته البشر؟ رآها عارية تمامًا يخور فوقها لوطى عارى المؤخرة، يصول ويجول فى أرض كانت حراما. يحرق عشبها. يجتز التين والزيتون. يحصد غلتها. يطفئ وهجها. تذكَّر يد سماح، يدها الصغيرة. رقيقة كهمسة، كبيت شعر أتقنت صياغته. احتواها فى يومه اليتيم الناسك عند خروجه معهم للنزهة. شم النسيم”. وكأن خبطتين فى الرأس ليستا كافيتين لإحداث الوجع، إذ نجده يعود بعد ذلك فيقول: “هذه اليد الرقيقة لا بد أن تحسس الظهر الخشن المنحنى فوق النبع الغزير” (ص140-141).
أما أهم ما في القصة فهو الوصف التفصيلى لفن التجسس على أفراد الشعب (أو “البِصَاصة” بلغة ذلك العصر) وكيفية التقاط كبراء البصاصين بصاصين جددا مستغلين فقرهم أو ماضيهم الملوث أو ما إلى ذلك ) كبعض من يمسكون القلم في بلادي المسكينة ممن تربَّوْا فى جحور المباحث وأمن الدولة وأطلقتهم للتجسس على أهل القلم الحقيقيين المحترمين تحت ستار الكتابة ورئاسة تحرير الصحف الأدبية)، وما تتسم به شبكة البِصَاصة من تعقيد بالغ حتى إن البصاصين لا يُكْتَفَى منهم بالتجسس على الأفراد العاديين، بل لا بد من تجسس بعضهم على بعض، وكذلك الدفاتر المسجل فيها كل شئ عن كل إنسان. وهذه المغالاة قد تذكّرنا بجوّ رواية “1984″، التى كتبها جورج أورويل، حيث لا يستطيع الإنسان أن يتنفس مجرد تنفس فى غير أن تلاحقة وسائل التنصت والتجسس التى زرعها النظام البوليسى المستبد القاهر فى كل مكان (انظر مثلا ص32-37، 100-102، 153، 148- 157). وهناك شىء آخر، وإن كان يذكرنا هذه المرة، ولكن من بعيد، برواية “هربرت جورج ولز”: “آلة الزمان”، إذ يتمنى كبير البصاصين أن يجىء يوم تخترع فيه آلة تعيد زمنا انقضى برمته لمواجهة إنسان ينكر ذنبا اقترفه (ص61. وانظر أيضا ص153 حيث يذكر أسلوبا آخر لا يحتاج إلى أى اختراع لاسترجاع الماضى الذى ولى). إلا أن الفرق بين كتاب الغيطانى وروايتى ولز وأورويل هو الفرق بين الأرض التى فى أسفل سافلين وبين السماء السابعة.
وهذا يقودنا إلى الحديث عن العيوب التى يعانى منها رسم الشخصية في كتاب الغيطانى. فمن المؤكد أن الفكرة (أو الأمنية) الآنفة الذكر ما كانت لتطوف فى رأس أحد فى ذلك العصر، بصاصا كان أو غير بصاص. ومعروف أن من أسباب نجاح القصاص فى تصوير شخصياته أن تكون مقنعة. وشخصية بهذا الوضع لا تقنع أحدًا. ومن ذلك الوادى أيضا التفات كبير البصاصين إلى الفرق بين الشئ مرئيا من زاوية ما والشئ فى ذاته، وكذلك الفرق بين الشئ مرئيا من زاوية معينة وبينه هو نفسه منظورا إليه من زاوية مختلفة، مما يدخل فى باب نسية الرؤية والإدراك (ص149-150). ومثله أيضا الأفكار التى تدور في عقل زكريا بن الراضي (ص60-61)، فهى تحتاج إلى عقل فلسفى دقيق وخيال نشيط واسع يرى الأشياء فى تشعباتها التي لا تنتهى، ومع ذلك لا تغيب عنه خطوطها العامة. وما هذا كله سوى بهلوانيات يظن الغيطانى أنها سوف تجعل منه روائيا مبدعا، وما هي فى الواقع إلا السخف مجسما.
أيضا فصورة الشيخ أبي السعود الجارحى قد خرجت مهزوزة، إذ يصوره الكتاب مرتادا لبيوت الدعارة فى شبابه، وحريصا بعد ذلك على التقرب إلى الأمراء والاعتزاز بمعرفتهم أمام الناس، بل وادعاء ذلك بالكذب أحيانا. وهذا الشيخ نفسه يُرْسَم فى مواضع أخرى رجلاً زاهدًا في الدنيا قد تجرد من علائقها، وملأ قلبَه الخوفُ من الله، وأصبح الموت والاستعداد له شغله الشاغل. فأما عن التناقص بين شباب وشيخوخته فقد يقال إنه تاب وأناب. وهذا جائز جدا، ولكن الكاتب لم يذكر شيئا عن الظروف التى يمكن أن تكون هى السبب فى تغير شخصيته، فظل التغيير غير مبرر. وأما التناقض، في شيخوخة الشيخ أبى السعود، بين رغبته الجارفة فى التقرب إلى الأمراء ورجالهم والافتخار بذلك بين معارفه وأقاربه وبين زهده فى الدنيا وتجرده من علائقها فلا يمكن تسويغه بحال. كذلك لا يمكن تسويغ التناقض الآخر فى تصرفاته وأخلاقه بين تلك الرغبة فى التقرب من الأمراء وبين حبسه الزيني بركات وتنكيله به. ودَعْنَا من السؤال الذى لا إجابة فى الكتاب عليه: من أين للشيخ بهذه القوة التى تمكنه من حبس الزينى بركات، هذا الذى لم تستطع مؤامرة كبير البصاصين أن توقف تقدمه الواثق الحثيث نحو أكبر المناصب الإدارية؟ (انظر ص112-117، 165).
وهناك سمة لاحظتها في عدد من شخصيات القصة، وهى تطويفهم بالدنيا. وهذه الشخصيات هي الرحالة الإيطالى (ص7)، والزينى بركات (ص7)، وشعبان (ص22)، وسعيد (ص30، 171). ومع حرص الغيطانى على الإشارة إلى ذلك عند حديثه عن كل شخصية فى هذه الشخصيات فاللافت للنظر أن هذه السمة لا تقدم ولا تؤخر: لا في تطوير أحداث القصة ولا فى تطور هذه الشخصيات أيضا.
فإذا انتقلنا إلى الوصف راعنا أن الكاتب يكثر من الاستطرادات ومن ذكر أمور متعلقة بالشخص أو الشئ الذى يتكلم عنه لا تفيد في تطور الأحداث. من ذلك مثلا أنه لا يكتفى بذكر صناعة الصفدى (أحد الشخصيات الهامشية العابرة في القصة)، وهى أنه بائع عطور، بل يمضى فيذكر الحى الذى يبيع فيه عطوره، ثم يزيد فيصفه هو نفسه بأنه “أحسن من يستقطر الزيت من السوسن. يلخص ويركز روح السوسن”. ثم يمضى فيتحدث عن عاداته: “من عادات الصفدى شرب التمر هندى والخروب والليمون فى قرارة أيام الشتاء. يقول: هذا يفتح دروب القلب ويشرح الصدر” (ص32). وهذا كله لا فائدة منه ولا عائدة، فسواء كان يلخص روح السوسن أو روح النعناع، وسواء كان يشرب الليمون أو الينسون، وسواء كان يشرب من كوب أو كوز أو يشرب من كيعانه، فإن ذِكْر ذلك لا يقدم ولا يؤخر قيد أنملة. وليس الاستطراد هو العيب الوحيد هنا بل الاستقصاء أيضا، فهو لا يكتفى عادة ببعض الأمثلة أو بعض الأوصاف، بل عنده صبر عجيب فى تتبع كل التفاصيل يملأ النفس بالملل (انظر ص23-24، وهو مجرد مثال على ذلك).
ثم نصل إلى لغة القصة. وأول ما نلاحظه هو خلو الكتاب بوجه عام من علامات الترقيم، اللهم إلا الفاصلة أو النقطة، فلا شرطة ولا نقطتين متراكبتين ولا علامة استفهام أو تعجب ولا نقطتى قول ولا نقطتين متجاورتين إلا في النادر. وهذا عيب من العيوب المرهقة جدا، فإن علامات الترقيم هي انعكاس لطريقة سير الفكرة فى ذهن الكاتب. وليس من المعقول أن تتوالى الصفحات فى كثير من الأحيان بغير أية علامة ترقيم، إلا الفاصلة أو النقطة، وكأن تلك الصفحات الطوال هي عبارة واحدة شديدة الطول. إن منظر الصفحة وحده، وهي مصمتة سوداء تامة السواد، يسد ويصد النفس سدا وصدا!
والغيطاني فى أحيان كثيرة يتجاهل حروف العطف، مثل قوله: “وفيه تغرق البيوت فى نعاس طرى، تتأخر الشمس فى الوصول إلى حوارى الحسينية. الباطنية. الجمالية والعطوف، بينما ترى واضحة من فوق أسوار وأبراج قلعة الجبل جماعة المماليك التى تخترق شارع حدرة البقرة لم يخرجوا من القلعة. خرجوا من بيت الأمير قانى باى الرماح أمير الخيل السلطانية. عبروا الخليج. نزلوا على مهل إلى باب اللوق. أشرعوا سيوفهم فى وجه النهار المقبل. السقاؤون الذين قابلوهم قرب باب اللوق أول من يستيقظ فى المدينة. يحملون الماء من النيل إلى البيوت. يجهلون مقصد الفرسان. تنثر حوافر خيولهم دوامات ترابية صغيرة. تسرع خطوات الجمال مثقلة بقرب المياه البنية اللون. يخفت همس السقائين. يبقى فى أذهانهم انطباع خفيف كأثر ضربة المجداف في مياه ترعة هادئة. ينسل المماليك أول النهار. نبذوا البيوت. أيام ما بعد عيد الفطر. دائما يركب الخمول هذه الأيام التى تعقب الأعياد” (ص12. وهي أول صفحة من كلام الغيطانى). والقصته كلها تقريبا على هذه الوتيرة التى يبدو فيها الكلام كأنه مسبحة انفرطت حياتها. ثم يضاف إلى ذلك أنه يتحول فجأة وبلا مسوغ من الجمل الفعلية إلى الجمل الاسمية، ومن الجمل القصيرة إلى الجمل الطويلة، فيحس القارئ كأنه راكب سيارة مخلعة المفاصل عجلاتها من خشب، وتجرى على طريق وعر!
وأحيانا ما يتعمد الغيطاني الغموض يسربل به سرد الأحداث أو الوصف، وبخاصة عن طريق استخدام ضمير لا يعود على اسم سابق، وأحيانا يستخدم جملا مهشمة مثل: “وعند ما اشترى جارية” (ص171)، “لو خرج علينا طومنباي” (ص172)، “عبثا صفاء النفس” (ص173)، “حيرة أول العمر” (ص173)، إذ إن الجملة الأولى ينقصها متعلق الظرف، والثانية جملة جواب الشرط، والأخيرة خبر المبتدأ… وهكذا.
وهو مغرم فى بعض الأحيان بلغة الصوفية، مثل “العبر” و”المبتدأ والخبر” (ص119)، و”المثنى والمفرد. الناء المفتوحة نهاية النهاية” (ص139) و”المثنى والجمع. الأول والآخر” (ص184)، وأحيانا أخرى يستخدم عبارات مأخوذة من كتب تاريخ تلك العصور (فيما أتصور)، مثل: “اتكوا عليه فى الحديث” (ص125)، و”بلسان العثمانية” (ص125)، و”بصاص” و”بصاصة”، و”بلاليق من الحلوى” (ص127)، و”متشحطة” (ص163)، و”نتر فى وجوهنا” (ص164)” و”كاينة” (ص166)، و”موالس” (ص167)، و”ألا يخامروا عليه” (ص175).
ومع ذلك فإن أسلوب البصاصين فى تقاريرهم وأسلوب الزيني فى رسالته إلى زكريا راضى لا يشبه، فيما أحسب، أسلوب تلك الفترة. وإنى لأحسب أن عبارات مثل “عطن الدنيا” و “دورة مياه”، و”كنيران المجوس” و”بلا لف أو دوران” و”ربما ثار سؤال”، و”فكرة ليست سطحية”، و”النهار يطلع ليشيخ، ثم يعتصره الليل” لا تمت إلى أسلوب ذلك العصر بصلة.
والغيطانى يحاول أن يقلد نجيب محفوظ فى تهويماته الوجدية وذكره السوسن والعطر وما إلى ذلك، ولكن تبقى المسافة بينهما شاسعة شسوعا فلكيا حتى لتقاس بالسنين الضوئية التي يستحيل قطعها، فيبقى الغيطانى في الطين، ومحفوظ في أعلى عليين. كما نراه يكثر من الصور المتكلفة متصورا أن هذا الإكثار دليل على أنه مبدع كبير. ومن هذه الصور قوله:”أشرعوا سيوفهم فى وجه النهار المقبل” (ص12)، و” يخفت همس السائقين. يبقى فى أذهانهم انطباع خفيف كأثر ضربة المجداف في مياه ترعة هادئة” (ص12)، و”الأصوات تصل إلى هنا متسلخة” (ص13)، و “بهجة تمتد إلى روح سعيد، بطيئة كسريان ماء فى شقوق ضيقة” (ص18)، و”تعثر الهواء فى صدره وكبا” (ص36)، و”اليدان مذبوحتان” (ص144)، و”المآذن حروف لا معنى لها” (ص179)، و”يبقى السكون بلا خدش” (ص20. وانظر الصفحات 27، 28، 72، 185 حيث تكررت هذه الصورة مع بعض التحويرات). وهو ذو غرام بتتابع التشبيهات حتى لو لم يوجد بينها رابط نفسى أو مجالى، مثل: “تعلو الأسئلة وتنزل كعصا نقرزان. حلقات غليظة فى سلسلة حديدية ساخنة تلهب منه العصب. تسلّ النخاع. تجفف ماء الحياة” (ص16). فإذا أضفنا إلى هذا أن تلك اللغة ليست أبدا لغة عصر المماليك تبيَّن لنا حجم الداهية الثقيلة التي حطت على الكتاب.
والترادف عنده كثير لدرجة الإملال. وأخطاؤه اللغوية ليست بالقليلة، ومن ذلك: “لايعرف حقا أتدعى… أو لا” (ص67، والصواب: “أم لا”)، و”تنسال” (تنثال/ ص49، 171، 173)، و”ما أخشى إلا هو” (إلا إياه/ ص52، 71)، و”أو شرائه” (شراءه/ ص67)، وتأتى مع بعضها (يأتي بعضها مع بعضها/ ص120). و”يُظْلِم الروح” (بضم ياء المضارع. والصواب: “يجعلها تظلم” أو “يُشِيع فيها الظلام/ ص140)، و”البصاص الصفوة” (ص151)، و”توخز عينيه أسوار قلعة الجيل” (تخز/ ص16. وانظر كذلك ص162)، و”كلما كان الأمر كذا كلما كان كذا”، الذى تكرر في الرواية. وبطبيعة الحال لن يدرك الغيطانى ما أريد أن أقوله من خلال الإشارة إلى أخطائه هذه حتى لو شرحتها له تفصيلا، إذ لا علاقة له باللغة المستقيمة بحال. فلذلك لم أجد ما يجعلنى أُعَنِّى نفسى بشرح أى شىء منها سوى إيراد الصواب عقب الخطإ بين قوسين رغم أنني متيقن أنه لا فائدة بالنسبة له من وراء ما كتبتُ وصَوَّبْتُ، إذ يكفينى أننى قمت بواجبى. وبالمناسبة فإن أمثال الغيطاني ممن تفصل بينهم وبين صحة اللغة آماد وآماد تخضع كتاباتهم للتدقيق والتصويب قبل صدورها. أي أن تلك الأخطاء التى لا يمثل ما أوردته منها هنا سوى كسر صغير لا تعطينا صورة صحيحة عن مستوى الغيطاني، بل عن مستوى مصححيه، الذين لا شك أنهم قد عدلوا كثيرا جدا من عِوَج لغته. ولكن ماذا تعمل الماشطة في الشعر الذائب؟
وهو يكتب الحوار أحيانا بالعامية، وبخاصة عندما يكون قصيرا، ومن ذلك قوله: “السكون الغويط” (ص20)”لم يوزّه” (لم يحرضه/ ص21)، و”القُعَاد” (ص33). وأظن أن عبارة مثل “تسمح معانا” يصعب على الخيال تماما تصوُّر صدورها عن بصاص في ذلك الوقت في حديثه إلى من يريد القبض عليهم. كما أن الغيطاني كثيرا ما يورد حوارا دون أن يذكر بين مَنْ ومَنْ. فما فائدة مثل تلك الحوارات إذن؟
—————
أ. د. إبراهيم عوض
أستاذ النقد الأدبي والفكر الإسلامى بكلية الآداب، جامعة عين شمس