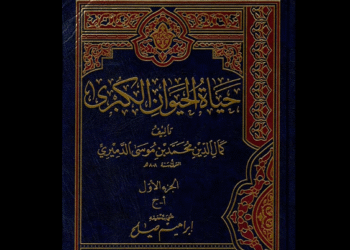في تاريخ المسرح العربي، يقف سعد الله ونوس شاهقًا كجبل تتكئ عليه الذاكرة الثقافية، ويمد الجمهور بجسور نحو وعيٍ جديد. في مسرحيته “الفيل يا ملك الزمان”، لم يكتب نصًا عابرًا، بل صاغ أيقونة رمزية تختصر مأساة الإنسان العربي في مواجهة السلطة المستبدة.
في بضعة مشاهد، رسم ونوس لوحة مكثفة، حيث يصبح “الفيل” استعارة لكل أشكال الظلم والقمع، ويغدو السكوت عليه جريمة مشتركة بين الحاكم والمحكوم.
نبذة عن المؤلف
سعد الله ونوس (1941–1997)، كاتب ومسرحي سوري وُلد في قرية حصين البحر قرب طرطوس. جمع بين حساسية الفنان ووعي المفكر، فحوّل المسرح إلى منبر سياسي وثقافي، لا منصة ترفيه فحسب.
من أعماله البارزة: حفلة سمر من أجل 5 حزيران، مغامرة رأس المملوك جابر، طقوس الإشارات والتحولات. عُرف بقدرته على تطويع الرمزية لتجاوز رقابة السلطة وإشعال أسئلة حارقة في أذهان الجمهور، مؤمنًا بأن “المسرح فعل تحريض وتغيير”.
ملخص المسرحية
تجري الأحداث في مملكة غامضة، يتسيّدها ملك قوي يتغنى بالعدل، لكن حياة الناس معطلة بسبب فيل ضخم يسيطر على الشوارع والأسواق، يلتهم أقواتهم، ويعكر صفو حياتهم. يحاول مواطن بسيط رفع شكواه إلى الملك، لكنه يواجه سلسلة من الحواجز: حاشية متملقة، بيروقراطية خانقة، وجدار من الخوف الذي يشلّ إرادة الناس. مع مرور الأحداث، يتضح أن الفيل ليس مجرد مخلوق، بل رمز شامل للظلم الممنهج، وأن بقاءه مرهون بصمت الشعب.
الرمزية في المسرحية
الفيل: تجسيد للاستبداد والهيمنة، قد يرمز للحاكم، أو للفساد، أو لأي قوة قهرية تحتل المشهد العام.
الملك: صورة للسلطة المطلقة التي تدّعي خدمة الشعب بينما هي غافلة أو متواطئة مع الظلم.
الحاشية والوزراء: أدوات السلطة التي تحجب الحقائق عن الحاكم وتعيد صياغة الواقع لخدمة بقائها.
المواطن البسيط: نموذج للإنسان الذي يحاول التغيير لكنه يواجه منظومة تبتلع صوته.
الجمهور/الشعب: كتلة صامتة، تُمثل الجماهير المستسلمة لواقعها، ما يتيح استمرار الاستبداد.
أهم المشاهد
1- المشهد الافتتاحي: عرض معاناة الناس مع الفيل، كاشفًا جو الخوف والقهر.
2- مشهد الشكوى: محاولة المواطن مواجهة الفيل عبر مخاطبة السلطة، لكنه يُساق في دوامة الروتين.
3- مشهد القصر: تتكشف آليات تزييف الحقائق أمام الملك، وتلميع الواقع المأزوم.
4- المشهد الختامي: إدراك أن الفيل باقٍ، وأن الصمت الشعبي يمنحه الشرعية.
أهمية المسرحية
نص تأسيسي في المسرح العربي السياسي، يجمع بين الرمزية والواقعية.
تشريح دقيق لعلاقة السلطة بالشعب، حيث الخوف واللامبالاة يصنعان الاستبداد.
دعوة إلى مواجهة الظلم قبل أن يتحول إلى “فيل” يملأ المكان ويشلّ الحياة.
النقد والتحليل
القوة الفنية: لغة مكثفة، رمزية شفافة، قدرة على طرح القضايا الكبرى بأبسط الصور.
العمق السياسي: النص يتجاوز إطار الحكاية إلى مساءلة البنية السياسية والاجتماعية التي تفرز الظلم.
الملاحظات النقدية: بعض النقاد رأوا أن وضوح الرمزية قد يختصر مساحة التأويل، لكنه جعل النص أكثر وصولًا للجمهور.
البعد الإنساني: المسرحية تصلح لأي زمان ومكان، فـ”الفيل” متجدد بأشكال مختلفة في التاريخ.
إسقاطات على الواقع العربي المعاصر
في كثير من البلدان العربية، ما زال “الفيل” حاضرًا، وإن تغيّر شكله من دكتاتور متصلب إلى منظومة فساد متجذرة، أو احتلال مقنّع، أو إعلام يضلل العقول. وما زال “الملك” الذي يعلن العدل بينما تظل يداه مشغولتين بحماية عرشه. أمّا الشعب، ففيه من يقاوم، وفيه من يلوذ بالصمت، تاركًا الفيل يمرح في الميادين.
المسرحية تُذكّر القارئ بأن الخوف أخطر من القهر، وأن التواطؤ بالصمت يُبقي الفيل سيد الميدان، مهما تغيّرت الأزمنة.
“الفيل يا ملك الزمان” ليست مجرد مسرحية قصيرة، بل صرخة في وجه الاستبداد، تحذّر من تحوّل المظالم إلى جزء من المشهد اليومي حتى يألفها الناس. سعد الله ونوس لم يكتب عن فيلٍ واحد، بل عن أفيال تتوالد ما دام هناك من يهاب مواجهتها. وفي عالم عربي مثقل بالصمت، يبقى السؤال مفتوحًا: من يجرؤ على إخراج الفيل من الميدان؟
—