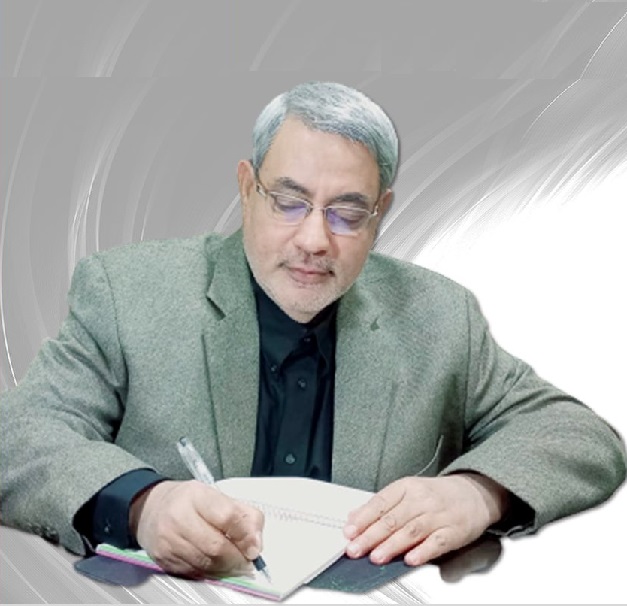في الوقت الذي تسجّل فيه الإحصاءات الأممية تحسناً طفيفاً في معدلات الجوع على مستوى العالم، يسير الشرق الأوسط في الاتجاه المعاكس، إذ تتعمق أزماته الغذائية بفعل النزاعات المسلحة، وأزمات العملات، والاعتماد المفرط على الواردات.
وبينما تنجح مناطق في آسيا وأفريقيا في تقليص نسب الجوع عبر النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، يجد ملايين السكان في دول مثل سوريا ولبنان واليمن وغزة أنفسهم أمام واقعٍ أكثر قسوة، حيث يصبح الغذاء شحيحاً، والقدرة على شرائه أبعد ما تكون عن المتناول.
بينما أظهرت الإحصاءات الأممية أن نسبة الجوع على مستوى العالم انخفضت قليلاً من 8.5% عام 2023 إلى 8.2% عام 2024، لم ينعكس هذا التراجع على الشرق الأوسط وغرب آسيا. بل على العكس، ارتفعت نسبة انتشار نقص التغذية لتصل إلى 12.7%، أي ما يعادل أكثر من 39 مليون إنسان.
يرجع هذا التباين إلى مجموعة من العوامل المركبة، تتصدرها النزاعات المسلحة، التي لا تزال تمزق دولاً مثل سوريا واليمن ولبنان، إضافة إلى المأساة الإنسانية في غزة.
ففي القطاع المحاصر، كشف تقييم مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة أن 98.5% من الأراضي الزراعية إما دُمّرت أو أصبحت غير قابلة للوصول،
وهو ما وضع أكثر من مليوني إنسان على حافة المجاعة. وقد حذرت تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن ربع سكان غزة يعيشون فعلياً ظروفاً أقرب إلى المجاعة.
إلى جانب الحروب، يلعب التضخم وأزمات العملة دوراً محورياً في حرمان الأسر من الاستفادة من انخفاض أسعار الغذاء عالمياً. ففي دول مثل لبنان والسودان ومصر، أدى انهيار العملات المحلية إلى تضاعف تكلفة الاستيراد، وهو ما جعل المواد الأساسية بعيدة المنال عن ملايين الأسر.
ويزيد من حدة الأزمة الاعتماد الكبير على الواردات، حيث إن المنطقة تستورد معظم احتياجاتها الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية. أي اضطراب عالمي، مثل جائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا، يترك بصماته مباشرة على أسعار وأسواق الغذاء المحلية.
أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فإن ضعف شبكات الحماية الاجتماعية مقارنةً بما هو قائم في جنوب وجنوب شرق آسيا، يجعل الشرائح الفقيرة أكثر عرضة للجوع وسوء التغذية.
وفي المقابل، تبقى بعض الدول الغنية في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، بمعزل عن هذه الأزمة نتيجة قدرتها المالية على تأمين الغذاء وتطوير أنظمة استيراد متينة. لكن الصورة الكبرى تكشف فجوة آخذة في الاتساع بين دول مستقرة وأخرى تعيش في دوامة أزمات مزمنة.
وهكذا، فإن التراجع في الأمن الغذائي بالشرق الأوسط ليس مجرد انعكاس لحرب أو أزمة محددة، بل هو نتيجة تراكمية لضعف البنى التحتية الزراعية، هشاشة الاقتصاد، والاضطرابات السياسية المستمرة.
وبينما يخطو العالم خطوات صغيرة نحو تقليص نسب الجوع، تبقى المنطقة أسيرة أزماتها، في مسارٍ معاكس للتحسن العالمي.
الاستثمار في الزراعة المحلية:
يرى خبراء “الفاو” أن تقوية الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استخدام التقنيات الحديثة (كالزراعة المائية والزراعة الرأسية) قد يخفف من اعتماد المنطقة على الواردات.
إدارة أفضل للموارد المائية:
يشير خبراء في قضايا المياه إلى أن ندرة المياه هي أكبر تحدٍ زراعي، وبالتالي فإن تطوير تقنيات الري الموفّرة للمياه وإعادة استخدام المياه المعالجة أصبح ضرورة ملحّة.
تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية:
يقترح خبراء التغذية توسيع برامج الدعم الغذائي المباشر، مثل القسائم الغذائية والتحويلات النقدية، لحماية الفئات الأكثر هشاشة من آثار التضخم.
التعاون الإقليمي:
دعا اقتصاديون إلى إقامة شبكات إمداد غذائي مشتركة بين دول المنطقة، بما يقلل من تعرضها للصدمات العالمية ويعزز الأمن الغذائي الجماعي.
حل النزاعات:
أجمع الخبراء على أن معالجة الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة تبقى المدخل الأساسي لأي تحسن دائم في الأمن الغذائي، فبدون الاستقرار لن تنجح أي حلول اقتصادية أو زراعية.