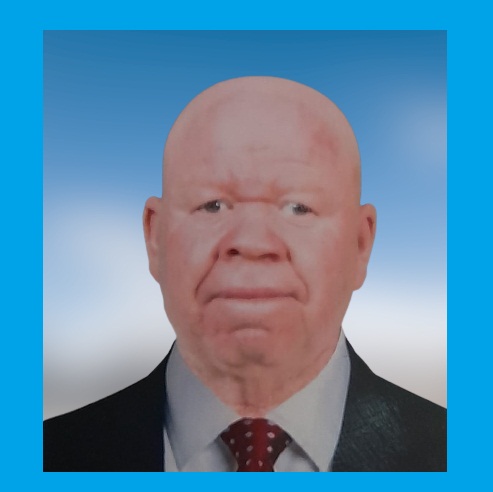عواطفنا بوصلة اتجاه صادقة، فنرسل الشارات كدلالة واضحة لما تحمله القلوب من مشاعر اتجاه الرسالة، لهذا لا نستهين بتلك التعابير أن نمنحها لمستحقيها، وأن نحسن قراءتها إذا وردت إلينا.
تمثل العواطف في حياتنا الشيء الكثير، علينا أن نعطيها اهتماما بالغا، فهي تشكل جسر عبور لعالم النفوس، فمن لم يرعها ويعرف معانيها، فإنه في الحقيقة أرعن مغلق، كمن يرى الورود والرياحين ولا تهزه عبيرها، أو كمن يجلس في بقعة نتنة ولكن لا يدرك نتانة ريحها، وكذلك العواطف، لها مجستها التي نقيس بها تعابير المشاعر والعواطف المرسلة.
في تعاملنا الحياتية نكتشف أن لغة العواطف معدومة عند البعض، فيعامل الناس بلا أحاسيس، يعامل الناس مثل آلة صماء، فإن مدت اليد، مدت باردة بلا روح، وإن استقبل فكلح الوجه سيد الميدان، فإن حاول وسامر بلغة الأمر والنهي، يصدر الأوامر بنبرات فوقية، جفاء في جفاء.
إن حياة يغيب فيها الذوق والملاطفة، حياة فاقدة لمعناها، لهذا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي البعد العاطفي في المعاملة حقه، فيوظف لغة العواطف، فجعل من الهدية طريق للقلوب، كما يحبب إفشاء السلام عند التلاقي، وهو باب مشرع لتوليد المحبة بين الناس، كما يحبب إلينا التزاور والعيادة لترطيب العلاقات وهي وسائل كثيرة
والجهل بأسلوب لغة المشاعر يولد تجافي القلوب بين الناس، فإذا كانت النفوس تنشرح بالطائف والمشاعر الراقية، فإنها تتأذى كذلك بسلوكيات جفاف العواطف، لهذا كان الإسلام مهتما بثقافة نشر القيم الروحية بزرع الفضائل وأخلاق المشاعر بين أتباعه، حماية وصيانة البنيان المجتمعي من التصدع والانهيار، فحرم الحسد والتباغض والغيبة والنميمة، وحرم الكبر والتعالي، وحرم التنابز والمفاخرة، وحرم إذاية اللسان واليد، وجميع ما ذكرت قواهم تهدم البعد العاطفي.
في خلاصة المقال نؤكد على أهمية توظيف لغة العواطف في الواصل المجتمعي أو الوظيفي أو التعليمي، فلا نقلل من شأنها، فكلماتنا الطيبة تبني جسورا التواصل الإيجابي، كلغة الجسد التي نوظفها في تواصلنا، كالتحية والمصافحة، والبشاشة والتبسم، أدوات قوية تدعم العلاقات الإنسانية بين المجتمع، لهذا علينا أن نرقي من أساليب تعاملنا بتوظيف الذوقيات الراقية في التعامل.