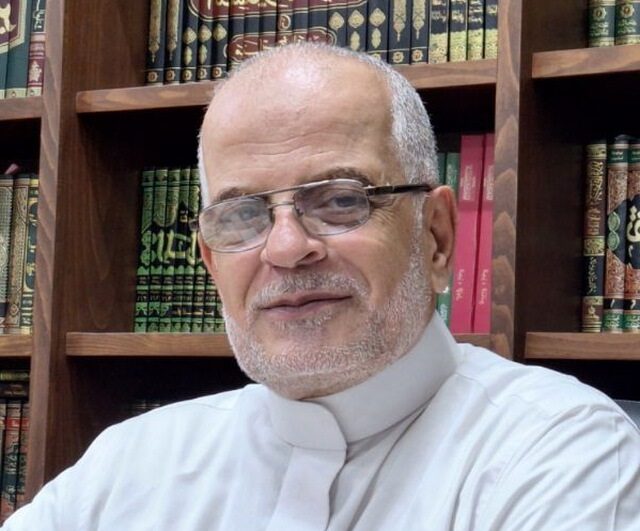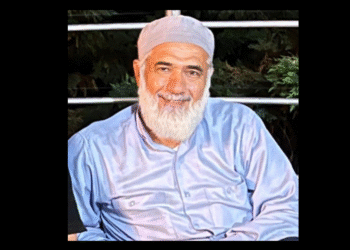جعل الله قتل النفس جريمة كبرى تعادل الشرك به، وتوعد قاتلها بالخلود في النار: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾، وجعل من قتل نفسا واحدة ظلما وعدوانا كمن قتل الإنسانية كلها: ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾، ولم يغتفر الإسلام هذه الجريمة في الحكم الدنيوي، حتى اختلف العلماء في تحريم الصلاة على من قتل نفسه، فضلا عمن قتل غيره ظلما وعدوانا، وجعل الله لولي المقتول سلطانا لا ينازع فيه بالقصاص ممن قتل وليه: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾.
والعداء بين ولي المقتول والقاتل عداء غريزي طبعي لم يبطله الإسلام ولم يعسف النفس البشرية فيه على خلاف طبعها وغريزتها بل شرع القصاص والدية أو العفو لمعالجة آثاره.
وهذا المعيار الشرعي معيار أخلاقي يعلي من قيمة النفس الإنسانية نفسها ويجعل لها حرمة ذاتية بقطع النظر عن فئتها وأهميتها، ومكانتها، ومكانة قاتلها الاجتماعية، أو السياسية، شريفا أو وضيعا، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، رئيسا أو مرؤوسا، مسلما أو كافرا.
وكذا جعل القرآن إخراج الإنسان من وطنه وأرضه وأهله والإعانة على ذلك كقتله، وشرع القتال في سبيل الله لكلا الأمرين ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم﴾.
ولهذا كما شرع الله لأهل غزة قتال عدوهم الذي قاتلهم ظلما وعدوانا وأخرجهم من أرضهم وديارهم وأعان عدوهم على إخراجهم، فكذلك شرع لأهل #سوريا في (ردع العدوان) ما شرعه لأهل غزة في (معركة الطوفان)، فالمعيار الشرعي والأخلاقي الذي قرر لأهل غزة هذا الحق، قرر لغيرهم مثله سواء بسواء، فالدعوة إلى إبطال أو تأجيل حق الشعب السوري أو العراقي أو اليمني بالقصاص من عدوهم الذي قتلهم وأخرجهم من أرضهم وديارهم، وأعان المحتل الأمريكي والروسي عليهم -وما يزال عدوانه قائما لم تزل آثاره، ولم تجف دماؤه، وما زالوا مهجرين من أرضهم- بدعوى الدفاع عن غزة؛ دعوة تنقض المعيار الأخلاقي والشرعي والفطري الطبيعي!
وكما لم يغتفر الدعاة لهذا التأجيل أو التعطيل دماء قتلى رابعة والنهضة في مصر، فلا يتصور أن يغتفر أهل الشام والعراق واليمن دماء ملايين القتلى والمهجرين من أرضهم وديارهم -حتى لم يبق أهل بيت في هذه البلدان وإلا فيهم قتيل وجريح أو مهجر- مهما كان الشعار المرفوع لهذه الدعوة التي تصطدم بالفطرة الإنسانية فضلا عن الأحكام القرآنية!
ولهذا صمّت الأمة وشعوبها آذانها بفطرتها وغريزتها عن هذه الدعوة التي حاولت الربط بين الوقوف مع أهل غزة ضد العدوان الصهيوني، وتأجيل الوقوف مع أهل الشام والعراق واليمن ضد العدوان الإيراني عليهم! بدعوى مواجهة العدو المشترك! أو أن هناك عدوا أشد من عدو وأحق بالمقاومة منه! وكأن العدو لا يكون إلا صهيونيا، وكأن المقاومة لا تكون إلا له! ولا أن الأعداء يحيطون بالأمة وشعوبها من كل حدب وصوب، كما أخبر النبي ﷺ: (تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها)!
لقد حاول الدعاة لهذه القضية إقناع الأمة بكل حجة حتى علل بعضهم هذا الامتناع عن قبول دعوتهم بالخلاف المذهبي والصراع الطائفي! وحتى استدعوا التاريخ وقصصه والشرع ونصوصه وتجاهلوا العدوان الإيراني الواقع الآن على هذه الشعوب وما يزال، وكأن الخلاف في الماضي الزائل لا الحاضر الماثل! مع أن هذه الشعوب نفسها وقفت عبر تاريخها مع كل من قاوم عدوها دون نظر إلى مذهبه وطائفته، فمن اعتدى عليها ظلما وعدوانا، وأعان عدوها عليها، كما فعل من أعان نظام الأسد والمحتل الروسي في سوريا، ومن أعان حكومة بريمر والمحتل الأمريكي في العراق، لم تشفع له مقاومته، وكان كمن أعان نتنياهو والمحتل الصهيوني على أهل غزة وفلسطين سواء بسواء، والتفريق بين العدوين، أو الاعتداءين ضرب من المكابرة عجزت عن تبريره وتمريره أقلام دعاة التفريق بين الأمرين!
وتحديد العدو من الصديق لا يقرره المفكرون ولا السياسيون ولا الكتاب بل دماء الشعوب نفسها بغريزتها الفطرية فمن اعتدى عليها فهو عدوها، وإن كان من جنسها ودينها، ومن أحسن إليها كان صديقها وإن كان أجنبيا عنها.
والأمة وشعوبها اليوم ليست في حاجة لاستدعاء التاريخ وكلام الأئمة لتجاوز الخلاف الطائفي بقدر حاجتها لدفع العدوان عنها سواء كان المعتدي عليها المحتل الصهيوني أو الإيراني الطائفي أو النظام العربي الوظيفي.
ولا يتصور الوقوف مع الربيع العربي وحق شعوبه في الحرية والعيش الكريم في أوطانها والوقوف في الوقت ذاته مع من قاتلها وارتد وأعان العدو المحتل على قتالها واحتلالها ليظل يحكمها طغاتها وأكابر مجرميها تحت شعار المقاومة أو المصلحة!
وإذا جاز مثل ذلك فقد جاز من باب أولى الوقوف مع عسكر مصر وأشباههم فهم أقل فتكا وإجراما من عصابات بشار والحوثي والخزعلي!