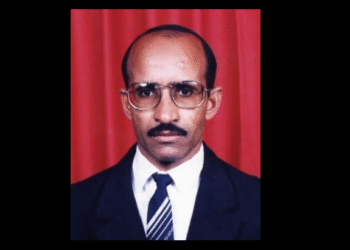الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونواصل الحديث عن (الغايات القرآنية) تكملة لما بدأناه في الحلقة الماضية عن مفهوم الغايات عامة ومفهوم الغايات في القرآن الكريم وقد تحدثنا عن المقاصد الكلية الكبرى التي وجد علماء الشريعة عامة، والذين كتبوا عن علم المقاصد خاصة، حيث عددوا خمسة مقاصد كبرى، تسعى الشريعة بأحكامها التفصيلية وبجزيئاتها لترسيخها وأن الإنسان المكلف يخدم المقاصد الكلية ويعمل على رعايتها في الجزئيات والكليات ليحقق مقصد الاستخلاف والعمران في الأرض، وليكون عابدًا لله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح وينتهي به الأمر في نهاية المطاف لتحقيق رضوان الله تعالى ودخول جنته وهي غاية الغايات ومنتهى الإرادات.
والمقاصد الخمسة التي ذكرت في الحلقة الماضية وأوجبت الشريعة المحافظة عليها هي: (الدين / النفس/ العقل / النسل / المال) تعتبر غايات دُنْيا بالنسبة لما فوقها من الغايات الكبرى و هي غاية التعبد المطلق لله تعالى، وغاية الاستخلاف والعمران في الأرض و غاية رضوان الله تعالى ودخول جنته .
وتتحقق الغايات الكبرى إذا حققنا الغايات التي دونها، فهذه أهداف بالنسبة للغايات الكبرى، ولكنها غايات بالنسبة لما دونها وأهداف بالنسبة لما تحتها من وسائل، وأحكام تشريعية.
وقد أمر الله سبحانه وتعالى في شريعته بالإيمان به وتحقيق التوحيد ونفي الشرك والابتعاد عنه وترك الكفر، والتكذيب والعناد، وأمر بالصلاة والزكاة والصيام وهذه التكاليف العلمية الخبرية والعملية الشعائرية في حقيقتها تحافظ على مقصد الدين، وهذا ما يسمى بإقامة الدين، الوارد في قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحࣰا وَٱلَّذِیۤ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡكَ وَمَا وَصَّیۡنَا بِهِۦۤ إِبۡرَ ٰهِیمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰۤۖ أَنۡ أَقِیمُوا۟ ٱلدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِیهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِینَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَیۡهِۚ ٱللَّهُ یَجۡتَبِیۤ إِلَیۡهِ مَن یَشَاۤءُ وَیَهۡدِیۤ إِلَیۡهِ مَن یُنِیبُ}الشورى/13.
فالله سبحانه وتعالى شرع جملة الشعائر التعبدية بهيئاتها وأركانها وواجباتها وسننها إقامة للدين وحفاظا عليه باعتباره المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة.
والكليات الخمس راعتها الشريعة من حيث الوجود كما راعتها من حيث العدم -كما فصل ذلك العلامة الشاطبي في كتابه الموافقات-، بمعنى هنالك جملة من الأحكام الشرعية تؤدي إلى إقامتها، وهناك العديد من الأحكام الشرعية تؤدي إلى عدم انهيارها وانتهائها ونقصانها وتلاشيها.
وهذه مسألة غاية في الأهمية، فالشريعة عندما تأمر بشيء فإنها تفصل وتبين ما يقيمه ويحفظه ويرعاه فقد أمر الشارع بالصلاة، في قوله تعالى: {وَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّ اكِعِینَ } البقرة/43 وجاء الأمر بها في كثير من النصوص وبصيغ عديدة بيانا لأحكامها وتوضيحا لمنزلتها ومكانتها وحثا وتحفيزا عليها وبين عاقبة المقيمين لها والمحافظين عليها في الدنيا والآخرة ( رعاية الوجود ) كما نهى عن تركها وإضاعتها ، وبين عواقب ذلك وحكمه في جملة من الأدلة (الحماية من العدم) قال تعالى: {فَوَیۡلࣱ لِّلۡمُصَلِّینَ * ٱلَّذِینَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ}الماعون/4-5 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) الترمذي و النسائي وأحمد وخلاصة القول فقد أحاط الشارع هذه الشعيرة بجملة من الأحكام المتعلقة بالديانة وروادع الإيمان كما أحاطها بجملة من الإجراءات التشريعية والقانونية التي تجعل من هذه الشعيرة التعبدية قائمة، ولا يتم الاعتداء عليها ولا على مواقع إقامتها وذلك بصيانة المساجد وترك العدوان عليها بمنعها من عمارها والسعي في خرابها والتضييق على أهلها وروادها والتحكم فيها لتكون منابر تسبح بحمد الطغاة والمجرمين فتخرج بذلك عن وظيفتها الأساسية وهكذا الأمر في كافة الأركان التعبدية الشعائرية في إقامتها وحراستها وجودا وعدما فهناك جملة من الشرائع تؤدي إلى إقامة الشيء وجملة من الشرائع تؤدي الى الحيلولة دون أن يكون هذا الشيء ناقصًا أو مهدومًا.
والمقصد الثاني من المقاصد الكلية للشريعة هو مقصد (حفظ النفس)، فالله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على النفس البشرية منذ نشأتها الأولى وحتى مفارقتها الحياة الدنيا، وذلك بالحفاظ عليها ابتداء من خلال مراعاة حاجات الجسد وضروراته بعد وجوده من خلال التناسل والتزاوج المشروع، حيث يحتاج إلى الطعام و الشراب والكساء والسكن و ما يقوم به الجسد عامة ليكون حيا وموجودا ، وبطبيعة الحال يتطلب ذلك الضرب في الأرض لاكتساب المعاش وحصول الأرزاق وتوفير سبل العيش الكريم كما يتطلب في جانب الحماية من العدم تحريم قتل النفس البشرية أو التعرض لها بما يؤذيها ويخل بوجودها كمنعها من الطعام والشراب وتعرضها للأمراض وترك العلاج وزيادة في الحماية من العدم شرعت أحكام القصاص لأنها تحقق الحياة للناس بمنعهم من التجرؤ والاقتحام على قتل النفوس أو التعدي عليها قال تعالى ﴿وَلَكُمۡ فِی ٱلۡقِصَاصِ حَیَوٰةࣱ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ البقرة/179
وهذا التوازن البديع في الأحكام الشرعية التي تحرص على وجود النفس البشرية والحفاظ عليها ومنعها من الزوال والعدم ينسجم مع عناية الله تعالى بالنفس ابتداء من الخلق والتكوين والإيجاد ثم العناية والرعاية بعد تشكلاتها الباطنية وظهورها الخارجي ثم عمليات الإمداد المستمر طوال الحياة تدبيرا من الرحمن الرحيم بلا انقطاع وتتجلى في كل ذلك (إيجادا وإعدادا ورعاية وإمدادا) أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله جل جلاله.
ومن المقاصد والكليات الكبرى في الشريعة الإسلامية (حفظ العقول) وحمايتها لأن عليها مدار التكليف لأن فاقد العقل أو المجنون لا يعتبر مكلفا بل مرفوع عنه القلم كما نصت على ذلك الشريعة التي تقيم للعقل وزنا ولا تهدره أو تغيبه أو تهمشه كما هو الحاصل في واقع المسلمين اليوم حيث يعاني العقل ضمورا وغيابا للفاعلية والإبداع بل الصورة الذهنية التي يشكلها الخطاب الدعوي هو ذم العقل وتعطيله مع أن الشريعة تقوم في مجمل أدلتها الشرعية على المنقول والمعقول ويحاسب الإنسان على تعطيل أي منهما قال تعالى ﴿وَقَالُوا۟ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِیۤ أَصۡحَـٰبِ ٱلسَّعِیرِ﴾ الملك/10 والمطلوب من السمع والعقل والبصر الوصول إلى الحقائق المجردة وبناء العقل المسلم الذي يدور مع الحقيقة لا الوهم واعتبار الحقائق آيات دالة على الله تعالى وهو الحق جل جلاله وهو منتهى العلوم والإرادات والحقائق.
وقد جاءت الشريعة لحماية العقول وحفظها وسلامتها بتقرير حقائق الغيب و الوجود حتى لا ينشأ الإنسان في الأوهام، والوهم في حقيقته خروج عن دائرة اليقين إلى دوائر الظنون والأوهام المسببة للضلال عبر الشبهات وكم من أوهام يعيشها الإنسان وهو يظنها حقائق كأوهام النشأة والتربية وأوهام الحزبية والجماعة والقبيلة وأوهام المجتمع والوطن، وأوهام العلوم الخاطئة وكلها تؤثر في بنية العقل وتخرجه عن الحق والصواب وهذا مناقض لحفظ العقول وسلامتها والذي جاءت به الشريعة في أحكامها التي تؤسس لليقين عبر البراهين القاطعة الساطعة قال تعالى: ﴿قُلۡ هَاتُوا۟ بُرۡهَـٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ﴾ البقرة /١١١ ووردت العديد من الآيات تحث على التعقل وتجعله غاية من غايات الشريعة بعبارة{لعلهم- لعلكم /يعقلون- تعقلون} ولا يمكن للتعقل أن يكون صحيحا إلا إذا قام على الحقائق اليقينية بعيدا عن الظنون الوهمية كما هو حال الضالين من أهل الباطل الذين حكى القرآن مقولتهم في قوله تعالى:﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنࣰّا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَیۡقِنِینَ﴾ الجاثية /٣٢
وخلاصة القول فالبراهين العقلية والنقلية كلها تؤدي إلى اليقين المطلوب ولا تصادم بعضها بعضا إذا كانت قطعية وبالتالي لا مجال لصراع العقل والنقل لأن الشريعة ما جاءت بمحالات العقول بل جعلت النقل الصحيح موافقا للعقل الصريح .
و المحافظة على العقول كما تكون بمعرفة الحقائق المجردة والعلوم النافعة كذلك تكون من خلال تحريم وتجريم ما يعطلها أو يضلها عن طريق العلوم الفاسدة والأوهام والظنون والنظريات الباطلة والسحر والشعوذة أو ما يمنع فاعليتها الطبيعية في التفكير الموضوعي والتعقل الراشد كشرب الخمر وتعاطي المخدرات وغيرها من المغيبات المادية أو المعنوية كل ذلك حراسة للعقل (وجودا وعدما) لأداء وظيفته الأساسية في التعقل والتفكر في آيات الله في الخلق والأمر قال تعالى {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} البقرة/ 164وقال تعالى ﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ﴾ النساء /٨٢ .
وحماية للعقل من العدم وغياب الفاعلية فقد شرع الله تعالى عقوبة الجلد لشارب الخمر زجرا له عن تعاطيها وقد تواترت النصوص الشرعية الناهية والزاجرة عن الخمر شربا وبيعا وشراءً وتداولا ومن ذلك قوله تعالى﴿ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ أَن یُوقِعَ بَیۡنَكُمُ ٱلۡعَدَ ٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاۤءَ فِی ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ وَیَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ المائدة /٩١.
ومن المقاصد الكبرى التي حرصت الشريعة على رعايتها وحمايتها مقصد (حفظ النسل) وهو مقصد له علاقة باستمرار النسل البشري وبقائه لأداء رسالته الاستخلافية في العبادة والعمران وقد نظمت الشريعة طبيعة ونوع هذا البقاء وكيفية إشباع العلاقات الإنسانية الغريزية وما المشروع منها والمحرم ، ومن ذلك أحكام الزواج والنكاح من مصاهرة ومحرمية ورضاعة ونسب ونفقة وميراث وعشرة زوجية وقضايا الطلاق وغيرها من أحكام الأسرة وكذلك تحريم الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن ومقدماتها من النظر المحرم والخلوات غير المشروعة وهي تشتمل على الأحكام المتعلقة بوجود النسل البشري على أسس شرعية صحيحة والخروج عن العلاقات البهيمية الحيوانية غير المنضبطة ومنع كافة السبل المؤدية لقطع النسل البشري بسلوك الظواهر والعلاقات المانعة من الإنجاب كقتل الأجنة في بطون أمهاتها أو قتلها بعد ميلادها أو بناء علاقات غير سوية لا تثمر نسلا كما هي ظواهر المثلية الجنسية في واقعنا المعاصر , و نجمل مقاصد النكاح في -التناسل والتراحم والمودة- وهذه تنافي كثيرا من العقود الفاسدة كحرمة تزوج المرأة على خالتها أو عمتها وهو المشار إلى حكمته في قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان .
ويعتبر الإسلام بناء الأسرة مقصدا شرعيا تبنى عليه بقية الهياكل المؤسسية في المجتمع وتترتب عليه الكثير من الحقوق والواجبات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وحماية للنسل البشري بوجهه المشروع فقد شرعت الأحكام الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالتعدي على الحرمات بارتكاب الفواحش فشرع الجلد والرجم والنفي والتغريب وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد صانت هذا المقصد من حيث الوجود والعدم.
ونختم هذه الكليات الخمس من مقاصد الشريعة الكبرى بمقصد (حفظ المال) ويتفق الجميع على أهمية المال لقضاء الحوائج البشرية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغيره من الضرورات والحاجيات والكماليات التي تتعلق بالحياة بمختلف ضروبها ولما كان للمال هذه القيمة في الحياة البشرية فقد حرصت الشريعة في أحكامها على رعاية هذا المقصد فحددت الأعيان التي تصلح أن تكون مالا كالذهب والفضة والأنعام والزروع وثمارها والعقارات والمنقولات كما حددت المكاسب والأعمال التي ينتج عنها أموالا كالتجارة والرعي والمهن المختلفة ووردت تفاصيل تشريعية عديدة في ذلك رعاية للمال ووجوده كما حددت المحرمات والمنهيات في كل ذلك ، كتحريم الربا وأكمل أموال اليتامى ظلما والبيوع المحرمة كبيع ما لا يعد مالا من الناحية الشرعية كالخنزير والخمر والدم وغيره كل ذلك رعاية للمال ووجوده المشروع ، وأما من حيث العدم فقد منعت الشريعة التبذير والإسراف والسرقات والغصب وكافة أشكال العدوان على الأموال كما رتبت عقوبة صارمة على السرقة لأنها عدوان على المال بوجه غير مشروع فجعلت قطع يد السارق حدا من الحدود التي يلتزم بها المجتمع المسلم عند العدوان على المال بالسرقة قال تعالى ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوۤا۟ أَیۡدِیَهُمَا جَزَاۤءَۢ بِمَا كَسَبَا﴾ المائدة / ٣٨.
وخلاصة القول فإن أحكام المعاملات المالية التي حفلت بها الشريعة الإسلامية يراد منها حماية مقصد حفظ المال من حيث الوجود والعدم لأن المال عصب الحياة وقوامها .
ومن خلال استقراء نصوص الشريعة تم ترتيب هذه الكليات الخمس من حيث أهميتها ومكانتها في سلم الأولويات الشرعية فكانت على النحو التالي:
1/ الدين 2/ النفس3/ العقل4/ النسل 5/ المال
وهذا الترتيب محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا فقد قدّم الإمام الشاطبي حفظ المال على حفظ العقل في كتابه الموافقات، وأمّا الإمام الغزالي فقد قدّم العقل على النسل والمال وهو الترتيب الذي سبق ذكره، كما أنّ بعض العلماء يُقدّم النفس على الدين، وقال بعض أهل العلم إنّ القضية اعتبارية وكل واقعة تفرض ما كان حفظه أكثر أهمية من الآخر بحسب الظروف القائمة وهذا الترتيب يتم مراعاته عند التزاحم والتعارض والموازنات وترتيب الأولويات الخاصة والعامة ويراعي في ذلك كله بأن الكليات الخمس فيها ما هو ضروري وهو ما لابد منه لقيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين ، ومنها ما هو حاجي وهو ما كان مفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، ومنها ما هو تحسيني وهو ما يليق بمحاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق كما فصله العلامة الشاطبي في كتاب الموافقات.
والخلاصة فإن مقاصد الشريعة الكلية التي يجب حفظها ورعايتها من حيث الوجود وحمايتها وحراستها من العدم هي: (الدين/ النفس/ العقل/ النسل / المال) ولها تراتبها الأولوي عند التزاحم فيما بينها والضرورات في كل مقصد من المقاصد الكلية مقدمة على الحاجيات والتحسينيات وهو علم واسع لمن تبحر فيه وخبر دروبه ومسالكه.
ولئن كانت هذه هي الغايات الكلية للشريعة ونص عليها علماء الإسلام من خلال الاستقراء فما الذي نعنيه بالغايات القرآنية في حديثنا وبحثنا؟
الذي نسعى لشرحه وبلورته وإظهاره من خلال هذه المقالات هو ما جاء في السياقات القرآنية بعد حرف
(لعل) مثل قوله تعالى: (لعلكم تتقون) الموحي للعلة والغاية كما ذهب إليه البعض ومنهم العلامة ابن قيم الجوزية – رحمه الله – عند حديثه عن التعليل حيث قال: (وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبمجموعهما تارة، وبكي تارة، ومن أجل تارة، وترتيب الجزاء على الشرط تارة ، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة، وبلمّا تارة، وبإنّ المشددة تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول له تارة) إعلام الموقعين: 1/254)
وقال الدكتور أشرف إبراهيم عبدالله في مقالة له بعنوان – أدوات التعليل وأثرها في إثبات علية الحكم عند الأصوليين: (وقد اضطرَب كلام العلماء في (لعلَّ) الواقعة في كلام الله – تعالى – فقال بعض العلماء: معنى (لعلَّ) التعليل، فمعنى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ آل عمران: 132: لتُرحَموا، ومعنى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة: 63: لتتَّقوا، ومعنى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ آل عمران: 130: لتُفلحوا، ومعنى: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ البقرة: 53: لتهتدوا، ومعنى: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾ البقرة: 52: لتشكروا، لكنَّ هذا القولَ لا يستقيم في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ الشورى: 17؛ لأنَّه لا معنى فيه للتعليل.
وقيل: إنَّ (لَعَلَّ) تُفيد تحقيق مضمون الجملة التي بعدها ووقوعه، نحو قولك: لَعَلَّ المجتهدَ ينجحُ، ولا يستقيم ذلك في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ هود: 12؛ لأنَّ ترْكَ بعض ما يوحى إلى النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – غيرُ ممكنٍ عقلاً وشرعًا؛ لكونه معصومًا، وقوله -جلَّ جلاله- لموسى وهارون -عليهما وعلى نبيِّنا أفضل الصلاة والسلام- حين أرسَلهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ طه: 44؛ لأنَّه لَم يحصل من فرعون تذكُّرٌ، وأمَّا قوله -جل جلاله- حكاية عن فرعون: ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ يونس: 90، فتوبةُ يأسٍ لَم تُقبل، ولو حصَل منه تذكُّرٌ حقيقيٌّ، لَقُبِلَ منه هذا القول.
وقال سيبويه: إنَّ معنى (لعلَّ) في القرآن الكريم هو الترجِّي أو الإشفاق باعتبار حال المخاطبين، فهما متعلقان بهم؛ لأنَّ الأصل ألاَّ تخرج الكلمةُ عن معناها بالكلية، فـ(لعلَّ) منه تعالى حملٌ لنا على أن نترجى أو نشفقَ، وحَثٌّ لنا على ذلك، كما أنَّ (أو) المفيدة للشك إذا وقعَت في كلامه تعالى، كانت للتشكيك أو الإبهام على السامع، لا للشكِّ، تعالى الله عن ذلك.
وأرى أنَّ (لَعَلَّ) قد جاءَت في مواضع متعددةٍ من كلام الله -تعالى- وتنوَّعت معانيها تَمَشِّيًا مع سياق الآيات الكريمة، فلا ضيرَ إنْ حُمِلَت في بعض الآيات على معنًى من المعاني المذكورة دون غيره، متى اقتضى السياقُ القرآني ذلك.
أمَّا الوقوف عند معنًى واحدٍ منها فقط، وعدم قَبول غيره، فهذا ما لا أرتضيه، ولا أقبله البتةَ؛ لأنه يُوقعُ في خطأ كبيرٍ، وإثمٍ عظيمٍ.) وقد نقلت كلامه مطولا -وبتصرف يسير- لأهميته في حديثنا عن الغايات القرآنية من خلال حرف التعليل (لعل) في كتاب الله تعالى وتتبع تلك المفردة وما بعدها للوقوف على الغايات التي توخاها الشارع بعد حرف التعليل المذكور وهذه تحتاج جمع وترتيب ومعرفة لأنها غايات أشار إليها الشارع بصورة مباشرة لتكون هدايات للمكلفين في سعيهم الدؤوب وقد استوعب الكتاب العزيز جملة من هذه الغايات.