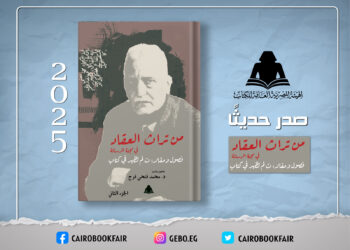حين دخلت السجن أول مرة (2014) شُغِلتُ بالقرآن الكريم. شُغِلتُ بالتلاوة، والحفظ، والقيام به ليلًا. وجُلنا يُقبل على ربه حال البلاء. كنت أحاول أن أقوم بألف آية كل ليلة، ولم أستطع، وجرّني هذا للتأمل في السور والآيات، بحثًا عن السور ذات الآيات الأكثر عددًا، مثل ﴿الحجر﴾، و﴿الشعراء﴾، و ﴿الصافات﴾، و ﴿ص﴾، و ﴿الدخان﴾، وعامة المفصل [من ﴿ق﴾ إلى ﴿الناس﴾].. حيلة العاجز الذي يبحث عن هدف ثمين بجهد قليل، وربنا كريم منان يعطي الكثير على القليل. وفي كل مرة كنت أتأمل فيها في الآيات والسور ظهر لي بوضوح شديد: أن لا اضطراد في أي من ظواهر القرآن الكريم. بمعنى أنك لا تستطيع أن ترسم أنماطًا محددة لكثير من ظواهر القرآن الكريم اللفظية أو البلاغية.. هكذا ظهر الأمر لي ابتداءً، فماذا وراء لو نظرنا من ناحية ترتيب السور، فلا نستطيع أن نقول أنها رتبت على حسب الطول: الأطول فالأقل طولًا، وهكذا. نعم من حيث السياق العام يمكن أن نقول هذا، ولكن في التفاصيل يوجد استثناءات، واستثناءات كثيرة موزعة على المصحف، مثل سورة ﴿الأنفال﴾، فهي أقصر من التي قبلها والتي بعدها، وسورة ﴿النحل﴾ فهي أطول من التي قبلها والتي بعدها، و﴿الفرقان﴾ فهي أقصر من التي قبلها والتي بعدها، و﴿الشعراء﴾ أطول من التي قبلها والتي بعدها، و ﴿الأحزاب﴾ و ﴿الفتح﴾… إلى ﴿البينة﴾.
وإذا نظرنا من ناحية تاريخ النزول، [مع الأخذ في الاعتبار أن القرآن الكريم لم ينزل سورًا كاملة إلا قليلًا، وبعض السور التي نزلت جملة، كـالأنعام، فيها بعض الآيات التي لحقت بالسورة الكريمة بعد سنين من نزولها، بل إن عشرات من السور مختلف في مكان نزولها حتى قال بعضهم بتكرار النزول]، سنجد أن السور لم ترتب حسب النزول؛ لكن ثمة سياق عام، وهو أن عامة القرآن المدني بجوار بعضه في ثلاث فقرات، وفي كل فقرة استثناءات: السبع الطوال عدا ﴿الأنعام﴾ مدنية، ثم تجد ﴿النور﴾ منفردة، وكذلك ﴿الأحزاب﴾، ثم ﴿محمد﴾، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمدٍ وآله وصحبه، و ﴿والفتح﴾، ومن سورة ﴿الحديد﴾ إلى سورة ﴿الملك﴾ سور مدنية مجتمعة مع بعضها في وسط السور المكية، ثم سورة ﴿النصر﴾ منفردة بين السور المكية كأنها منهن. عجّل الله بالنصر لأوليائه. فهنا (الترتيب حسب مكان النزول [مكي، ومدني]) تستطيع أن تتحدث عن سياق عام وهو أن الطوال مدنية والمفصل مكي، ولكن هذا السياق به استثناءات، واستثناءات كثيرة. تمامًا كما في الترتيب من حيث طول السورة.
وإذا نظرنا من ناحة عدد آيات السور، نجد أن عدد الآيات لا يأخذ نمطًا محددًا، بمعنى لا ينتهي عند رقم ثابت دائمًا، بل تجد تنوعًا لا تستطيع معه أن تضع نمطًا محددًا للترقيم فلا تستطيع أن تقول أن العدد يقف عند رقم ثابت (10، 20، 30، 100، 200)، فكثير من السور تنتهي قبل الرقم الثابت بقليل، ومثلًا: ﴿الحجر﴾ 99، و ﴿مريم﴾ 98، و ﴿النحل﴾ 128، و ﴿يوسف﴾111، و ﴿الجمعة﴾ و ﴿المنافقون﴾ 11، و﴿الطلاق﴾ و﴿التحريم﴾12؛ وهذا الأكثر في ترقيم السور.. أنها تنتهي بعددٍ لا يبدو معه إرادة التسوية الذهنية للمعدود (عشرة كاملة.. مئة كاملة.. مئتين..)، أو استحضار عدد بعينه شائع بين الناس وخاصة إن تم الاقتراب منه كالتسعة والتسعين)؛ وتجد على هذا (ترك التسوية الذهنية للمعدود) استثناءات، واستثناءات كثيرة فبعض السور ينتهي بعدد ثابت، ومثلًا: ﴿آل عمران﴾ 200 آية كريمة، و﴿السجدة﴾ و﴿الملك﴾ 30 آية، و﴿القيامة﴾ و﴿النبأ﴾ 40 آية، وهكذا. حين تسأل: لم هذا التنوع ضمن سياق عام (عدم تسوية المعدود)؟
لا تجد إجابة سوى أن هذه إرادة الله.
وحين تتأمل في السور ذات البدايات المتشابة، مثل التي بدأت بالحمد، أو التسبيح أو الحروف المقطعة (ألم، المر، الر، طه، طسم، طس، يس، حم)، تجد أن بعضًا من اللواتي اشتركن في بداية واحدة متجاورات تمامًا، وهذا هو الاستثناء في هذه الظاهرة (السور ذات البدايات المتشابهة)، وهن الحواميم، بل داخل الحواميم تم تجاورت اللواتي تشابهن في البدايات: ﴿الزخرف﴾ و﴿الدخان﴾، و ﴿الجاثية﴾ و﴿الأحقاف﴾. والغالب الأعم أن اللواتي تشابهن في البديات متفرقات في المصحف، مثنى وفرادى وربما أكثر، ومثلًا السور التي تبدأ ب ﴿ألم﴾: ﴿البقرة﴾ و﴿آل عمران﴾ متجاورات، ثم ﴿العنكبوت﴾ و﴿الروم﴾ و﴿لقمان﴾ و﴿السجدة﴾متجاورات، والسور التي تبدأ بالحمد تجد فاتحة الكتاب منفردة ، وكذا ﴿الأنعام﴾ و ﴿الكهف﴾، ثم ﴿سبأ﴾ و﴿فاطر﴾ متجاورات.
وإذا دخلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سورة من السور، وحاولنا أن نجد نمطًا محددًا في أي سورة فلن تجد. ومثلًا: مقاطع الآيات، لا تجد انتظامًا إلا في عددٍ قليل في قصار السور (كالإخلاص، والكوثر)؛ وعلى سبيل المثال سورة النجم تجد البداية ولمسافة طويلة بنوع واحد من الآيات، ثم يتوقف هذا النوع وتأتيك آيات طويلات نوعًا ما ومختلفة بشكل كبير عن التي قبلها، ثم يعاود السياق مرة ثانية الآيات ذات المقطع القصير السريع. وكذا الأمر في سورة النبأ، والفجر.
وإذا نظرنا من ناحية الموضوع، فكل سورة بها كل المواضيع تقريبًا. أو كل سورة مستقلة بذاتها. مسوّرة. تستطيع أن تكتفي بها، بل أزعم أن عامة آيات القرآن الكريم تكفي وحدها، وذلك حسب المعنى القائم في حس من يقرأ، أو حسب ما تثيره الآية الكريمة في نفسه من معان، ولذا نجد الحبيب، صلى الله عليه وسلم، وقف ليلة كاملة مع آية واحدةٍ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدة:118) يرددها، وكان يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بمعنى أنه بقي ساعات طوال لا يقرأ إلا هذه الآية الكريمة.. يتفاعل مع شيء أثارته في نفسه. ومثل هذا عند الذين اتبعوه بإحسان فأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، ظلّت تردد آية واحدة ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ (الطور: 27) زمنًا طويلًا كما جاء في رواية عروة ابن الزبير؛ بل الكلمة الواحدة من القرآن الكريم- كما يذكر صاحب النبأ العظيم، وأكتب من حفظي- كاللؤلؤة، إن وجدتها منفرده وجدتها على أحسن حال وإن تراصت بجوار بعضها زاد حسنها، بل إن وضعت في كلام ماجن حسنته (وأنت ألا تبت يداك)؛ ويجمل هنا أن نذكر أن من جمال السياق القرآني المتفرد أن الآيات التي تعترض السياق (الجمل الاعتراضية، أو الاسترسال) تزيد السياق جمالًا، ولا تخل به. فيها جمال فوق الجمال، فالجمل الاعتراضية في كلام ربنا شديدة الحسن، بخلاف ما يدعيه المؤمنون بالوضعية (العلمانية/ الأكاديمية الحديثة) من رفض الجمل الاعتراضية.. يسمونه خروج عن الموضوع. والجمال في الاسترسال يتذوقه من يتدبر. كل الجمل الاعتراضية شديدة الحسن لفظًا ومعنًا.
وإذا نظرنا من ناحية العلاقة بين اسم السورة الكريمة ومحتواها، سنجد أن الأكثر وضوحًا هو أن السورة تسمى ببعض ما فيها، كأنما يراد من التسمية إبراز شيء محدد، وتدبر: ﴿البقرة﴾، و﴿الأنعام﴾، و﴿الأعراف﴾، و﴿الروم﴾، و﴿لقمان﴾، و﴿المجادلة﴾، و﴿المطففين﴾.
والذين يتحدثون عن خطٍ ناظم يُفهم من خلاله ترتيب السور يتكلفون جدًا. بل يتكلفون أيضًا تكلفًا كبيرًا حين يحاولون البحث عن ترتيب منطقي بين مواضيع السورة الواحدة. ولتفهم مرادي دعني أسأل: هل لترتيب السور على هذا النحو رسالة تصل من يقرأ؟
هل يشعر القارئ بضرورة قراءة السور متتاليات؟ وإن لم يفعل.. إن لم يقرأ السور متتاليات كما هي في المصحف هل يشعر أنه فقد شيئًا؟
لابد أن للترتيب حكمة بالغة، ولكنها لم تذكر صراحة، وكل الذين حاولوا الحديث عن المناسبة بين السور ظهروا متكلفين حينًا، ومتكلفين جدًا أحيانًا، ومقبولين قليلًا؛ ومثلهم الذين يبحثون عن مناسبة بين الآيات داخل السورة!!
نعم القرآن الكريم بِنْيَةٌ متكاملة، والسورة بنية متكاملة، والآية بنية متكاملة وقلَّ إن ترتبط بما قبلها أو بعدها وجوبًا. ولكن هذه البنية المتكاملة تعمل سويًا ويعمل بعضها منفردًا.. فتستطيع أخذ بعضه والاكتفاء به، على الأقل في موقف أو في حالٍ من أحوالك؛ وفي الصلوات الجهرية شاهد على ذلك، وذلك حين يأخذ الإمام شيئًا من أي مكانٍ في كتاب الله ويتلوه على المصلين تجد ما أخذه حسنًا دون حاجة للذي قبله أو الذي بعده؛ بمعنى أننا أمام حالين: حال اجتماع النص كله وحال حضور بعضه.. كله حسن، وكله يصلح.
ظلّ هذا هو التصور الذي يدور بخاطري طيلة سنوات ثمان، وهي معالجة للقضية (وحدة النص) في سياق أدبي، تأثرًا بما دار بين «المحافظين» في الأدب أولئك الذين اتبعوا ما كان عليه العرب منذ قالوا الشعر (تعدد مواضيع القصيدة)، و«المجددين» في الأدب أولئك الذين اتبعوا الغرب في الزعم بأن وحدة النص ضرورة وأن الموضوعية ضرورة، فاستقر في نفسي أن النص القرآني على ما كان عليه العرب في أسلوبهم (تعدد الأغراض).
ولم يشف صدري!!
ظلّت الآيات والسور تتلألأ بخاطري وأمام عيني وأدعو الله أن يفهمني، ما الحكمة في هذا التراص للآيات والسور، ولم هذه الطواعية في النص، بحيث تأخذ من حيث شئت بقدر حاجتك؟
وكم تحدثت مع المؤمنين بالوضعية (الأكاديمية الحديثة).. أولئك الذين يدّعون أن الكتابة لا تكون إلا بالموضوعية.. وتجنب الذاتية.. وأن لابد من وحدة الموضوع، وذات مرة نصحني أحدهم فقال لي: كتابتك ليست أكاديمية كما ينبغي!!
فقلت: وما الكتابة الأكاديمية؟ كيف تكون الجملة أكاديمية؟
قال: الجملة الأكاديمية هي التي لا تفصح عما بداخلها من أول مرة.. هي تلك التي تمر عليها مرة بعد مرة حتى تعلم ما تقول!!
فقلت: كلام ربي سهل قريب يفهمه الجميع ومع ذلك يحمل من المعاني ما لا تحمله كل الأكاديميات!!
وكتبت بعد هذا الموقف مقالًا، لقي استحسانًا من عامة من قرأه، بعنوان «القرآن الكريم والعبوس المتغطرسة» وأقصد بالعبوس المتغطرسة الأكاديمية الحديثة، وكانت فكرته أن الأسلوب فرع على المنظومة العقدية التي يكتب بها الكاتب. بمعنى أن الأسلوب ابن منظومته، فالعلمانيون لهم أسلوبهم، والجاهليون من العرب لهم أسلوبهم، والقرآن شيء آخر غير هذا كله.. شيء أخذ بلب من قرأ أو سمع، والقصص في هذا كثيرة… القرآن حياة.. إحياء للناس وليس توافقًا مع طباعهم.. يقينًا لم ينزل القرآن على ما كان عليه الجاهليون في أسلوبهم، فقد جاءهم بجديد كلية في النسق (سور، وآيات)، وفي كل شيء، فماذا وراء هذا الأسلوب؟! ماذا وراء الظواهر القرآنية هذه التي تتلألأ بخاطري من بضع سنين؟؟
ومرّت أيام طوال (عشر سنوات أو يكاد) على بداية التفكير في هذا الموضوع، وأنا لا أكف عن سؤال الله أن يفهمني، وأن يجعلني وذريتي من أهل القرآن.. أهله وخاصته.
في مرحلة الدكتوراة، ظهرت بعض الأفكار الكبرى في منطقة صناعة الفرد والمجتمع ومن ثم السلطة، استحضر منها ثلاثة أفكار رئيسية:
أولها: النظرية البنائية constructivism.. أن المجتمع يبنى.. أن الهوية تبنى.. أن العادات تبنى.. أننا نعيش في مجتمع من صنعنا.
وثانيها: علاقة السلطة بالمعرفة.. تلك التي أكثر من الحديث عنها ميشيل فوكو (الفرنسي)، وتدور على أن لكل سلطة معرفة خاصة بها أنشأت هذه السلطة.. ثم دعمت السلطة هذه المعرفة فمكنتها من إدارة حياة الناس، أو أن السلطة بعد أن تمكنت كوّنت منظومة معارف تساعد في استقرارها وتحقيق أهدافها.
وثالثها: أن السلطة في الدولة الحديثة تسعى دائمًا للسيطرة [التأثير] على المجتمع، سواءً عن طريق العقاب المباشر (بالتعذيب والسجن)، أم بمنظومة العقاب الخفي التي تمارسها من خلال التحكم في مجريات الحياة في الشارع أو المؤسسات، أم عن طريق المعرفة والخطاب والخاصة الخطاب الديني الوعظي المعني بالحشد والتوجيه.
وبعد سنوات من التفكر والتجول في مقولات الوضعية التي تتعلق بالسلطة والمجتمع (النخبة، والمؤسسات، والعوام)، تبين بوضوح أن النخبة في ظل الوضعية يتصارعون على النفوذ والسيطرة، أو: لمن الأمر والنهي؟ وأن النخبة تحاول بكل أدواتها تحريك الناس حيث تشاء هي.. أو حيث مصالحها هي، فالناس كتلتان: كتلة صغيرة تصنع الحدث وتحاول تحريك الناس حيث تريد هي، وهم الملأ، أو نخبة المال والسلطة، أو «الأوليجارشية Oligarchy»؛ وكتلة كبيرة تتحرك حيث يريد الملأ. وهذا التحريك.. وهذا التحكم في الكثرة (الغثاء) يتم بأدوات معرفية تثمر واقعًا، مثل: بناء الحياة على الاستهلاك: استهلاك المال، والوقت (كورة، وغناء)، وعلى إنهاك الناس فيما يشغلهم ولا ينفعهم كالتعليم النظامي الذي يستمر لعشرين عامًا ولا يستطيع الخريج- في الغالب- العمل فيما تعلمه قبل أن يعاد تأهيله، ومثل: الطرق والمواصلات، والسجن والاعتقال، والدعاية والإعلام،
وانتهيت إلى أننا أمام منهجين منفصلين تمامًا، منهج يراعي التعدد والتنوع في النفس الإنسانية، وأنها تشرد حال القراءة أو السماع وبالتالي تحتاج من يتتبع شطحاتها ويخاطبها بما يدور بخلدها، أو من يثير مكامنها بأسئلة يجاب، أو لا يجاب، عليها، وهو المنهج القرآني. تعدد ضمن سياق واحد.
ومنهج آخر (الوضعية) صلب جامد يتحدث بحدية وأحادية ويرفض التعدد والتنوع.. هذا حال الوضعية (العلمانية) حقيقة.. ترفض التعدد والتنوع إلا قيلًا. فكل من خالفها تحاول تطويعه ووضعه في سياق التابع، وتتحكم في كل شيء. فالدولة عندهم ليست من التداول.. هذا اليوم وذاك غدًا، وإنما State من Static الإحصاء.. تحصي كل شيء على الناس وتتحكم في شئونهم جميعها، ولا تترك للفرد مساحة، فكل شيء بيد الدولة. . بخلاف النموذج الإسلامي الذي يرفض التنميط، أو يوسع النمط جدًا ويجعل التنوع فيها حقيقيًا.
ومن أهم الأخطاء التي ارتكبها المتأخرون: التوجه للنص المكتوب مباشرةً بعيدًا عن التطبيق العملي له، سواءً أكان هذا النص في القرآن الكريم أم في السنة النبوية، وهو خطأ من ناحيتين:
الأولى: أن النص عندنا هو الكتاب والسنة (قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفعله، وما أقر عليه أصحابه، رضي الله عنهم). وليس المكتوب بين دفتي المصحف فقط، فالسنة وحي منزل من الله كما القرآن، يقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾(البقرة: 231)، ويقول الله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:151)، وكل رسول أرسله الله للناس جاء بكتابٍ وحكمة (سنة شارحة)، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ (آل عمران:81).
وأحيانًا ينفردون بنص السنة المدون في كتب الحديث ثم يؤولونه حسب فهومهم، أو بعيدًا عن المراد منه.
والثانية: أن أي نص مكتوب تستطيع أن تخرج منه بما يوافق هواك، وذلك أن النصوص تدخلها الاحتمالات بأضعف القرائن، بمعنى أن النصوص المكتوبة طيّعة لمن أراد تأويلها؛ ومن يتدبر يجد أن النصوص المؤسسة تعرضت للتأويل في اتجاهات متباينة.. تصل للتضاد. وعمليًا اقتتل الأتباع على فهمهم للنص المؤسس!! كما هو الحال في كتابات “ماركس”، فالذي انتشر منسوبًا إليه هو فهو مات الأتباع وليس كلامه!!
والذي يحدث عمليًا هو أن الأتباع يأتون النص المكتوب ليخرجوا منه بما يشاءون هم؛ وإن أتوه مذعنين فإن أفهامهم تؤدي إلى تشتتهم، ولذا لم نُترك لعقولنا ورغائبنا وجاءنا- من الله- نص محكم مشروح بقولٍ وفعل المعصوم، صلى الله عليه وسلم.. بمعنى تم تطبيقه واقعيًا. وأمرنا بالاهتداء بالنص وتطبيقه، يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ (البقرة:137) ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: 115)
تعددية داخل سياق:
وأستطيع أن أقرر بارتياح تام أن النموذج الإسلامي تمثل في هيئة سياقات بداخلها تعددية.. تنوع.. استثناءات كثيرة، سمها ما تشاء. وأعرض عليك نماذجًا من حال النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعين تبين صحة هذا الفهم واضطراده.
كان، صلى الله عليه وسلم، لا يترك الصلاة بالليل، بمعنى أن قيام الليل ثابت بالنسبة له، صلى الله عليه وسلم، وفي التفاصيل نجد تنوعًا، مرة يقرأ السبع الطوال، ومرة يقرأ آية واحدة ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الأنعام:118) يرددها طول الليل.
ويصلي أول الليل، ويصلي آخره (وهذا الغالب).
ويصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل أسبوع بشكل ثابت، وفي رجب وشعبان يكاد يصوم الشهر كله. فهنا ثابت (سياق عام) وهو صيام أيام معينة من كل أسبوع ومن كل شهر، بداخل هذا السياق تنوع، أو استثناءات.
ولنأخذ الظواهر الاجتماعية التي تولدت بالإسلام، تحديدًا الظواهر العلمية المعرفية (الثقافية)، مثل: الفقه، والعناية بالسيرة والمغازي، والعناية بالحديث (متن وسند)، والعناية باللغة والأدب، وكذلك السلطة وما فيها. تجد سياق وتعددية واسعة داخل السياق، فالفقه سياق، وبداخله لا تكاد تجد توافق بين اثنين. حتى الشيخ وطلابه. فالشافعي تلميذ مالك ومع ذلك خالفه، وأحمد يحب الشافعي وله مذهب خاص، وهكذا، ولذا تجد التواتر في الرأي (أو الرواية عند أهل الحديث) محكي عن كل واحدٍ منفردًا، يقول: قال به الأربعة.. بمعنى قاله كل واحدٍ منفردًا وتوافقوا دون أن يتفقوا على الموافقة. فالفرد في الإسلام مستقل ضمن إطار أوسع، أو ضمن سياقٍ أوسع، ويتحرك كفرد. وإن رحت ترصد فعل الفرد ستجده حرًا تمامًا، ولكن ضمن سياق عام. وإن رحت ترصد السياق ستجده فضفاض جدًا.. به استثناءات كثيرة، تمامًا ككتاب الله.. القرآن الكريم الكريم.
استقرت الحقائق في حسي بعد عشر سنين كاملة من العراك بين الأفكار والتردد على كتاب الله: هكذا: العلمانية هي التي تحاول التحكم في سلوك الأفراد تمامًا.. تحاول التحكم في كل شيء.. فالدولة تحصي على الناس كل شيء: الماء الذي يشربونه ويستعملونه في أغراض أخرى غير الشرب، وتحصي النقود عدًا، وتحصي المراكب، وتحصي الوظائف؛ وعندهم صنع العادات.
وقد عبّر بعض المفكرين بأن العلمانية تدير المجتمعات على طريقة معسكرات الاعتقال. وكأن المجتمع معسكر اعتقال مفتوح.. قلة تحرك الكثرة حيث تشاء.. قلة تتحكم في كل شيء وتفعل ما تشاء (والأمر كله لله). فالعلمانية تستعبد الناس على الحقيقة والإسلام يعطيهم حرية حقيقية.. يعطيهم مساحة واسعة في كل شيء حتى في أركان الإسلام. وصدق ربعي بن عامر حين قال: «اللَّهُ ابْتَعَثْنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ».