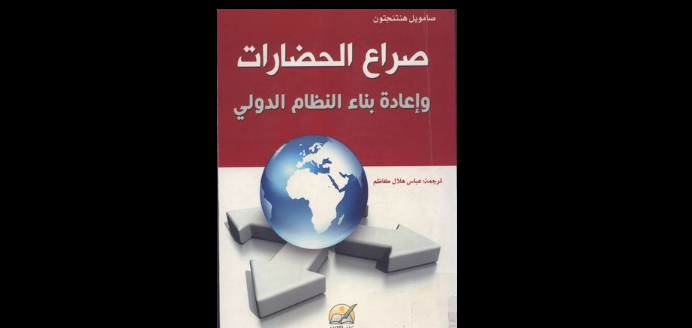صمويل هنتنجتون.. النظرية التي غيّرت خرائط العالم بعد الحرب الباردة
المؤلف: صمويل فيليبس هنتنجتون (1927 – 2008)
مفكر وسياسي أمريكي عنصري بارز، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد، وصاحب تأثير واسع في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.
عمل مستشارًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون)، وكان رئيس تحرير مجلة Foreign Policy. عُرف بتحليلاته الحادة حول الصراع بين الثقافات، وبدعوته إلى تعزيز الهوية الغربية لمواجهة “الخطر الحضاري القادم”، حسب وصفه.
الكتاب:
صدر كتاب “صراع الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي” عام 1996 عن دار Simon & Schuster، وتُرجم إلى عشرات اللغات، وأثار جدلاً عالميًا واسعًا. يقوم الكتاب على أطروحة محورية ترى أن الصراع القادم بعد الحرب الباردة لن يكون بين دول قومية أو أيديولوجيات، بل بين حضارات كبرى ذات هويات دينية وثقافية متميزة.
الحضارات حسب تصنيف هنتنجتون:
قسّم هنتنجتون العالم إلى 8 حضارات رئيسة:
1- الغربية (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية)
2- الإسلامية
3- الصينية (الكونفوشيوسية)
4- الأرثوذكسية (روسيا والبلقان)
5- الهندوسية
6- اليابانية
7- أمريكا اللاتينية
8-أفريقيا جنوب الصحراء (قيد التشكُّل)
ورأى أن أخطر خطوط التماس هي بين الحضارة الإسلامية والغرب، وكذلك بين الصين والغرب، مرجّحًا نشوب صراعات سياسية وعسكرية وثقافية في هذه المناطق.
أهم أفكار الكتاب:
نهاية الحرب الباردة لا تعني نهاية الصراع، بل تحوّله إلى صراع حضاري.
الديمقراطية الليبرالية ليست نموذجًا عالميًا، بل جزء من خصوصية الغرب.
الهوية الدينية والثقافية ستصبح العنصر الأساسي في التحالفات والصراعات.
الإسلام يمتد عبر حضارة ذات حدود دموية ومتوترة مع جيرانه.
الصين تسعى لصعود حضاري ينافس الغرب، وتحالفها مع العالم الإسلامي سيكون تهديدًا مزدوجًا.
أهم الفصول:
1- عالم الحضارات
2- الحضارة الغربية تحت الحصار
3- الإسلام وحدوده الدموية
4- الكونفوشيوسية والإسلام ضد الغرب
5- هل الغرب في حالة انحدار؟
6- إعادة تشكيل النظام العالمي
من أشهر مقولاته:
“حدود الإسلام دموية، وكذلك أحشاؤه.”
“العالم ليس قرية صغيرة بل تجمع لحضارات مختلفة في صراع دائم.”
“الغرب يجب أن يتحد لحماية قيمه وهويته في وجه التحديات القادمة.”
ردود الفعل والانتقادات العالمية:
عالميًا:
إدوارد سعيد (المفكر الفلسطيني الأمريكي) كتب مقالاً شهيرًا بعنوان “صِدام الجهالة” هاجم فيه هنتنجتون، واعتبره يُروّج لنظرية عنصرية تسعى لشيطنة الآخر، خصوصًا الإسلام.
نعوم تشومسكي اعتبر النظرية وسيلة لصنع عدو جديد يبرر التدخلات العسكرية الغربية بعد زوال الخطر السوفييتي.
فرنسيس فوكوياما صاحب نظرية “نهاية التاريخ”، رأى أن هنتنجتون يبالغ في تضخيم الفروقات الثقافية، ولا يدرك حجم التداخل والتفاعل بين الحضارات.
عربيًا وإسلاميًا:
فهمي هويدي في كتابه “نقد صِراع الحضارات”، يرى أن نظرية هنتنجتون محاولة لتبرير الصراع مع الإسلام تحت غطاء ثقافي.
عبد الوهاب المسيري اعتبرها تجليًا للفكر الإمبريالي الجديد، يقوم على مركزية الغرب وشيطنة غيره.
المفكر المغربي المهدي المنجرة في كتابه “الحرب الحضارية الأولى”، ناقش تصاعد التوتر بين الغرب والإسلام، لكنه رفض حتمية الصدام، داعيًا إلى نهضة ثقافية إسلامية.
د. طارق رمضان، حفيد حسن البنا، وصف النظرية بأنها “تعيد إنتاج الاستشراق السياسي بثوب أكاديمي ناعم”.
تأثير الكتاب سياسيًا:
شكّل مرجعية فكرية لصناع القرار الأمريكي، خصوصًا في عهد جورج بوش الابن، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
استخدمه المحافظون الجدد لتبرير “الحرب على الإرهاب”، وغزو أفغانستان والعراق.
مهّد لتزايد الخطاب اليميني في أوروبا عن “تهديد الهوية الأوروبية” من الإسلام والمهاجرين.
روّج لفكرة الصدام الثقافي بدلًا من الحوار الحضاري، ما أعاق جهود التفاهم العالمي.
شكّل كتاب “صِراع الحضارات” نقطة تحوّل في الفكر السياسي العالمي، إذ نقل النقاش من صراعات المصالح إلى صراعات الهُويات.
وقد تمّ توظيف أفكاره في سياسات دولية جرّت كوارث على العالم الإسلامي، وأسّست لمرحلة من الخوف المتبادل بين الشرق والغرب، وبينما يعتبره البعض تحليلًا واقعيًا لما يجري في العالم، يرى فيه كثيرون دعوة لتأبيد الهيمنة الغربية وشيطنة الآخر المختلف ثقافيًا ودينيًا.