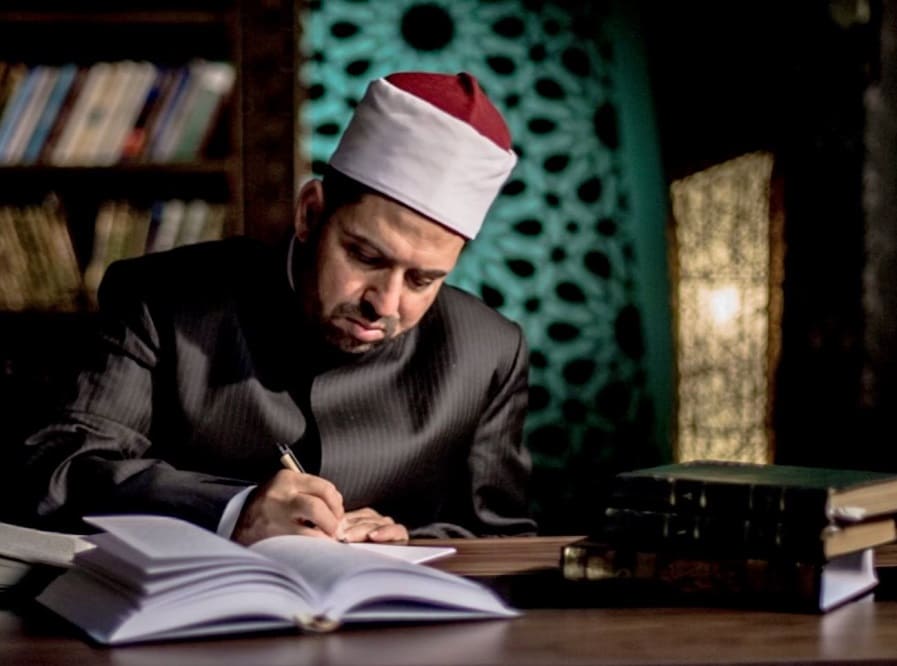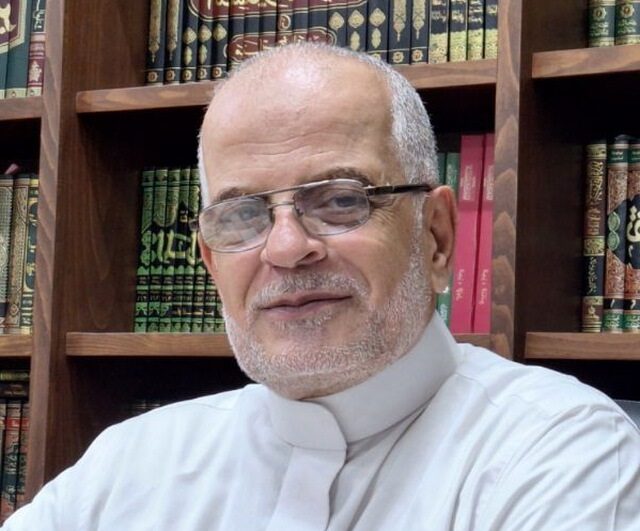العلاقة بين المفكر والتنظيم
بعد دراسة الدوافع التي دفعت عددا من أهل الفكر والعلم من الخروج عن تنظيم الإخوان، بقيت نقطة تدفعنا دفعا للبحث فيها، وهي العلاقة بين المفكر والتنظيم، ولماذا تتوتر العلاقة بينهما، وما الحلول المقترحة في فض هذا الاشتباك بين المفكر والتنظيم.
أسباب توتر العلاقة بين المفكر والتنظيم:
هناك أسباب لا شك تؤدي إلى صدام المفكر بالتنظيم، أو ضيق أحدهما بالآخر، منها:
1ـ الخلط بين أدبيات التنظيم المدني والعسكري:
أول هذه الأسباب وأهمها هو: عدم فهم طبيعة العمل التنظيمي الدعوي، فالمفترض في العمل الدعوي المنظم: أنه تنظيم مدني، تحكمه طبيعة وقوانين وأخلاقيات وأدبيات العمل المدني، وليس تنظيما عسكريا، بما فيه من الغلظة والشدة وعدم إعمال العقل كثيرا، والخطورة هنا تتمثل في استدعاء أدبيات وطريقة إدارة التنظيم العسكري لتنظيم دعوي مدني، يودي بالعمل الدعوي إلى طرق تؤدي إلى انسداد العلاقة بين المفكر والتنظيم، ويؤدي إلى مسخ أفراد العمل الدعوي إلى مجرد دمى تتحرك، وهذا خطأ كبير يقع في إدارة العمل الحركي الدعوي أحيانا، فمن المعلوم أن التنظيم العسكري ينبغي فيه إعلاء مبدأ السمع والطاعة بلا نقاش، بل كثرة النقاش تعوق نجاح أي تنظيم عسكري، وليس مطلوبا فيه كثرة الرؤوس المفكرة، بقدر ما هو مطلوب منها أن تكون جنودا مخلصة، ملتزمة بسرعة التنفيذ، ومطلوب في التنظيم العسكري: قلة الاعتراض، بل انعدامه من الأساس، على خلاف العمل الدعوي وهو تنظيم مدني، لا بد فيه أن يناقش كل فرد ما يقوم به، وأن يكون ما يؤمن به من أفكار، وما يؤديه من أعمال عن قناعة تامة، ولا بد أن تكون الطاعة فيه طاعة مبصرة، وليست طاعة عمياء، وينبغي فيه أن يمنع كل مستبد بالرأي، ضيق به، مانع للنقاش أن يحال بينه وبين توسد أي مسؤولية في التنظيم الدعوي، لأنه يودي بالعمل الدعوي إلى سراديب العمل السري العسكري، وهو ليس مطلوبا، ولا هو الأساس في الدعوة.
ونتج هذا الخطأ في الخلط كذلك عن طريق: استدعاء أدبيات مرحلة تطلبت أن ترتفع أدبيات العمل العسكري فيها بحكم مرحلتها، من حيث التضييق والمحنة، أو عن طريق استدعاء أدبيات كانت لفئة خاصة فتم تعميمها خطأ، ومن ذلك: ما نقرأه في رسالة التعاليم، وفيها فقرات – مثلا – واضح أن الخطاب فيها موجه لجنود في عمل عسكري، وهي بلا شك كانت تدرس للتنظيم الخاص في الإخوان المسلمين، ولكن ما يخص الدعوة العامة منها، هو ركن الفهم، وبقية الأركان، أما ركن الطاعة، والثقة، ففيهما كلام ينبغي أن يحرر، ويزال ما فيه مما هو خاص بالتربية العسكرية، وهذا ما لاحظه مسؤول التربية في جماعة الإخوان المسلمين على عهد الإمام البنا؛ الدكتور عبد العزيز كامل، فاعترض عليه اعتراضا شديدا.
2ـ عدم الدراية بأهمية وعظم دور المفكر في الحركة:
فقد يأتي من لا يقدر قيمة المفكر، ودوره، وما يقوم به من تأصيل للفكرة، وشرح لها، واستشراف لمستقبلها، وهو دور ربما استخف به البعض دون قصد، أو ربما يتسرب إلى البعض بسبب مقولة قالها حسن البنا رحمه الله، وهي رسالة (نحن قوم عمليون)، وقد قصد بها الإمام البنا: العملية في مقابل الدعائية، الذين لا هم لهم إلا الدعاية وقلة العمل، وليس العلم مقابل العمل، ولا تعارض بلا شك بين الفكر والعلم والعمل، والظن بأن المفكر مجرد رجل يجلس ليجادل جدلا بيزنطيا، وهذا الفهم الخاطئ يرد عليه بأنه لا قيمة لعمل ليس مبنيا على العلم الصحيح، وقد صنف أئمة الحديث في كل كتبهم أبوابا في أهمية العلم، وقيمته، وأنه يأتي قبل العمل.
3ـ الضيق بالنقد، وسد منافذه:
ومن الأسباب التي تفسد العلاقة بين المفكر والتنظيم، بل بين التنظيم وبقية أفراده من أصحاب الفكر الحر، والرأي: الضيق بالنقد، والرأي الآخر، وسد كل منفذ يؤدي إليه، من باب: إغلاق باب للجدل، وشتان بين الجدل والنقاش والتحاور. فالمفكر لا يحيا بدون إعمال عقله، وتقليب النظر فيما مضى من مواقف للحركة، وفيما هو قائم من أعمال، وفيما هو مستشرف من مستقبل، وهذا يتطلب منه نقد ما فات، ونقد ما هو قائم، وتقييمه، حتى يبني رؤية لمستقبل يتماشى مع ما تهدف إليه الحركة، وعندئذ تتفاوت وجهات النظر في تقبل هذا النقد، فعند قبوله تستمر العلاقة بين المفكر والتنظيم، ولكن عند رفضه رفضا تاما – بل والضيق به – تسوء العلاقة، وبخاصة عندما يظن البعض بأن النقد باب للخروج على ثوابت الجماعة.
لقد قمت بما يشبه الحصر للنقد في عهد الإمام البنا لشخصه وعلمه وجماعته، فوجدت ما يقرب من أربعين نقدا منشورا في مجلات الإخوان المسلمين، بل خصص البنا صفحة كاملة في مجلة (الإخوان المسلمين) النصف شهرية، جعل عنوانها: باب النقد، وكان غالبا يكتب فيها الشيخ محمد الحامد الحموي نقدا على ما ينشر في المجلة، ونقد فيها رمزين كبيرين من رموز الإخوان: حسن البنا، ومحمد الغزالي. بل وصل الأمر بأحد المنتقدين لحسن البنا أن أرسل له نقدا في صورة سؤال، وكان السؤال كالتالي: يا شيخ حسن أنت رجل مدرس، ونحن نعلم مرتب المدرس جيدا، ونعلم أنك لا تتقاضى راتبا على عملك الدعوي، ومع ذلك نراك أنيقا في ملبسك، أنيقا في مظهرك، فمن أين لك هذا وأنت رجل مدرس بسيط؟!
ومع ذلك نشر حسن البنا سؤال السائل الناقد، ووعدت المجلة بالإجابة في العدد القادم، وأجاب حسن البنا بما يلي: نعم صدقت يا أخي أنا لا أتقاضى راتبا على عملي الدعوي، أما ما لاحظته من أناقة المظهر وغيره وأن راتبي لا يكفي فهو صدق، وكان صلى الله عليه وسلم ينفق من مال خديجة، وأنا أنفق من مال أخي خديجة (يقصد صهره)، ولي أخوان يقرضانني دائما، وأعرض عليك ثلاثة حلول: أن تزورني في المركز العام للإخوان المسلمين وأطلعك على اسم الأخوين الكريمين وإما أن تسدد لهما ديوني عندهما، وبذلك أصبح مدينا لشخص واحد، أو أن تكون الثالث الذي أقترض منه عند الحاجة، أو أن تدعو الله تعالي لي بأن يسدد عني. وقد فكرت في سبيل لتحسين حالتي المادية، وسوف أصدر بإذن الله مجلة (الشهاب) بترخيص شخصي لي، لعلها بذلك تكون سببا من أسباب الدنيا في تحسين وضعي. وجزاك الله خيرا. أخوك: حسن البنا.
4ـ تضخيم جانب الإداري والمنظم على حساب المفكر:
فتضخيم الجانب الإداري والتنظيمي على حساب الجانب الفكري، أو طغيان أحدهما على الآخر، ويأتي نتيجة تضخيم جانب الإداري، وتقزيم جانب المفكر، أو محاولة الإداري الجمع بين المهمتين: أن يكون إداريا ومفكرا في الوقت ذاته، وهي مهمة صعبة ندر من يقوى على الجمع بينهما، وغالبا ما يكون الجامع بينهما ـ على ندرتها ـ المفكر في الأساس.
وأوضح هذه النقطة بمثال معاصر في الحركة الإسلامية المعاصرة، فقد خرج أفراد الحركة الإسلامية من السجون والمعتقلات بعد وفاة جمال عبد الناصر، وقد كان للحركة رصيد ضخم من الفكر والثقافة، ولم تكن حاجتها في ذلك الوقت إلى تصدر المفكر بقدر حاجتها إلى المنظم الذي يعيد حبات العقد المنفرط، فقد كان هذا الرصيد الثقافي يكفيها لبضع سنوات، فتولى أمر الحركة من يدير شؤونها، ومن يهتم بالبناء التنظيمي، وقد كانت تحتاج لهذا بحق في هذه الفترة، وشيئا فشيئا بدأ ينحسر دور المفكر أو الباحث في الحركة، وفوجئنا بالطبيب – وكذلك المهندس وغيره من بقية التخصصات العلمية – الذي يلقي الخاطرة الخفيفة التي تصلح في مجال التجميع الدعوي البسيط، ثم تعمقت الفكرة وتأصلت في قدرة الطبيب والمهندس والمنظم والإداري في الدعوة إلى التكلم باسم الدعوة، والتنظير لها، وشتان بين الموعظة الدعوية، وبين التنظير الفكري، والتأصيل العلمي، فأدوات كل منهما تختلف عن الآخر.
كان ينبغي أن تفهم الحركة أن هذا الدور لغير المفكر دور مؤقت، إذ إن سيلا من الأسئلة والمواقف الفكرية سوف يطرح نفسه تلقائيا بعد عودة نشاط الحركة، ولن يقوى على مواجهة هذه الأسئلة والتنظيرات الفكرية والعلمية سوى المفكر والباحث. وقد تسبب هذا الخطأ في إقصاء المفكر بدرجة ما، وأدى إلى بروز أفكار ليست من صحيح الدعوة ولا صلبها ولا جوهرها، نتجت عن ذلك، مما يجعل هوة تحدث بين المفكر والتنظيم، بل هي تمثل نتوءات، وزوائد زائدة عليها، بل شوهتها في بعض الأحيان.
5ـ تقييم المفكر عن طريق أدائه التنظيمي:
فهو ينظر له بنفس المقياس الذي يقاس به الحركي أو التنظيمي، من حيث الالتزام بما يلتزم به التنظيمي، من واجبات، وحقوق، وأداء دعوي إداري، مما يجعله في نظر الإداري أقل دورا، بل لا دور له أساسا، وينسى هؤلاء أن الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم لم يكن أداؤهم جميعا بمقياس واحد، فلم نر مثلا صحابيا جليلا كخالد بن الوليد من رواة الأحاديث، ولم أجد له اللهم إلا حديثا أو حديثين، فلا نستطيع أن نقيم خالدا في باب العلم ورواية الحديث، كذلك لا يمكن أن نقيم صحابيا كأبي هريرة من الميزان العسكري، فهو رجل حفظ على الأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم، وهكذا.
6ـ استخفاف المفكر بالتنظيم:
ويقابل السبب السابق سبب آخر مكمل له، وهو: عندما يستخف المفكر بالقرارات التنظيمية الجادة، التي تبنى على شورى صحيحة، وهو خطأ يقع من جانب المفكر، فهو يريد إمضاء رأيه، وإن كان الأمر جرى على شورى معتبرة، وهو خطأ يحدث أيضا من جانب بعض المفكرين، فالصواب في مثل هذه الأمور: أن الشورى إذا تمت ونوقشت الأمور، وانتهى النقاش فيها إلى رأي معين، كان بناء على أغلبية الآراء، فعندئذ يلتزم الجميع بالرأي المتفق عليه، ويظل كل صاحب قناعة فكرية على قناعته في نفسه، كرأي علمي قابل للنقاش وقت فتح باب النقاش.