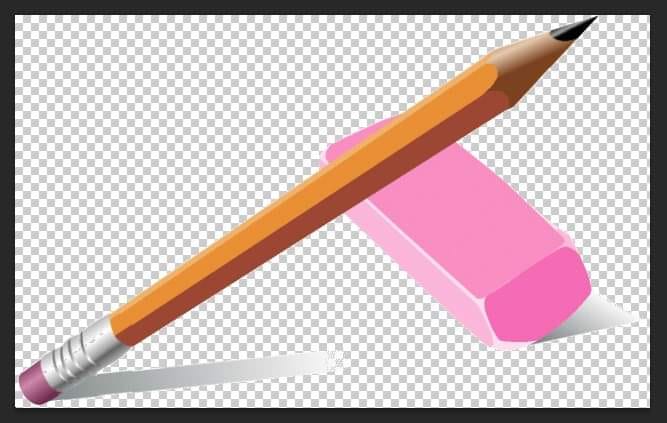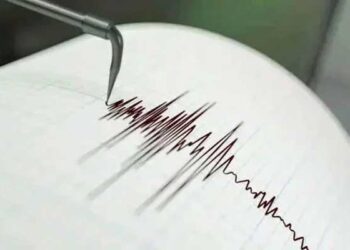كلّ الشعر مرئيّ بالضرورة، فالصور مُدمجة بالمعاني، والمعاني تفسّرها الأصوات. والرؤية مجسَّدة في كلمات، تتحرّك وفقًا لاهتماماتٍ لا تُعدّ ولا تحصى، بحسب اللّغات وقدرات المُبدعين على إنشاء المعاني التي تتضمّن كلّاً من الشكل والصورة والصوت، وفق مُعادلاتٍ غاية في التعقيد يُدركها الشعراء قَبل غيرهم من خلال الكتابات الاستبهاميّة التي يبرز فيها الشكل أكثر من الكلمة، بما يجعل قصائدهم مرئيّة وبصريّة، بمقدار ما تحقّقه من تواصل يمتدّ في حقيقته عميقًا في الزمن، زمن القصيدة وزمن الشاعر.
الشعر البصري الدلالي
يتحقَّق هذا التواصل مُعانقًا النقوش البدائيّة الصخريّة والكهفيّة والكتابات المسماريّة والهيروغليفيّة، بل والقصائد الأولى التي تمّ تشكيلها على أشكالٍ صوريّة مثّلت الأفكار في القصائد، وحقّقت البنية البصريّة في الشعر الذي استمرّ في التطوُّر إلى الشعر المُعاصِر، الذي يشمل أعمالًا مختلفة الأبعاد، ثنائيّة وثلاثيّة، اعتماداً على سيميائيّة الوسائط المُستحدثة التي يجتمع فيها المكان والزمان والفعل، وبما يَجعل المعنى مُعتمداً على طبقاتٍ من التفسير المعرفيّ للجماليّات التفاعليّة التي تَجمع الشاعر بالشعر أوّلًا، مُحقّقًا اتّصالًا ديناميكيًّا بالقارئ أو المُستمِع أو المُشاهِد المتفاعِل معًا.
يَختبرُ الشعرُ حقيقَتَهُ عبر الزمن بتطوير ارتباطه بالفنون الأخرى، التي طالما جمعته بها عرىً وثيقة لاستجواب القضايا الإنسانيّة الأشدّ إلحاحًا، بما فيها السياسي والاجتماعي، وباقي المفاهيم المعنيّة بتحليل الصورة، والانشغال بما حقَّقته الصور في مجالات الميديا، والعمليّات المعقّدة لتبدُّل القيَم الإنسانيّة والثقافيّة التي يُمكن من خلالها اختبار ادّعاءات القصيدة في ترحالها من الموزون إلى المفعّل نحو النثر وما تلاه، ومن الملموس الرمزي منتصف القرن الماضي إلى الهندسيّ والدلاليّ، وكلّ ما تبع ذلك من توصيفاتٍ نقديّة تجلّت في إسهامات الشعراء بالمشاركة في معارض كبرى وبيناليّات عربيّة ودوليّة متأثّرة بتجارب مهمّة في هذا المجال: كالتجربة البرازيليّة التي قدّمت شعرًا وقراءات تعتمد على تفكيك الرموز والعلامات البصريّة الأيقونيّة لإنتاج سلسلة من الدلالات المعاصرة في شعر ما بعد الحداثة، حيث يكمن التجريب في تعافي التنوّع وخلق مساحاتٍ من الحريّة التعبيريّة غير مسبوقة، وصولًا إلى ما يُمكن اعتباره شعر المونتاج أو الشعر البصري الدلالي.
تعتمد الصور المرئيّة في الشعر على قدرتها في خلق الأعماق المكانيّة، التي تتضمّن الشكل واللّون والشفافيّة والخطّ والمنظور وسواها ممّا يشكّل طبقات المعاني، التي تُحدِّد العلاقات الإدراكيّة وفق قوانين ماديّة تتّصل بالتشابُه والإيقاع والانسجام والقرب والبعد والعلوّ.. إلخ، وكلّ ما يَجعل منها قوّة تواصليّة بالغة المرونة تصل إلى حدود الحواسّ كالشعور بالملمس والنشوة والاهتزاز، وكلّ ما يُكثِّف العوالم الروحيّة والأحاسيس في كلماتٍ وفضاءاتٍ وهياكل نحتيّة مرئيّة تسمح بلمس الصوت كما تُلمس المنحوتات المشوبة بالغموض، وتضيف مستوياتٍ من التجريد الحسّي والرموز العلائقيّة لإنشاء مستوياتٍ من التشفير الموجَّه إلى الحواسّ والمحمَّل في صور وألوان وإيقاعات ورموز وحركات.
في القصائد المرئيّة والبصريّة يغلب الوصف الضمنيّ، استجابةً للاستفسارات التي تَجمع بين الأفكار وسياقاتها الزمكانيّة، لتشكيل البنية (النصّ والصور والصوت والحركة والفعل.. )، وتحقيق مصفوفاتٍ متعدّدة الأبعاد الافتراضيّة والماديّة، لإنشاء هياكل بصريّة ودلاليّة جديدة يكون فيها الشعر ضدّ الصيَغ السهلة، بل هو الفضاء الذي يلغي الزمن، ويُعيد تشكيل الحركات البصريّة التفاعليّة، التي تُحدِّد إيقاع التفاعُل، مضيفاً بُعداً آخر للشعريّة البصريّة، تماماً بما يشبه فنّ الأداء بتقنيّاته المُستحدَثة، وقدرته على استقطاب التفاعُل الإيمائي، الذي يُعتبر اللّغة الطبيعيّة الأصليّة للبشريّة.. إنّه ما يُحقِّق نِسباً جديدة لتوسيع الحواسّ والمُدركات العابرة للنماذج، إذ تتغيّر الارتباطات في الشعر بمرور الوقت دلاليًّا مع ظهور أنماطٍ جديدة. تبرز في التفاعُل مع الناس والبيئات المحيطة، باعتبارها تركيباتٍ لم تَكتمل، ولكونها تبقى مفتوحةَ الآفاق إلى الأبد.
الكتابة حتّى المحو
تدعو القصيدةُ البصريّةُ للتشكيك بالمعاني التقليديّة للشعر وكذلك بمختلف الافتراضات المعرفيّة الأساسيّة للصور المرئيّة غير اللّغويّة؛ فهي تولِّد المعاني بطرقٍ مختلفة من خلال تسليط الضوء على الأبعاد غير المدروسة للمعارف الفنيّة في المُجتمعات وتفكيك البنى البيانيّة، بما فيها الاستعارة والكناية وسواها، وبما لا يَخرج عن السياقات الاجتماعيّة وظروفها. فالشعر البصريّ منشغل أساسًا بالوعي المجتمعيّ والأبعاد التحليليّة للصورة بما في ذلك وسائل الإعلام المرئيّة. وغالبًا ما نَوَّه النقّاد والشعراء بمثل هذه الأمور. كتبَ عيسى مخلوف مثلاً في حاشية ديوان «كمن يريد أن يمحو» لحسين بن حمزة أنّه: يتبرّأ من كتابة الشعر من فرط ما يتهيّبه. إنّه هاجس الكمال ما يَجعل الشاعر يتوق إلى بقاء القصيدة حلمًا خشية أن تتجسّد ولا تكون في مستوى تصوّره لها. وقد ذهب عيسى في الاتّجاه ذاته حين كَتَبَ أيضًا: الشعر في هذا الديوان مقرون بالمحو، إنّه الكتابة حتّى المحو. نحن أمام شعرٍ لا يطمح أن يرتجز، ولا أن يُنشَد، ولا أن يُطرِب. شعر يُصارِع القصيدة، ويعمل على نقدها من داخل. إنّنا أمام نَوع من الزهد، من الاقتصاد، وبالطبع الغناء القليل، والبلاغة القليلة.
على المستوى العربيّ
نسيج القصيدة البصريّة (زمان ومكان وكلمات، صور وأصوات وأفعال) يحدّده إيقاع العلاقات الديناميكيّة بين هذه المكوّنات ومختلف الانتقالات السمعيّة والبصريّة المُعتمدة على الذاكرة والوعي البصري للمعاني التي يتمّ تجسيدها حسب السياق، وكيفيّات تغيُّر هذا السياق بدمْج العناصر البصريّة بالنماذج المفاهيميّة للّغة وطبقاتها الرمزيّة على اختلافها، علماً أنّ الصور تتلاشى في حقيقة تكوينها، وتَمتزج معاً لترمز إلى الوحدة حينًا وإلى الاختلاف حينًا آخر كتكاملٍ بين الحقائق المُختلفة لخلْق إطارٍ بصريّ ومفاهيميّ جذّاب يقع خارج نطاق القياس، حقائق تولِّد رؤىً ووجهات نظر طليعيّة جديدة ومُعاصرة، قادرة على مواجهة جماليّات الماضي المِتحَفيّ.
يتمّ التعامُل نقديًّا مع الشعريّة البصريّة من خلال تصنيفها الشكلاني، وهو ما يُضيِّق مساحةَ التقدير اللّازم للاطّلاع على الجوانب الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة المتّصلة بأبعادها المعاصرة، من دون اللّجوء –غالبًا- إلى النقد المقارن المتّصل بمنهجيّات نظريّات الشعريّة البصريّة وأسسها وحالات تقييمها بناءً على العديد من الفعاليّات الدوليّة ذات الاهتمام بالشعر البصريّ، كبينالي ساو باولو، وبينالي الشارقة، وبينالي القاهرة، ويُمكن الإشارة إلى البينالي الدولي للشعر البصري الثالث الذي أُقيم في مكسيكو سيتي في العام 1990، والذي ضمّ أعمال فنّانين وشعراء تجريبيّين من أكثر من أربعين دولة؛ وقد تمّ تجميع مختارات من الشعر البصري من تلك البلدان التي اعتبرها القيّمون في غاية الأهميّة التجريبيّة، كونها تُشكِّل وسيطًا بين«الشعر الخطّي الذي يعتمد على بناء الجملة والأسلوب التقليدي وبين الشعر المرئيّ بأشكاله المتنوّعة المُعتمِد على ما يُدعى الفضاء السلبيّ المستفيد من الاستراتيجيّات التعبيريّة والتركيبيّة والأدائيّة، التي يَستخدمها الفنّ المعاصر، والتي تتميّز بدعوتها للجسم الفنّي المكبوت للعودة عبر تسليط الشعر البصريّ الضوء على الركائز، وتفعيل الأرض الإدراكيّة، وكل ما يؤدّي إلى تفاقُم المفاوضات الثقافيّة والسيميائيّة بين المحامل الإبداعيّة الأخرى، كالشعر الخطّي والمطبوعات والرسم وما إلى ذلك».
الفنّان شريك الشاعر، بل هو ذاته، وهو يُسخِّر مختلف المحامل الإبداعيّة المُعاصرة من رسمٍ وتصويرٍ وفوتوجراف وتصميمٍ جرافيكي وفيديو وأفلام لقصيدةٍ تحوِّل الإشارات إلى عناصر تجريديّة مُثيرة للتفكير. لكنّ السؤال الذي يَطرح نفسه: متى يُمكن للقصيدة المرئيّة أن تُغيِّر في سياق الشعر؟ أو أن تُفجِّر نفسَها في سياقِ أيّ متغيّرٍ اجتماعيّ أو سياسيّ أو سواه؟ إنّه ما قَلَبَ مُعادلات القصيدة في كوبا مثلاً في ستّينيّات القرن الماضي إثر انتصار الثورة في العام 1959، أي اللّحظة التي بدأت فيها متغيّراتٌ ضخمة كحملاتِ محو الأميّة الجماعيّة، والمطبوعات الضخمة للكُتب، وصناعة السينما والزّخم الكبير للمرئيّ، وخصوصاً ما تبلْور في الملصق الذي بدا كشعرٍ مرئيّ في أعلى مستوياته عبر مزْجِ الرسوم بالنصوص، لتأسيس نَوعٍ من الشعر ذي حسٍّ بصريّ متطوّر للغاية؛ شعر تبدو الكتابة فيه كقيمة بصريّة أكثر ممّا هي دلاليّة، حتّى في تنقية العلامات وتوليفها بطريقةٍ شخصيّة للغاية، استفادوا فيها من التقنيّات الحاسوبيّة وأجهزة الكومبيوتر والفيديو، بدمْج الألوان والحركة والموسيقى والنصوص والمؤثّرات الصوتيّة بلغة إلكترونيّة تُعيد توجيه الحواسّ، بعيدًا عمّا كان في القصيدة الكتليّة (الكونكريتيّة) وما حقَّقته في قراءة التوزيع الفراغيّ للنصّ بصريًّا.
شكلانيّات التاريخ
على المستوى العربيّ، يحتاج الأمر إلى مزيدٍ من دراسات النقّاد والباحثين في الشأن الشعريّ الحديث والمُعاصر، على الرّغم من إحالات عديد المؤلّفين الذين كَتبوا عن أهميّة القراءات البصريّة لشعراء إبّان العصر العبّاسي الثاني الذين وُصفوا بالانحطاط بقيَم الشعر عمومًا، فيما رأى آخرون في لعبهم بالأشكال الفنيّة الشعريّة تجسيمًا لقيَمٍ بصريّة نقلتِ الفنونَ الشعريّة آنذاك من الأُذن إلى العَين، مرورًا بالشعر المدبَّج والهندسيّ والمطرَّز والمشجَّر وشكلانيّات التأريخ بحروف الكلمات والأشعار أو ما يُكتب بالطرد والعكس أو المحبوك الطرفَيْن وكلّها على صلة بالمرئيّ والبصريّ الذي جعل من هذا الشعرِ سبّاقاً في التأريخ للشعريّة البصريّة على شعراء الغرب: أبولينير ومالارميه، ومن تلاهم من السورياليّين وأصحاب الشعر المجسَّم: باوند وغومينغز وجويس وسواهم ممَّن تأثّروا بالدادائيّة والمستقبليّة ومن ثمّ المفاهيميّة.
يبقى أن تتأكّد الدراسات النقديّة المأمولة بمستنداتٍ نصيّة بصريّة تنتمي إلى حقيقة الشعر العربي المعاصر وجوهره، كحقلٍ واحد لا كحقلَيْن كما جرتِ العادة في التطرُّق إليهما.
———