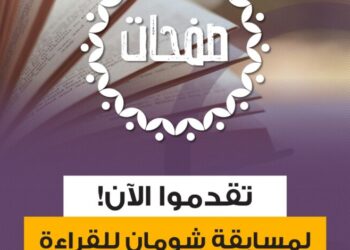مسألة المجاز من المسائل الخلافية عند أهل السنة والجماعة، ومن قال بالمجاز فهو بشروطه الصحيحة، ولا يقال به في تفسير نصوص الوحي إلا عند تعذر حملها على الحقيقة، ثم هم كلهم متفقون على اتباع السلف الصالح في فهم نصوص الكتاب والسنة.
(مجاز القرآن أو المجاز في القرآن هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح، مثل قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}، وهذا مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، وذهب جمهور العلماء إلى وجود المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب الذين يستعملون المجاز في لغتهم، ويُحمل الكلام على المعنى المجازي)
قال ابن حزم : «لا يجوز استعمال مجاز إلا بعد وروده في كتاب الله أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم».
وقال الفراء عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَآءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ]، فقال: «السُّجُود في هذا الموضع اسم للصَّلاة لا للسُّجود؛ لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع».
فنجده قد صَرَف اللَّفظ عن ظاهره إلى المعنى المجازي.
وقال أبو يزيد القُرَشِي، وهو من أئمة اللغة، المتوفى سنة 170هـ: “وقد يداني الشيءُ الشيءَ وليس من جنسه، ولا يُنْسَبُ إليه، ليَعْلَم العامَّة قُرْبَ ما بينهما، وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللَّفْظِ المختلف، ومجاز المعاني” ، ثُمَّ مَثَّل بقول امرئ القيس:
قِفا فاسألا الأطلالَ عن أُمّ مالكِ
وهل تُخبِرُ الأطلالُ غيرَ التّهالُكِ
ثم قال: «فقد علم أن الأطلال لا تجيب إذا سُئِلت، وإنما معناه: قفا فاسألا أهل الأطلال، وقال الله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف:82]، يعنى أهل القرية»
وقد أشار الخليل بن أحمد الفراهيدي-وهو من أئمة اللغة- إلى المجاز واستخدامه، حيث قال في العين: قال: «البَائِضُ» وهو ذَكرٌ، فإن قَالَ قائل: الذَّكَرُ لا يَبِيضُ، قيل: هو في البَيْضِ سَبَبٌ؛ ولذلك جعله بَائِضًا، على قياس والِدٍ بمعنى الأب، وكذلك البَائِضُ، لأَنَّ الوَلَدَ من الوَالِدِ، والوَلَد والبَيْض في مذهبه شيء واحد.
وقال سيبويه : «ومما جاء على اتِّسَاعِ الكلام والاختصار قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا﴾ [يوسف: 82] إنما يُرِيدُ: أهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان هاهنا.
فنُلاحِظُ أن سيبويه بَيَّن أن الفعل (اسأل) قد عمل في (القرية) التي حلَّتْ مَحَلَّ (أهل)، فكان حقُّ الفعل (اسأل) أن يعمل في الأهل لا في القرية، ولا في العير من حيث أنهما قرية وعير، والعلاقة في (القرية) المكانِيَّة، والعلاقة في (العير) المجاورة أو المصاحبة.
وأبو عبيدة، صاحب كتاب مجاز القرآن، كان من الذين أشاروا إلى المجاز ولم يصرِّحُوا باسمه، قال: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ [الأنعام: 6] مجاز السماء ها هنا مجاز المطر، يُقَال: ما زِلْنَا في سماء، أي: في مطر، وما زلنا نَطأُ السَّمَاءَ، أي: أثر المطر، وأَنَّى أخذَتكم هذه السماءُ؟ ومجاز (أرْسلنا): أنزلنا وأمطرنا.
المجاز من التجاوز والتعدي وهو أحد فروع الحقيقة، ويعني اصطلاحًا استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وُضع له، وذلك بسبب وجود قرينة تحول بين هذا اللفظ ومعناه الحقيقي، فيستحيل أن يكون مقصودًا به معناه الحقيقي، ومثال ذلك وصف شخص ما بأنه أسد، كقولنا: (رأيتُ أسدًا يعِظ الناس)، إذ يستحيل أن تكون لفظة أسد في هذه الجملة بمعناها الحقيقي، والذي يمنع ذلك هو وجود قرينة وهي (يعِظ الناس)، فيفهم القارئ أن الأسد يُقصد به رجل ولكن تم تشبيهه بالأسد لشجاعته، ومن الجدير بالذكر أن المجاز لا يؤخذ به إلا في حال تعذّر المعنى الحقيقي؛ وذلك لأن الأصل هو الحقيقة، فنتحرى الحقيقة أولًا ثم إذا تعذرت فإنه يتم الأخذ بالمجاز، ومن الجدير بالذكر أن الحنفية وغيرهم ذهبوا إلى أن المجاز لا يدخل في باب الضرورات، بل هو وسيلة من وسائل التعبير عن المعنى مثله مثل الحقيقة، وقد يكون المجاز أبلغ من الحقيقة في بعض الأحيان، ولذلك نراه شائعًا في الكلام البليغ.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
” – الأول- المجاز المفرد: وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي.
والعلاقة إن كانت المشابهة، كقولك: رأيت أسداً يرمي. سمي هذا النوع من المجاز استعارة…
وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك، سمي مجازا مفردا مرسلا كقول الشاعر:
أكلت دما إن لم أرعك بضرة * بعيدة مهوى القرط طيبة النشر
أطلق الدم، وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية؛ لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له.
– الثاني -: المجاز المركب:
وضابطه: أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر، لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات…
وعلاقته: إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة والمثل يحكي بلفظه الأول…
وإن كانت علاقته غير المشابهة، سمي مجازا مركبا مرسلا، كقوله:
هواي مع الركب اليمانيين مصعد * جنيب وجثماني بمكة موثق
فالبيت كلام خبري أريد به انشاء التحسر والتأسف لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحصر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل، علاقته السببية؛ لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر، ولا لازم فائدته…
-الثالث-: المجاز العقلي:
فالتجوز فيه في الإسناد خاصة…
كقول المؤمن: أنبت الربيع البقل.
فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في اسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا عند المتكلم، وكذلك هو في الواقع…
-الرابع-: مجاز النقص: عندهم ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَة )…
جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب ” انتهى من “مذكرة أصول الفقه” (ص 88 – 90).
والمجاز لا بد فيه من القرينة الصارفة للفظ من المعنى الحقيقي إلى المجاز.
قال الزركشي رحمه الله تعالى:
” المجاز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة:
فالعلاقة: هي المجوزة للاستعمال.
والقرينة: هي الموجبة للحمل.
فأما القرينة: فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا…
ولا خلاف في أنه لا بد من القرينة، وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم المجاز، وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره، وهو رأي الأصوليين؟ ” انتهى من “البحر المحيط” (2 / 192).
ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى:( وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) الإسراء/72.
فلفظ “الأعمى ” هنا مجاز عن عدم إبصار القلوب للحق.
وقرينة ذلك؛ أن عرف الشرع في ذم العمى، وهو عدم الإبصار، هو ذم عدم إبصار القلوب للحق وإعراضها عنه.
قال الله تعالى:( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) الحج/46.
وأما عمى الأعين فلا ذم فيه كما هو معلوم من الشرع، بل صاحبه محمود إن آمن وصبر وموعود بالفضل الكبير.
ثانيا:
القول بنفي المجاز في القرآن
ذهب بعض أهل العلم إلى نفي وجود المجاز في القرآن على وجه الخصوص، لأن المجاز خلاف حقيقة اللفظ، فمن قال رأيت أسدا ويريد به رجلا شجاعا. فنستطيع أن نصفه بأنه لم يقل حقا؛ باعتبار ظاهر اللفظ، فننفي قوله، والقرآن حق بيّن، لا يمكن أن ينفى منه شيء.
وجاء في الدرر السنيّة للسقاف:
ذهَب جُمْهورُ العُلَماءِ مِنَ الأصولِيِّينَ والبَلاغِيِّينَ والمُفسِّرينَ وغيرِهم إلى أنَّ المَجازَ واقِعٌ في اللُّغةِ والقُرآنِ، في حين ذهَب قليلٌ مِنَ العُلَماءِ إلى أنَّ المَجازَ لا وُجودَ له أصْلًا؛ لا في اللُّغةِ، ولا في القُرآنِ، وذهَب بعضُ العُلَماءِ إلى وُقوعِ المَجازِ في اللُّغةِ، وأنْكَروا وُقوعَه في القُرآنِ.
واحْتجَّ مُنكِرو وُقوعِ المَجازِ في القُرآنِ وحْدَه أو في القُرآنِ واللُّغةِ بـ:
– أنَّ المَجازَ كَذِبٌ، ولا يَجوزُ القولُ بأنَّ في القُرآنِ مَجازًا لِهذا.
– أنَّ القولَ بإثْباتِ المَجازِ مُبرِّرٌ لمُنكري الصِّفاتِ الإلهيَّةِ الَّذين زعَموا أنَّ فيها تَأويلًا ومَجازًا، وأنَّ المُرادَ باليدِ القُدرةُ وبالبصَرِ العلْمُ، ونحْوُ ذلك.
– أنَّ إثْباتَ المَجازِ في القُرآنِ يُفْضي إلى وصْفِ اللهِ بالمُتجوِّزِ، وهذا لا يَجوزُ.
– أنَّ تَقْسيمَ الكَلامِ إلى حَقيقةٍ ومَجازٍ مُسْتحدَثٌ مِنَ القولِ لا يُعرَفُ في الصَّدرِ الأوَّلِ ولا في القُرونِ الثَّلاثةِ الأُولى.
وأجاب مُثْبِتو المَجازِ على ذلك بـ:
– أنَّ القولَ بأنَّ كلَّ مَجازٍ كذِبٌ يَجوزُ نفيُه: ليس صَحيحًا؛ فإنَّما يكونُ المَجازُ كذِبًا إذا أثْبت المَعْنى على الحَقيقةِ لا على المَجازِ؛ فإذا قلتَ لرجُلٍ بَهيِّ المَنْظرِ: إنَّك قمَرٌ، فلستَ كاذِبًا إلَّا أنْ تزعُمَ أنَّه القمَرُ الَّذي يطلُعُ في السَّماءِ.
– أنَّ المَجازَ لا يُسْتعمَلُ إلَّا معَ قَرينةٍ تَصرِفُه عن المَعْنى الحَقيقيِّ المُرادِ، فإذا لم تُوجَدِ القَرينةُ وأريدَ باللَّفظِ المَجازُ دُونَ الحَقيقةِ كان الكَلامُ فاسِدًا، بخِلافِ الكذِبِ؛ فإنَّ صاحِبَه يَسعى إلى تَرْويجِ كذِبِه.
– أنَّ القولَ بأنَّ المَجازَ وَسيلةٌ لنفْيِ الصِّفاتِ وتَأويلِها ليس صَحيحًا؛ فالأصْلُ أنْ يُحمَلَ اللَّفظُ على الحَقيقةِ إلَّا إذا تَعذَّرَ ذلك، أو وُجِدتْ قَرينةٌ تَصرِفُه عنِ الحَقيقةِ إلى المَجازِ، كما أنَّ مَجيءَ الصِّفاتِ مُتكاثِرةً في القُرآنِ يَشْهدُ لها أنَّ المُرادَ منها الحَقيقةُ لا المَجازُ.
– أنَّ إثباتَ المجازِ في القرآنِ لا يَعني القولَ به في مَسائلِ الصِّفاتِ والغَيْبياتِ؛ فإنَّ صَرْفَ النُّصوصِ عن ظاهرِها يَفتقِرُ إلى قَرينةٍ تُثبِتُ ذلك، وطَريقةُ سرْدِ آياتِ الصِّفاتِ تَشهَدُ أنَّ المُرادَ منها حَقيقتُها، كقَولِه تعالى: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا [النساء: 164] ؛ فإنَّ التَّأكيدَ لا يَأتي معَ المَجازِ، فلا يُقالُ: أراد الحائِطُ إرادةً. ومنْه قولُه تعالى: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] ؛ فإنَّه لا يَجوزُ أنْ يُرادَ به القُدرةُ؛ لأنَّ القُدرةَ صِفةٌ واحِدةٌ، ولا يَجوزُ أنْ تأتيَ مُثنَّاةً، ولا يَجوزُ أنْ يُرادَ به النِّعْمةُ؛ لأنَّ النِّعَمَ لا تُعَدُّ ولا تُحْصى، ولا يَجوزُ أنْ يكونَ المُرادُ “لِما خلقتُ أنا”؛ لأنَّهم إذا أرادوا ذلك أضَافوا الفِعلَ إلى اليدِ مُباشَرةً؛ تقولُ: هذا ما قدَّمَتْ يداك، ومنه قولُه تعالى: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ [آل عمران: 182] ، وقولُه: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ [الحج: 10] ، أمَّا عندَ إضافَةِ الفِعلِ إلى الفاعِلِ، وتَعْديةِ الفِعلِ إلى اليدِ بالباءِ، فإنَّه لا يُرادُ به إلَّا الحَقيقةُ. ولا تَجدُ مَنْ يقولُ: فعلْتُ هذا بيدِيَّ، وهُو يُريدُ: فَعَله خادِمي أو مَمْلوكي.
– أنَّ أكثرَ التَّأويلاتِ التي تأوَّلَ بها نُفاةُ الصِّفاتِ لا تُعَضِّدُها قَرينةٌ ولا يدُلُّ عليها قَرينةٌ أو استعمالٌ.
– أنَّ العَربَ وإنْ لم يُعرَفْ عنهم اصْطِلاحُ المَجازِ فقد كَثُر ذلك في شِعرِهم وأقْوالِهم، كما أنَّه قد تَكلَّم غيرُ واحِدٍ في المَجازِ مِنَ القُرونِ الأُولى، منْهم أبو زيدٍ القُرَشيُّ المُتوفَّى (170هـ).
أمَّا القولُ بأنَّ ذلك يُفْضي إلى وصْفِ اللهِ بالمُتجوِّزِ، فهذا لا يَجوزُ إلَّا بالدَّليلِ؛ فإنَّ أسْماءَ اللهِ تَوْقيفيَّةٌ، كما أنَّ في القُرآنِ ضرْبَ الأمْثالِ والسَّجْعَ، فهل يُقالُ: إنَّ اللهَ مُمثِّلٌ أو ساجِعٌ؟! هذا لا يَجوزُ