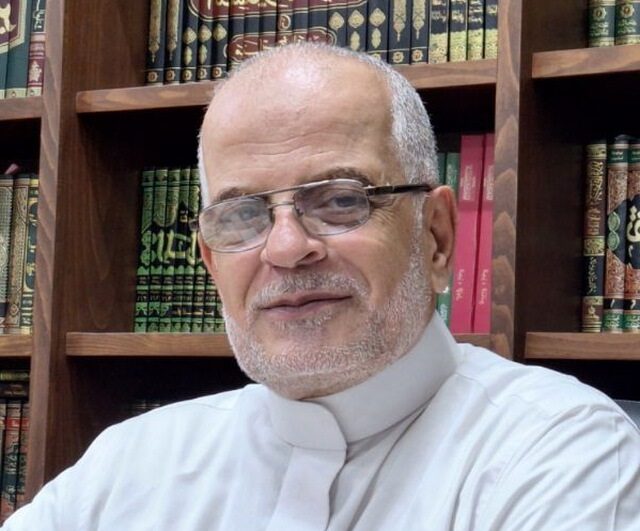إنها ليست أسطورة من أساطير الأولين، أو قصة من نسج الخيال أو رواية من الروايات التي يضعها الكُتّاب (المحترفون) للمجلات أو المسرحيات والتمثيليات، بل إنها قصة حقيقية واقعية «ذات فنون وشجون»، قصة تمثلت على أرض الواقع، وتجسدت فصولها وتمثلت أدوارها عبر قرون متطاولة على مسرح التاريخ البشري.. لا على مسرح الرواية السينمائي، أو منصة التمثيل الملهاتي.
إنها حقيقة ثابتة من أعظم حقائق التاريخ الإنساني التي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها للحاقد الأعمى.. فضلا عن البصير الواعي!
ولكن هذه الحقيقة التي تساوي – في حتمية وجودها – الشمس والقمر، والأرض والسماء، والبحار والأنهار، والجبال الشماء والسهول الفيحاء، وغيرها من الحقائق الكبرى الناطقة المرئية المعاشة – المبثوثة في الكائنات – التي لا مجال فيها لأدنى ذرة من شك وشبهة… أقول: إن هذه الحقيقة تبدو الآن أغرب من الخيال، أو نوعا من الأحلام التي يراها الرائي في المنام.
وسبحان مقلب الليل والنهار، ولله في خلقه شؤون، وبيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء.. {وتلك الأيام نداولها بين الناس}.
إنها قصة ” أمتنا ” المخرَجة للناس، المحظوظة بآخر وأعظم الكتب السماوية، المحظية بأفضل الرسل، الأمة التي سماها القرآن الكريم: «خير أمة».. فجعلها شامة في مصاف الشعوب ومنظومة الأمم، أمة مصطفاة مجتباة مختارة، فكأنها واسطة العقد، وبيت القصيد، والغرة في وجه الفرس، والتاج على رأس الملك.
فما هي القصة؟ وما هي الحقيقة التاريخية التي تبدو الآن أغرب من الخيال؟!
ذلك ما أحاول الإجابة عنه فيما يلي:
إن أغلى ما وهب الله أمتنا الإسلامية: «العقيدة».. فهي -العقيدة- روحها وجوهرها وسر وجودها، وقطب رحاها الذي يدور حوله سائر نشاطاتها، وعليها يتوقف – قبولاً ورداً – جميع أعمالها، فهي -العقيدة والإيمان- أغلى من الوجود وأثمن من الحياة.
العقيدة التي بها تميزت الأمة وسادت. فبفضلها حقّقت ما حققت من الإنجازات والانتصارات والفتوح والبطولات التي حارت – ولا تزال تحار – فيها العقول العبقرية، وبفضلها حازت من الرقي والازدهار ما حازت..
ومن العقيدة تفجرت ينابيع العلوم والفنون والمعارف التي لا تضارعها فيها أمة من الأمم.
والعقيدة هي التي جعلت العرب البدو يقفون من الإمبراطوريتين الفارس والروم – القوتين العظميين آنذاك اللتين كانتا تحكمان العالم – موقف الند للند، بل موقف السيد للمسود، فبهذه العقيدة هزموا الإمبراطوريتين شر هزيمة، فعادتا قصة ماضية، وكأنهما لم تغنيا بالأمس..
فكانت عقيدة الأمة أساس كل مجد أثلته، وانتصار أحرزته، وعلم ابتكرته، وسبب سعادتها، التي طارت في سمائها حقبا من الزمن، وبها أصبحت ترعى الأمم بعد ما كانت ترعى الغنم، ووصلت إلى الجوزاء بعد ما كانت تتسكع في الصحراء، وبلغت أوجها وذروتها.
وبهذه العقيدة أدرك أصحابها منبع قوتهم، وسر حياتهم، وغاية وجودهم.
وذلك شأن العقيدة (أي العقيدة الصحيحة) فهي إذا صلحت أصلحت الفساد، وسدت الخلل وأكملت النقص الذي قد يوجد في مرافق أخرى من الحياة، وبالعكس إذا فسدت لم تنفع معها أحدث الأسلحة ولا أرقى الآلات، أو أبهى المظاهر وأضخم الثروات.
فالعربي البدوي حينما تسلح بسلاح العقيدة الصحيحة والإيمان الغالي والعمل الصالح.. واجه – وليس في يده إلا أسلحة بالية عتيقة – بها أرقى أمم العصر وأكثرها ثروة وامتلاكاً لأنواع الأسلحة الفتاكة بالنسبة لذلك العصر، ففاز وغلب.. {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ٢٤٩].
فالعقيدة الصحيحة تصلح كل فاسد، وتجبر كل انكسار، وتُقوّم كل اعوجاج، وتسد كل فراغ، وتؤدي إلى التقدم والازدهار، وإن كان صاحبها خاملاً مغموراً، جاهلا معدما فقيرا، مجردا من كل شارة ولافتة، عاطلاً محروماً من كل أسباب الرخاء والرفاهية، والرواء والبهاء، يعيش في بلد ليس له نصيب من المدنية، أو التقدم وزخارف الحياة ومباهجها.
وبالعكس إذا انعدمت العقيدة أو فسدت لم تُجدِ شيئاً ولم تغن غناء.. وإن كان صاحبها ذا غنى وثقافة وعلم وتجارب.
فالفرس والرومان لم تثبتا – مع قوتهما الحربية الضخمة والكثرة العددية الهائلة – أمام العرب القرويين – أصحاب الأسلحة الساذجة البسيطة.. لأن هؤلاء العرب كانوا يحملون في قلوبهم عقيدة ملتهبة لا تقهر، وإيماناً قوياً لا يتزلزل.. وعاطفة جياشة لا يغرها الجمال الكاذب والمتاع الذاهب، وروحاً معنوية عالية تكهرب طاقتهم الكامنة، وحنيناً عارماً إلى الشهادة في سبيل الله، حنين الليل إلى مطلع الفجر والجدب إلى ديمة القطر.
أما الفرس والرومان فكانت قلوبهم هواء فارغة البطارية، محرومة من أي عقيدة أو إيمان أو عاطفة نبيلة، لا تحرك أصحابها إلا دواعٍ تافهة وشهوات رخيصة، ولذات فانية، ومتاع عاجل.
إن هذه العقيدة غيرت العرب تغييرا كاملا، غيرت عقليتهم ومزاجهم ونظرتهم إلى الكون والحياة، ووسعت أفقهم، وأخرجتهم من إطارهم المادي الضيق المحدود.. إلى أفق أوسع وغاية أسمى وهدف أنقى إلى ما فوق المادة.. إلى ما وراء المعدة والشهوة والمشاهد المحسوس والواقع الملموس، وحررتهم من رق الخرافة، ووضعت عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ورفعت تفكيرهم ورقّقت شعورهم، وجعلتهم يسمون عن تقديس الأحجار وعبادة الأصنام والأوثان، ويتصلون بفاطر السماوات والأرضين اتصالاً مباشراً بدون وسائط أو مقربات.. {مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [الزمر: ٣).
نعم! هذه العقيدة هي التي أخرجت من العرب البدو والمسلمين غير المتحضرين رجالا عظماء وعباقرة خالدين من قواد العالم، وفاتحي الإمبراطوريات، وممصري البلدان ومؤسسي الممالك، ومهندسي العمران، ومدوني الدواوين، ومبتكري العلوم والمعارف، الذين لا تستطيع الأمم والشعوب المتحضرة أن تقدم نظراء لهم.
إن هذه العقيدة جعلت العرب المسلمين ينظرون إلى الفرس والروم نظرة العطف والشفقة، نظرة الحُر الكريم إلى الأسارى المكبلين بالسلاسل والأغلال، فإنهم – الفرس والروم – كانوا عبيدا يعيشون في الأقفاص من الذهب.. والقفص قفص ولو كان من الذهب.. عبيد الشهوات والملذات والعادات والتقاليد والعقائد الفاسدة، فيحتاجون إلى أن يحرروا من هذه العبودية بجميع أشكالها وصورها وألوانها.
إن هؤلاء العرب كيف كانوا ينظرون – بعد ما تشبعوا بالروح الإسلامية – إلى أصحاب الحضارات السائدة آنذاك، يكفي لتقدير نظرتهم هذه ما حكت الكتب من منظر دخول ربعي بن عامر، بلاط رستم قبل وقعة القادسية، فإن فيه تفسيراً لما نقول وتصويرا لموقفهم من الحضارات المادية؛ بل إن هذا المنظر يمثل -في الواقع- موقف المسلمين في كل زمان ومكان من الحضارات قديمها وحديثها.
أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه، وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي والحرير، وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه، وبيضته على رأسه، قالوا له: ضع سلاحك، فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حينما دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت، فقال رستم: ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عامتها، فقال له رستم: ما جاء بكم فقال: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».
هنالك نرى الحضارة الإسلامية واضحة جلية في موقف ربعي بن عامر في هذا البلاط وحديثه مع الملك، ودعوته إلى الدين الحق، وهو يدلنا أن حضارة النمارق والزرابي ليست إلا بداوة وتأخرا وانحطاطاً إذا خلت عن نور الوحي الإلهي والهدي السماوي، وأن المظاهر لا اعتبار لها، بل إن الاعتبار للروح التي تحدوها.
فهذه العقيدة المُعلية الرافعة هي التي جعلت أصحابها يرفعون راية الإسلام ويعلون كلمة الله، يفتحون البلاد ويعمرون الأمصار ويعتلون العوالي، ويحتلون المعالي، ويقتنصون النجوم، ويصلون الجوزاء وينالون من المجد والعظمة ما لم يخطر للأمم السابقة ببال.
واستمرت هذه السلسلة من السؤدد والرفعة للأمة مئات من السنين.
ثم ماذا حدث…؟ حدث ما يخجل القلم من تسطيره، حدث ما يعرفه الجميع.
كأن هذه الأمة أصابتها العين (والعين حق) فهبطت من الثريا إلى الثرى.. لماذا حدث هذا؟
أ تركت الأمة عقيدتها التي رفعتها إلى السماء.
كلا!
إذن ما هو السبب…؟!
إذا كانت الأمة لا تزال تعتنق تلك العقيدة الإسلامية التي كانت سبب صعود سلفها إلى الثريا..
فلماذا لم تعد العقيدة ترفع أصحابها كما فعلت في الماضي…؟
هل فقدت العقيدة – والعياذ بالله – مفعولها وأثرها…؟!
فما الجواب؟
الجواب أن المسلمين فقدوا روح العقيدة وجوهرها وحرارتها.. إنهم متمسكون بها ظاهراً، فلم تعد تجري منهم مجرى الروح والدم في الأعضاء، والكهرباء في الأسلاك شأن سلف هذه الأمة.
فعادت العقيدة شكلاً لا روحاً، وقالباً لا قلباً، ولفظاً لا معنى.
الأذان يرتفع، ولكن فُقدت الروحُ البلالية.
الصلوات تقام، ولكن فقدت معنويتها وروحها، وخشوعها وخضوعها.
«لا إله إلا الله» تقال من طرف اللسان، ولا تصدر من أعماق الجنان.
فغلبت الظواهر والرسوم والشكليات والطقوس على الروح والجوهر والمعنى.
فإذا عادت إلى العقيدة روحها وحياتُها عادت إلى المسلمين غلبتهم وعزتهم.
فالعقيدة الحقة، والعمل الصالح المخلص، والبطولات والتضحيات هي التي ترفع أمة، وتصنع تاريخاً، وتحقق مجداً، وتجلب نصراً وفتحاً من الله.
فلنَعُد إلى العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، تعد إلينا عزتنا السالفة ومجدنا التليد إن شاء الله.
وما ذلك على الله بعزيز، وهو على كل شي قدير!
{وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}
محمد نعمان الدين الندوي
لكناؤ، الهند
(الاثنين: ٢٤ من رجب ١٤٤٥ھ – ٥ من فبراير ٢٠٢٤م).