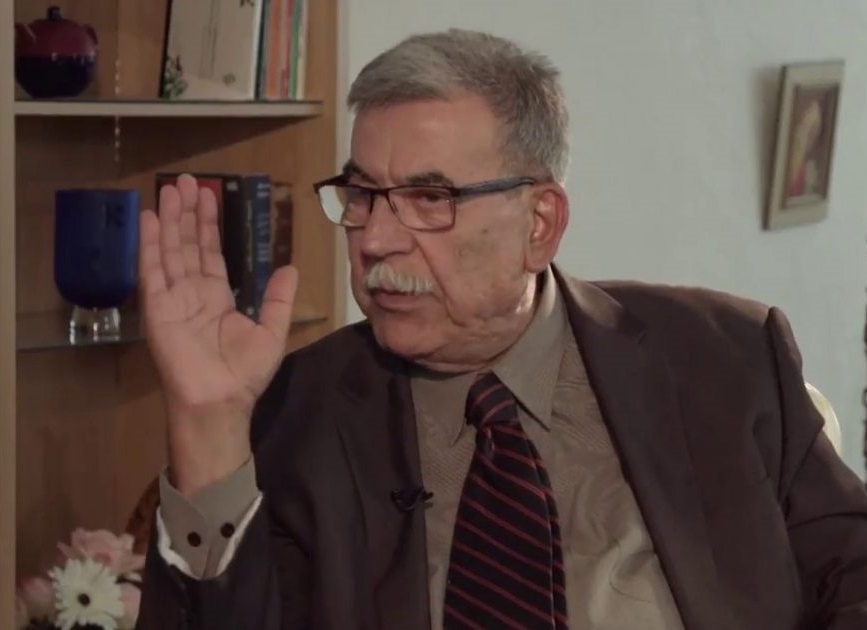في مأثور الأقوال نذكر، شر البلية ما يضحك. فملالي إيران، وعلى رأسهم الحاكم الأوحد علي خامنئي، ذو الألقاب المتعددة، مرشد الثورة الإيرانية ومرجعها الديني وقائدها الأعلى والولي الفقيه فيها، ومعهم جوقة من المحسوبين على الكتاب والمثقفين والأدباء، ذوو الصبغة الطائفية والمذهبية، إضافة إلى الإعلاميين المرتزقة والأقلام المأجورة والمحطات الفضائية،دوخوا رؤوس الخلق، بالنظام الإسلامي الديمقراطي في إيران، الذي يضاهي الأنظمة الديمقراطية في العالم والانتخابات النزيهة والشفافة والخالية من التزوير، والرشاوى وشراء الذمم، سواء تلك التي تخص الانتخابات الرئاسية، أو التي تجري في مؤسسات الدولة السيادية، مثل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
المناسبة لهذا الضجيج الإعلامي، الانتخابات التي جرت قبل حوالي أسبوعين، وعلى وجه التحديد، يوم الجمعة الخامس من هذا الشهر، حيث اعتبرها الإعلام الإيراني أفضل انتخابات جرت في إيران من جهة، ومثالا فريدا ورائدا يحتذى به من قبل شعوب المنطقة والعالم من جهة أخرى. مستدلين على ذلك، بهزيمة المرشح المحافظ، القريب من الولي الفقيه على خامنئي، أمام مسعود بزشكيان، الشخصية الأكاديمية المستقلة، الذي يحمل في جعبته برنامجا إصلاحيا، بعيدا عن سياسة إيران المتشددة، وتوجهات الولي الفقيه الحادة، من شانه، كما يروج فريق بزشكيان تحقيق جملة أهداف في المقدمة منها يفتح أبواب العلاقات مع جميع دول العالم. بحيث تعود إيران جزءا من المجتمع الدولي، وعضوا فاعلا فيه.
أما الشعب الإيراني، فانه سينعم بالجنة الموعودة على يد الرئيس الجديد وحكومته.حتى خيل لنا لبرهة من الزمن، بان هذه الانتخابات لم تجر في إيران، وانما جرت في السويد أو النرويج أو الدنمرك.
وكان أكثر ما يحزن في هذا الخصوص، هو الموقف الغريب لبعض الوطنيين والمثقفين والسياسيين المستقلين، بصرف النظر عن النوايا. حيث أضفوا على هذه الأكاذيب نوعا من المصداقية، وطالبوا الناس بتأييد النظام الإسلامي في إيران، والنظر إلى التجربة الإيرانية على انها تجربة رائدة في مجال الديمقراطية.
خاصة بعد فشل المشروع القومي واليساري والليبرالي في المنطقة في تحقيق الديمقراطية!في حين توصل عامة الناس، بما فيهم البسطاء، إلى قناعة راسخة بعدم وجود نظام ديمقراطي في بلدان العالم الثالث ودول منطقتنا، وعلى وجه الخصوص، البلدان التي تحكمها أحزاب شمولية، سواء كانت يسارية أو قومية أو دينية، وبالذات إيران التي يحكمها الولي الفقيه.
وهذا ما يفسر عزوف الناس في هذه البلدان عن المشاركة بالانتخابات، سواء الرئاسية منها، أو البرلمانية، أو مجالس المحافظات، أو غيرها.
جراء ما أنتجته هذه الحكومات المنتخبة، من تخلف ثقافي وسياسي واجتماعي واقتصادي، وتدهور في الخدمات العامة، وعدم توفير مقومات الحياة الكريمة.
إن الانتخابات في إيران، مسرحية بائسة يجري عرضها بين دورة وأخرى،منذ أكثر من أربعين سنة.
بل إنها أسوأ من جميع الانتخابات التي تجري في دول المنطقة. حيث لا علاقة لنتائج الانتخابات بتطلعات الشعب الإيراني، الذي يسعى للحرية والانعتاق من نظام ملالي طهران، وتفرد الولي الفقيه بالحكم المطلق، بذريعة القدسية التي يدعيها، تحت عنوان الولي الفقيه، الذي يأخذ على عاتقه مهمة الإمام المهدي المنتظر لحين ظهوره.
وقد جرى شرعنة هذا المقدس في الدستور الإيراني، بطريقة ثنائية لا مثيل لها في دساتير أعتى الأنظمة الدكتاتورية في العالم. ليعتقل هذا المقدس الذرائعي المفترض مؤسسات الدولة كافة في تكييف متبادل بينه وبين الدستور. ليس بصورة أفكار فحسب، وإنما بصورة تشمل مؤسسات الدولة كافة. ومن جهة أخرى،يمنح الدستور صلاحيات غير محدودة للولي الفقيه، ولبعض المجالس واللجان التي تعمل تحت إمرته، بشكل صريح لا لبس فيه.
لنأخذ مثلا شروط منصب رئيس الجمهورية، الذي يأتي بالمرتبة الثانية بعد الولي الفقيه حسب الدستور الإيراني. حيث يذكر الدستور في المادة 115، بان المرشح للرئاسة يكون،من بين أوصاف أخرى، “أمينا معتقدا بالمبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد”. في حين توضح المادة الثانية عشرة المذهب الرسمي للبلاد حيث تفيد بان: “الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير”. بعبارة أخرى، لا يحق لأي مواطن، مهما علا شانه ومقامه، أن يرشح نفسه دون أن ينتمي إلى الدين الإسلامي وعلى وجه التحديد المذهب الجعفري الاثني عشري.
أما في حال فوزه، فهو ليس سوى أداة في يد الولي الفقيه، وعدد من المجالس واللجان، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فالرجل لا يملك من الصلاحيات سوى مسؤوليته عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة، ولديه تأثير محدود على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية. وهذه الصلاحيات تعتبر محدودة نسبياً، بالنسبة للقرارات السيادية في السلم والحرب والأمن والجيش. أما وزراؤه، فحالهم أكثر سوءا.
فوزير الداخلية الذي يشرف مثلا على جهاز الشرطة الوطني، لا يحق له تعيين قائد الجهاز، وإنما يتم تعينه من قبل المرشد الأعلى وهو مسئول مباشرة أمامه.وينطبق الأمر نفسه على قائد قوات الحرس الثوري، الذي يضم قوات المتطوعين التي تعرف باسم “الباسيج”.
أما مؤسسات الدولة كافة، بما فيها المؤسسات السيادية منها، مثل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهي أسوأ حالا من الرئيس الإيراني. فعلى سبيل المثال لا الحصر.
فالدستور حين يتحدث في المادة 56عن السيادة المطلقة للإنسان،وعلى تقديس الحريات الفردية، والفصل بين السلطاتا لثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية قراراتها،بحرص يفوق حرص مونتسكيو، الذي ابتكر هذه المبادئ، سرعان ما يفرغها الدستور من محتواها، عندما يعتبر ما ورد فيها من مكاسب هامة تصب في مصلحة الشعب الإيراني،منحة إلهية قادمة من السماء.
وبالتالي لابد لها من وسيط لنقلها للبشر، وهذا الوسيط في إيران تحديدا هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الذي يقوم بتبليغها أولا وتفسيرها حسب هواه ثانيا، باعتباره وكيل الإمام المهدي لحين ظهوره.
وإلا ما معنى أن يمنح الدستور في المادة 71 الحرية الكاملة للسلطة التشريعية،في سن القوانين في كافة القضايا،وفي الوقت نفسه، تسلب المادة 72 هذا الحق،حين تربط أي قانون أو تشريع يصدر عنها،بأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد، أي المذهب الجعفري الشيعي، الاثنا عشري، وان البت أو الحكم في هذا الصدد، يعود إلى مجلس صيانة الدستور،الذي يتفرد بتفسير القوانين الصادرة، كما تقتضيها إرادة الولي الفقيه الذي هو فوق كل هذه السلطات واللجان.
اما مجلس حماية الدستور، المسئول أمام الولي الفقيه، فهو الحاكم الفعلي للبلاد بعد الولي الفقيه. حيث يتمتع بالجانب الإلهي الذي يمنحه قدسية مطلقة. فهو يتكون وفق المادة 91 من 12 عضوا. ستة من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة وهؤلاء يختارهم القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وهم يمثلون الشق الإلهي.
أما الستة الآخرون فيشترط فيهم، أن يكونوا من المسلمين ذوي الاختصاص بمختلف فروع القانون، يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويصادق عليهم مجلس الشورى، وهم يمثلون الشق البشري أو الدنيوي،وهو مسئول أيضا أمام القائد الأعلى، الذي يمتلك حق الفيتو.
أن مجلس الفقهاء الستة في مجلس حماية الدستور،من حقهم رفض أي تشريع صادر عن الستة الدنيويين في المجلس، كونهم ليسوا من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة. بل ان من حق الفقهاء الستة رفض أي تشريع أو قانون، من قبل جميع السلطات الحاكمة، تحت ذريعة تعاكسها مع دين الدولة الرسمي.
وهؤلاء الستة الفقهاء تكون قراراتهم بالأغلبية المطلقة. نصف زائد واحد، أي ثلاثة زائد واحد. وبالتالي فهؤلاء الأربعة هم من يحكمون إيران بأمر الولي الفقيه.
باختصار شديد، فان الولي الفقيه يسرق من الأمة حق وضع الدستور بأسسه المستمدة من الشريعة، ليمنح هذا الحق لنفسه، باعتباره النائب للأمام الغائب، شاء المشرعون أم أبوا. أي أن الدستور الإيراني أداة بيد الولي الفقيه، أو اللجان التي تعمل تحت إمرته، سواء بشقها الإلهي أو الدنيوي. ليس هذا فحسب وإنما يتعدى الأمر إلى المؤسسات الأخرى جميعها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان المادة 57 تلزم السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية،المنتخبة بشفافية ونزاهة، تضاهي الانتخابات في الدول الديمقراطية، على حد ادعاءاتهم، بممارسة صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة علي خامنئي. وذلك وفقًا للمواد اللاحقة في هذا الدستور، اما الرئيس المنتخب فهو لا يملك، كما أسلفت، من الصلاحيات سوى مسؤوليته عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة،ولا تأثير مفصلي له على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية، أو القرارات السيادية في السلم والحرب والأمن والجيش. بل إن جهاز الشرطة الوطني، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية يعين قائده من قبل المرشد الأعلى وهو مسئول مباشرة أمامه.وينطبق الأمر نفسه على قائد قوات الحرس الثوري التي تضم قوات المتطوعين التي تعرف باسم “الباسيج”.
بالمقابل، فإن مجلس صيانة الدستور- الذي يضم أعضاء مقربين من المرشد الأعلى- يتولى مهمة المصادقة على القوانين الجديدة أو رفضها.
لندع الدستور جانبا، فعلى أرض الواقع الملموس، فإن النتائج البائسة، التي أفرزتها انتخابات الرؤساء في إيران دون استثناء، أثبتت بان هذه الانتخابات لم تجر من اجل بناء نظام ديمقراطي يخدم إيران وأهلها، وإنما تجري من اجل توفير آلية سياسية، ذات صفة ديمقراطية، تمكن ملالي طهران، والولي الفقيه بالذات، من حكم البلاد بطريقة مباشرة وصريحة وواضحة.
عبر امتلاكه صلاحيات مطلقة، إلى درجة يستطيع من خلالها، اتخاذ أكثر القرارات خطورة، دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة المنتخبة كافة، وفي الوقت نفسه، رفض أي قرار إذا تعارض معه، باعتبار منصب الولي الفقيه منصبا مقدسا، فهو يمثل الإمام الغائب المهدي المنتظر حتى ظهوره. ولا يغير من هذه الحقيقة بعض الحريات التي منحها الدستور، أو الولي الفقيه، للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. فهذه الحريات التي منحها الدستور بيده اليمنى يسحبها الولي الفقيه باليد اليسرى.
إن خطورة ملالي طهران ونظامهم المذهبي،القائم على سحق الآخر، لم تعد حصرا على الداخل الإيراني، بل امتدت لتشمل بلدانا عديدة في المنطقة. فقد جندت إيران خامنئي، تحت سقف نظرية ولاية الفقيه الدول والأحزاب والمليشيات، وأعلنت صراحة تبعيتها للنظام الإيراني، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا. حيث تجد ذلك معلنا في جميع برامج هذه الأحزاب، او المراجع التي تستند إليها.
فعلى سبيل المثال، المرجع الأعلى لحزب الدعوة محمد باقر الصدر، يؤكد هذه الحقيقة في جميع مؤلفاته ذات الصلة،خاصة في كتابه الموسوم “لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية” وكذلك آية الله محمد الشيرازي في كتابه الموسوم “الحكم في الإسلام” ثم حجة الإسلام محمد تقي المدرسي الأب الروحي لمنظمة العمل.
خلاصة القول، أن من العبث المراهنة على الانتخابات في إيران، وما تفرزه من نتائج. ولا على القادم الجديد وبرنامجه الانتخابي، أو التصريحات التي يطلقها حول سياسته الداخلية أو الخارجية، مادام الأمر مرهونا بيد الولي الفقيه المعصوم من الخطأ،والذي لا سلطة إلا سلطته، التي تتعالى على أي نقاش أو اعتراض أو نصيحة أو رأي. فهو كما يسوق نفسه، ظل الله في الأرض، مما لا يترك للمعارضة الوطنية الإيرانية غير خيار واحد، وهو إسقاط نظام الملالي، بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح، والخلاص من حكم الولي الفقيه وتفرده بالسلطة والقرار، وإقامة نظام وطني يحقق للشعب الإيراني كامل مطالبه المشروعة، في الحرية والتقدم والحياة الكريمة. الأمر الذي يدعو كل وطني داخل إيران وخارجها إلى دعم المعارضة الإيرانية،لإنجاز هذه المهمة النبيلة. حيث الانتصار في إيران هو انتصار لشعوب المنطقة، والعكس صحيح.