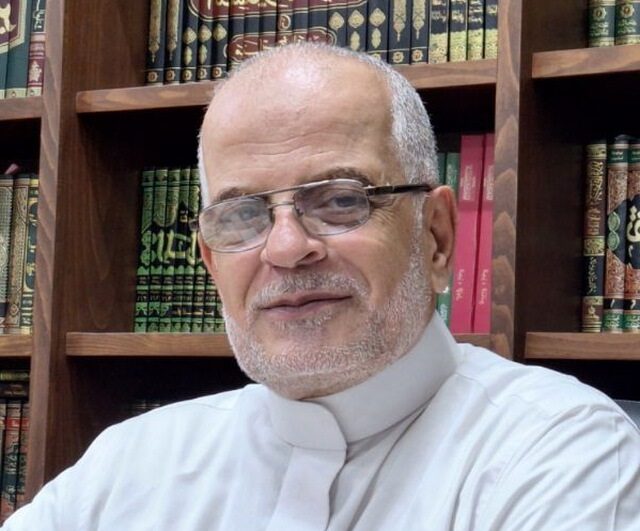كل من أراد أن يوجّه سهام النقد إلى عالم من علماء أمّتنا كالبخاري أو النووي وأضرابهما فإنه يبدأ بهذه المقدّمة المموّهة: (هل هو معصوم؟) ليصل منها إلى أنه غير معصوم، فيسوغ نقده.
ويغيبُ عمن يُصدِّر هذه المقدِّمة أن الشيء قد يكون صحيحًا في ذاته، غير صحيح في لوازمه ومتعلقاته، كما أنه قد يكون صحيحًا في ذاته فاسد المآل والغاية.
وشرح هذا أن الزمان والمكان والآلة لا تُعين على هذه المقدّمة؛ فأما الزمان وهو (العصر الذي نحن فيه) فأكثر أبنائه سُفهاء. وأما المكان فليس من التعقُّل في شيء أن يُصرَّح بهذا الكلام على هذه المواقع السيّارة التي تُسمى بمواقع التواصل التي يقصدها كل من هبّ ودبّ من عوامّ الناس وغيرهم. وأما آلة النظر فهذا جليّ في قصور أنظار أبناء هذا الزمان، وانتفاء صفاء تَلقّيهم، بسبب اختلاط علومهم التراثية بعلوم حديثة غربية أو شرقية، ووقوعهم فريسة للاتجاهات والمناهج المتعاندة.
إن قائل هذا الكلام تغيب عنه بلاغةُ القول حين لا يُراعي مناسبة المقال لمقتضى الحال، ويغيب عنه أن تلقّي الأمة لأحد علمائها بالقبول إنما هو بمنزلة الإجماع عليه، وخدش هذا العالِم هو خدش لإجماعها وخرقٌ لصفّها، وإن هذا القبول الذي كُتِب له الانتقال رغم اختلاف المكان وامتداد الزمن لحريّ أن يقوم مقام العصمة.
وإن شهادة الأمة لعالم ما إنما هي محض توفيق من الله له ودليل رضا عنه وتفسير عملي لوراثة النبوّة، وإن الطعن فيه لهو طعن في هذا التوفيق وإزراء بذاك الرضا، وانتقاص لميراث النبوة.
ثم إن هذه المقدمة لا يُصدّرها إلا من لم يشمّ رائحة الأدب فضلًا عن رائحة العلم، وهل يليقُ بالمرء أن يواجه كبير قومه ببيان خطئه على الملأ، فإذا قال له قائل: لا يليق أن تفعل هذا، قال له: وهل هو معصوم؟ لم يجر بهذا عُرف الأدب، بل إن من يفعله ينتظمه الناس بين السفهاء. هذا في كبير القوم في أمور الدنيا، فما الشأن إذا كان كبيرَهم في أمور الدين؟
ثم بابٌ آخر من الأدب يغيب عن هؤلاء الحمقى؛ وهو أن البر بمن تعب من أجلنا وارتحل بين الأصقاع ليجمع قواعد العلم ومسائله لا يكون بهذه المجاهرة الفجّة، فإن الجهر بذلك وكثرة ذكره يعني أنه قاعدة للمعاملة ومنطلق للتفكير، وأيّ بشر هؤلاء الذين ينظر صغارُهم إلى كبرائهم وفق قاعدة أنهم غير معصومين؟! لا ريب أن هذا يورث الريبة والتوجس من علمائنا، ومن ينتهج ذلك لا شك أنه ضحية أمراض اجتماعية وأدواء نفسية فضلًا عن قلّة ديانة.
وأخطر ما يكتنف هذه المقدمة أنها تُمثّل مصادرة على العقل الباحث؛ لأن الانطلاق منها يعني أن الأصل في البحث العلمي هو النقد، بل يعني أن الغاية من العلم هي النقد، ولعمر الله إن هذا لفهم منتكِس؛ فنحن لا نقرأ لعالِم من أجل أن نَتعقّبه، نحن نقرأ له من أجل أن نتعلّم منه، فإذا وجدنا ما يُشْكِل اتّهمنا عقولنا ابتداء، والتزمنا الأدب في الإبانة عنه، ولنا في (لعل) و(ربما) و(كأنّ) مساغ للتعبير.
ثم إن أمر التعقب ميسور لكل أحد أراد التشغيب، دليل ذلك أنك لو طلبتَ من هؤلاء المشاغبين أن يُضيفوا إلى صرح العلم شيئًا جديدًا، أو أن يُكملوا هذا البناء الشامخ الذي تركه أجدادنا لوجدتَ منهم الصمت المطبق.
إن الذي يروّج لهذه المقدمة -من أبناء هذا الزمان- لديه فسادُ تصوُّرٍ للعلم، فالعلم عنده كله يقيني، لا تدخله الظنّيّات، ولذلك لا نعجب حين نجد أن أي مسألة علميّة عنده إنما هي مسألة حياة أو موت، لأنه يراها من باب اليقينيات، ولا غرو أن يستخدم ضد من يخالفه قانون المفاصلة والإقصاء، وربما أدى به الأمر إلى التجريح والسبّ والقذف والتضليل، وهكذا ينتقل هؤلاء الحمقى من البحث في الظنّي المحتمل إلى ارتكاب القطعيّ المحرّم!! وهذا كله راجع إلى فساد تصوُّرهم للعلم ابتداءً.