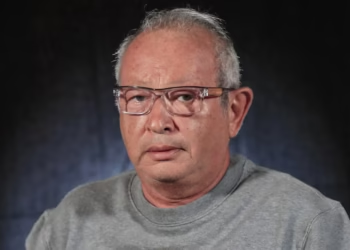الخميس: 26/ 8/ 1445ھ – 7/ 3/ 2024م
الضيافة الجهنية
فضيلة الأخ الكريم الشيخ أبو عبد الله عمر الجهني (ينبع البحر) من رجال المملكة المحترمين، الذين لهم جهود معروفة مشكورة في حقل الدعوة والتوجيه والإرشاد، وقد شغل عدة مناصب هامة في هذا الحقل في مدن مختلفة من المملكة.
و -إلى ذلك- إنه يتميز بميزة رفعت قدره كثيرا، بل تكاد تجعله شامة بين أصحابه، وهي أنه أمين للقيم والسمات العربية الأصيلة، ومستمسك بها في قوة واعتزاز، ويمثلها خير تمثيل وأصدقه..
وأنا شاهد عدل (ولا مؤاخذة على هذا التعبير) على خصيصته المتميزة هذه، فهو -حفظه الله- نموج حي نادر من نماذج العرب المتحلين بالسمات التي تعتبر سمات مميزة لهم، من السماحة والمروءة والندى، والوفاء والجود والكرم والضيافة والقرى وما إلى ذلك..
أما القِرى.. فهو من السمات التي يمتاز بها العربُ على غيرهم منذ قديم، والنصوص -من النثر والشعر- التي يزخر بها التراث العربي، تدل على أن هذه السمة -الكرم والضيافة- كانت متأصلة في العرب، جبلوا عليها، ورضعوا بلبانها، وجرت منهم مجرى الروح والدم، فإذا قلنا: إن العروبة والضيافة صفتان متلازمتان متلاصقتان، لا انفكاك لإحداهما عن الأخرى.. ما عدونا الصدق والصواب، ولم نُتَّهم بالمبالغة في وصف العرب، فحيثما وجد العربي وجد الكرم والقرى، ولا يمكن أن يكون العربي القح غير كريم، أو غير مضياف، أو غير قارٍ -من القرى-.
هذا. وكانت بداية تعرفنا بالشيخ عمر بقصة من قصص الكرم والضيافة..
وهذه القصة ما سجلت هناك في أرض الكرم والكرام.. في أرض العروبة والعرب..
بل سجلت هنا.. في الهند.. وفي حيدر آباد بالضبط..
إنها قصة حقيقية غريبة.. بل أغرب من الخيال..
ولكنها قصة واقعية، شهدت فصولها أولا بأول.. بل كنت من أدوارها -إذا كان التعبير لا يخونني- وكان الشيخ عمر وصحبه الكرام أبطالها..
إنه لَحديث 1433ھ -فيما أذكر- وكنت إذ ذاك في الجامعة الإسلامية دار العلوم / حيدر آباد- أننا سمعنا أن وفدا سعوديا كريما سيزور الجامعة، ثم شرفها الوفد بزيارته، وكان الوفد يتكون من الشيخ عمر والشيخ فهد القاضي، والأخ سامي، فرحبنا بالوفد، وبعد قليل علمنا أن الوفد يطلب معزين، ودفعوا -أعضاء الوفد- الثمن لاشترائهما، فاشتُريا، فذبحوهما وسلخوهما، وقطعوا لحمهما، ثم قالوا: نريد مطبخ الجامعة، فصحبناهم إليه، ثم طلبوا البهارات.. فقلنا: استريحوا.. وأنتم ضيوفنا.. الطباخون يؤدون مسؤوليتهم، فأبوا.. ورفضوا أي نوع من أنواع المساعدة في عملية الطبخ وإعداد الطعام، وقالوا: بل استريحوا أنتم.. ونحن نطبخ.. ونحن نتولى كل شيء..
فقلنا: والله لم نر كاليوم عجبا.. صار الضيوف مضيفين.. والمضيفون ضيوفا..
أهذا من علامات الساعة يا ترى؟
إلى أن أعدوا الإدام، ثم أبوا إلا أن يبسطوا الخِوان -أيضا- هم.. ثم جاؤوا بالإدام في الأطباق، ووضعوه على السفرة، وكان جميع أساتذة الجامعة ضيوفا على ضيوفهم المضيفين الأكرمين …
وكنا نكاد نذوب حياء وخجلا.. ولا تكاد تصدق عيوننا ما ترى.. ولا نملك إلا الامتثال لسادتنا الضيوف:
وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا
وما في إلا تلك من شيمة العيد
وكان الإدام -ولا مجاملة ولا مبالغة- من أشهى وألذ ما أكلت من أنواع الإدام في حياتي.. لأنه كان أعد بمزاج كريم من الكرم العربي، والحب الإسلامي.. وعُجن برائحة الإخلاص، وضمخ بريا الأخوة الإيمانية..
وقال بعضنا لبعضنا: هذا هو الكرم العربي الذي كنا نقرؤه في الكتب، ونسمع عنه من أساتذتنا وكبارنا.. اليوم رأيناه بأم أعيننا، ولمسناه وجربناه واقعا حيا يعيش بين ظهرانينا..
في القديم كان المضياف العربي يُحَوّل ضيفه رب المنزل، أما اليوم فالضيف العربي نفسه انقلب مضيافا يضيف رب المنزل:
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا
نحن الضيوف وأنت رب المنزل
هذه هي قصة أول لقائنا بالشيخ الجهني الكريم..
فالكريم الذي أضافنا ونحن في بيتنا، كيف لا يضيفنا إذا جئنا إلى بيته هو؟
ومعلوم أن الشيخ عمر يسكن في ينبع، ولكنه من أجل أخيه الضيف -كاتب السطور- تجشم السفر، وجاء إلى المدينة المنورة، وأقام مأدبة عشاء تكريما لضيفه الهندي، دعا إليها صفوة مباركة من العلماء والأدباء والأعيان من مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
فلنعم الأمسية تلك الأمسية، التي احتضنت في رحابها من خيرة أبناء طيبة الطيبة وأفضلهم علما وأدبا وصلاحا وتقى ما احتضنت..
ولنعم الراعي.. راعيها!
فكان هناك تعارف، وتآنس، وتقارب، وتبادل وجهات النظر وتجاذب أطراف الحديث بين المتلاقين المجتمعين على صعيد الأخوة الإسلامية العالمية.
والحقيقة أن تلاقي الإخوان والتحادث فيما بينهم، لهو -في حد ذاته- نعمة أي نعمة، ومما لا تشبع منه النفوس، ولا تكل منه النفوس، بل تحن إليه دائما، كما كان قال عبد الملك بن مروان لجلسائه: «قد قضيت الوطر من كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزهر على التلال العفر».
لقد صدق ابن مروان.. فلا بديل لمجالسة الإخوان، ولا غناء عن محادثتهم، فإن في ذلك ترويحا للقلوب، وإيناسا للنفوس، وتلقيحا للعقول، وتفريجا للهموم، وتفجيرا للقرائح، وتنقيحا للآداب، وزيادة للمعلومات، وتقريبا لوجهات النظر، وطرحا للرؤى والأفكار وما إلى ذلك من الفوائد مما لا يخفى على المثقف الواعي.
فالشكر موصول لراعي هذه الأمسية الشيخ الجهني، الذي أتاح لي هذه الفرصة الذهبية للاجتماع بهؤلاء الأحبة الكرام ومحادثتهم.
ومن الذين سعدت بالالتقاء بهم في تلك الأمسية المدنية المباركة الكاتب السعودي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن فرج -عضو نادي الخطابة العالمي سابقا-، والحقيقة أنى أرى التعرف به مكسبا كبيرّا أدبيّا وعلميّا ودينيّا.. فهو خير أخ في الله، وخير مثقف واع مطلع على الأوضاع الحاضرة، ومدرك لمقتضيات العصر، وخير خبير بالتكنولوجيا الحديثة، وخير مقدر للفضل لأهله، وخير محب لوطنه وخير وفيٍّ له.. ورغم أن لقائي معه لم يتجاوز ثواني (لا دقائق..) ولكنه حل في هذه الثواني واللحظات من قلبي موقعا لم يحله إلا القليل الأقل ممن أعرفهم..
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
فصادف قلبا فارغا فتمكنا
بارك الله في عمر أخينا الفاضل محمد بن فرج، ونفع به الدين والوطن، وأدام الحب بيننا خالصا لوجهه الكريم ما حيينا..
أما الحديث عن مأدبة العشاء.. فقد كان أسَر إلى ابن صغير للشيخ عمر عنها قائلا – في براءة الطفولة وسذاجتها -: «ستأكل اليوم أحسن ذبيحة»، وكفى به وصفا صادقا لما حوته المأدبة..
والابن الصغير هذا -الذي نسيت اسمه- تبدو على وجهه مخايل النبوغ المبكر والفطنة غير العادية، جعله الله من الطلائع المؤمنة، التي تتطلع إليها الأمة لاستعادة مجدها التليد وعزها السابق..
وشكرا خالصا مكررا لأخينا المفضال المضياف الشيخ عمر الجهني على ما شملني به من الحب والحفاوة والكرم والضيافة.. على أن ذلك ليس بغريب ولا جديد منه.. فهو المعهود منه، والكرم من طبعه، والشيء من معدنه لا يستغرب!
والحمد لله أكرم الأكرمين!
(الثلاثاء: 22 من رمضان المبارك 1445ھ = 2 من أبريل 2024م)